الأزمة وحل الحضارة الديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط
الأزمة وحل الحضارة الديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط
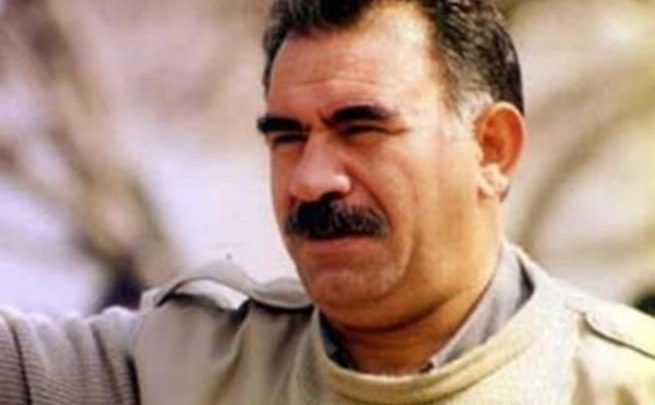
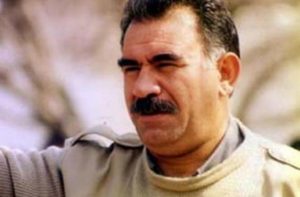 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
الوظيفةُ الأساسيةُ لعلمِ الاجتماعِ هي تعريفُ الحياة. لكنّ المُدَّعين أنهم زاوَلوا العِلمَ بدءاً من كهنةِ سومر ومصر وحتى العلمويين الاجتماعيين الوضعيين في أوروبا، وكما أنهم لم يُعَرِّفوا المعنى الاجتماعيَّ للحياة، فقد صاغوا تعابيرَ ميثولوجيةٍ هي الأكثر تحريفاً وتعتيماً للوعي بدلاً من هذه الوظيفةِ الأوليةِ على الإطلاق. بَيْدَ أنه لا يُمكِنُ الحديث عن علمِ الاجتماع ما لَم تُعَرَّفْ الحياةُ بمعناها الاجتماعيّ. كما لا يمكن تطَويرُ عِلمُ شيءٍ لَم يُصَغْ تَعريفُه. لا شكَّ في أنّ هذا الوضعَ متعلقٌ بالإنشاءِ المُنحرِفِ للحقيقةِ في نُظُمِ المدنية. فمثلما لَم تُوَضَّحْ حقيقةُ الحياةِ الاجتماعيةِ في نُظُمِ المدنيةِ منذ لحظاتِها الأولى وحتى يومنا الحاليّ فقد صيغَت بعدَ غَمرِها بأشكالِ الإنشاءِ المنحرفةِ والخاطئةِ بمقاييس عظمى من خلالِ التصنيفاتِ الميثولوجيةِ والدينوَِيةِّ والفَلسَفَوِيةِّ والعِلمَوِيةّ. فضلاً عن طَليِْ وصَقلِ هذه السرودِ بالفنون. وبإقحامِ الثقافةِ الماديةِ للمدنيةِ ضمن علاقةٍ جَدَليةٍ مع ثقافتِها المعنوية، لُقِّنَ العبيدُ نمط حياةٍ تَخدِمُ مصالحَ وعقائدَ ومطالبَ الآلهةِ المُقَنَّعين وغيرِ المُقَنَّعين، وذلك عبر سردِ التاريخِ المعروفِ أو الذي سُمِحَ بمعرفتهِ. وقد تمََكَّنَ نمطُ الإنشاءِ والتلقينِ هذا للحياةِ المهيمنةِ من الاستمرارِ بوجودِه على الرغمِ من مواجهتِه الاعتراضاتِ والمقاوماتِ مِن قِبلَِ عددٍ لا حصرَ له من الحُكماءِ والحركاتِ والجماعات. كنتُ قد جَهِدتُ على تعريفِ الحياةِ عموماً وحياةِ الإنسانِ الاجتماعيةِ على وجهِ الخصوصِ في مختلفِ فصولِ ومُجَلَّداتِ مرافعتي، وخاصة في فصولِها المعنيةِ بالحرية.
وعلى ضوءِ هذا التذكيرِ شعرتُ بالحاجةِ لصياغةِ تعريفٍ جوهريٍّ للحياةِ مرةً أخرى. وأخَُصُّ بالذكرِ الاغتيالاتِ والمجازرَ والإباداتِ اليوميةِ التي تتعرضُ لها الحياةُ في الشرقِ الأوسط، والتي تَحُثُّني على التقدمِ بصياغةِ تعريفٍ مُدرَكٍ بشكلٍ أعمق وذي مستوى أرقى فيما يتعلقُ بموضوعِ الحياة.
فحسبَ رأيي، الضررُ الأكبرُ الذي ألحَقَته الرأسماليةُ هو قضاؤُها على معنى الحياة. أو بالأحرى، هو ارتكابهُا الخيانةَ الكبرى بشأنِ علاقةِ الحياةِ مع مجتمعِها وبيئتِها. وبطبيعةِ الحال، فنظامُ المدنيةِ المتسترُ وراءَها أيضاً مسؤولٌ مِثلَها عن هذا الوضع. يُقالُ أننا نعيشُ في عصرٍ وصلَ فيه العلمُ والاتصالاتُ إلى أوَج قوتهِما. إلا أنّ سيادةَ العجزِ حتى الآن عن تعريفِ الحياةِ وأواصرِها الاجتماعيةِ رغمَ هذا التطورِ الخارقِ للعلم إنما يثيرُ الذهولَ إلى حدٍّ بعيد. إذن، ينبغي حينها السؤال: هو عِلمُ ماذا، ومن أجلِ مَن؟ وكلمّا صِيغَ جوابُ هذَين السؤالَين ستُفهَمُ دوافعُ عدمِ ردِّ العلمويين الاجتماعيين على السؤالِ الأساسيّ، أي على السؤالِ «ما هي الحياة؟ وما علاقتهُا مع المجتمع؟ ». قد تبَدو هذه الأسئلةُ بسيطةً للغاية، ولكنها قَيِّمةٌ في معناها بقدرِ حياةِ الكائنِ المسمى بالإنسان. فما هي قيمةُ الإنسانِ ما لَم يُفهَمْ ذلك! في هذه الحالة بوسعِنا الحديثُ عن تحََوُّلهِ إلى مخلوقٍ ربما أدنى قيمةً من حيوانٍ أو حتى نباتٍ ما. فالبشريةُ التي لا تَعرِفُ معناها وحقيقتَها مستحيلةُ الوجود. وإنْ وُجِدَت فستكَُونُ الأكثر انحطاطا وبربريةً على الإطلاق.
a ( الحياة:
قد لا يمُكنُ صياغة تعريف الحياة. أو بالأحرى، قد نشعرُ بها نسبياً، أو نُدركُها جزئياً. فعلى الرغمِ من كونِ التطورِ التدريجيِّ حقيقةً قائمة إلا أنّ إيضاحَ التفسيرِ التطوُّريِّ الداروينيِّ لتطورِ الحياةِ والكائناتِ الحيةِ بعيدٌ عن إظهارِ الحقيقة.
كما أنّ رَصدَ حياةٍ تبدأُ من كائنٍ حيٍّ لَم يصبحْ خليةً بَعدُ في أغوارِ المحيطِ قبل ثلاثةِ ملياراتِ سنةٍ من الآن، وتَصِلُ إلى إنساننا الراهن بمنوالٍ تسلسليّ، إنما يساهِمُ بشكلٍ محدودٍ في تحديدِ معنى الحياة. يبحثُ العلمُ حالياً عن أسرارِ الحياةِ في تكويناتِ الجُسَيماتِ ما تحتِ الذّرّيّة. ولكن، واضحٌ جلياً استحالةُ الذهابِ أبعدَ من إيضاحٍ محدودٍ للحياةِ بهذا الأسلوبِ أيضاً. للحياةِ صِلاتُها مع هذه السرودِ بكلِّ تأكيد، ولكنها لا تَحلُّ المشكلةَ تماماً.
هذا ومقارنةُ الحياةِ بالموتِ أيضاً لا تكفي لإدراكِ معناها. أي أنّ القولَ بأنّ «الحياة هي ما قبلَ الموت » ليسَ نمطاً إيضاحياً مُقنِعاً كثيراً. الأصحُّ هو أنّ الحياةَ غيرُ ممكنةٍ إلا بالموت. أعلَمُ أنّ الحياةَ الخالدةَ مستحيلة ولكننا بعيدون أيضاً عن معرفةِ معنى الموت. تعريفُ الموتِ أيضاً غيرُ ممكن، كما الحياةُ بأقلِّ تقدير. فربما هو مُحَصِّلةٌ نسبيةٌ لحياتنا. وربما هو إمكانيةٌ في الحياةِ أو نمط تَحَقُّقِها.
وخشيةُ الموتِ علاقةٌ اجتماعية، مثلما سأُعَرِّفُها بإسهابٍ لاحقاً. وربما الموتُ هو شيءٌ مِن قبيلِ هذه الخشية. لا أرى ثنائيةَ المثاليةِ – الماديةِ مبدئيةً وإيضاحية. إذ لا قيمةَ لهذه الثنائية التي يَطغى عليها طابعُ المدنية في تعريفِ أو شرحِ الحياة. وبالنسبةِ إلى ما أَوَدُّ صياغته من تفسير أُريدُ التأكيدَ على أنّ علاقةَ هذه القرينةِ محدودةٌ مع الحقيقة. وبمنوالٍ مشابه، فمصطلحاتُ الحيّ – الجامد أيضاً بعيدةٌ عن الإيضاحِ فيما يتعلقُ بالحياة.
الحقيقة 1: قد يَعيشُ كلُّ كائنٍ حيٍّ – جامدٍ لحظاتِه فقط، فيما خَلا الإنسان الذي يسعى لإدراكِ الحياة. فربما الخروف الذي انقضَّ عليه الذئب، والمَجَرَّة التي ابتلَعََها الثقبُ الأسودُ يتشاطران المصيرَ الكونيَّ نفسَه. وحتى هذا مجردُ لغزٍ لأجلِ فهمِ الحياة، لا غير.
الحقيقة 2: الكائنُ الحيُّ الذي يمَُزِّقُ نفسَه ويرُهِقهُا لأجلِ مَولودِه، وإنجازُ الجُسَيماتِ ما تحتِ الذّرّيّةِ تكويناتٍ
دياليكتيكيةً بسرعةٍ خاطفةٍ لا تُصَدَّق، إنما يَعمَلان بِحُكمِ القاعدةِ الكونيةِ عينِها.
الحقيقة 3: بَلَغَت هذه القاعدةُ الكونيةُ بنفسِها إلى منزلةِ مساءلةِ الذاتِ في المجتمعِ البشريّ: مَن أنا؟ هذا السؤالُ هو سؤالُ محاولةِ القاعدةِ الكونيةِ لإسماعِ ذاتهِا لأولِ مرة.
الحقيقة 4: قد يكَُونُ الردُّ على سؤالِ «مَن أنا؟ » هو الهدفُ النهائيُّ للكون.
الحقيقة 5: ربما الحياةُ الكونيةُ برمتِها من حيٍّ وجامدٍ هي في سبيلِ تأمينِ بلوغِ السؤال «مَن أنا؟ .»
الحقيقة « :6 أنا هو أنا، أنا الكون، أنا الزمكانُ الذي لا قَبلَ له ولا بعَد، لا قُربَ له ولا بعُد! » ربما هذا الجوابُ هو الهدفُ النهائي.
الحقيقة 7: الفناءُ في الله، النيرفانا، أنا الحق. هذه الحِكَمُ المُطلَقةُ ربما كَشَفَت عن الهدفِ الأساسيِّ لحياةِ الإنسانِ الاجتماعية، أو أنها أَظهَرَت للوسطِ اهتمامَها بالحياةِ الاجتماعية.
بهذه الحقائقِ السبعِ لا أَكُونُ قد عَرَّفتُ الحياة. بل اَبحَثُ في الميادينِ المعنية، أو أَوَدُّ البحثَ فيها. لا تُدرَكُ الحياةُ أثناءَ عيشِها. ثمة هكذا تناقضٌ بين المعنى والحياة. فعندما يَكُونُ العاشقُ مع معشوقِه، فهو في الوقتِ ذاتِه في المكانِ الذي ينتهي فيه المعنى. لذا، فالتمكنُ من الفهمِ المطلقِ يقتضي الوحدةَ والعزلةَ المطلقة، أي أنْ يَكُونَ بلا معشوق. فكأنّ المَثَلَ الشعبيَّ «إما الحبيبُ أو الرأس « يَوَدُّ الإشادةَ بهذه الحقيقةِ بمعناها الميتافيزيقيِّ، لا الجسديّ. فتَحَمُّلُ الوحدةِ المطلقةِ غيرُ ممكنٍ إلا بالقابليةِ لفهمِ المطلق. والوحدةُ المطلقةُ لا تتحققُ إلا ببلوغِ حالةِ قوةِ المعنى فحسب، أي بالخروجِ من كينونةِ علاقةِ القوةِ الماديةِ فقط، لا غير. قرينةُ الوجود – العدم شبيهةٌ بثنائيةِ المعنى – المادة. فكِلا الثنائيتيَن مُجَرَّدتان ولا تعُاشان في الواقعِ الملموس. ويطغى احتمالُ كونِ الحياةِ هي القابليةُ اللانهائيةُ لهاتَين القرينتَين في الترتيبِ والانتظام. ويَبدو فيما يبَدو أنّ الفواصِلَ البيَنيِةَّ لحالاتِ الانتظامِ ضرورة حتميةٌ لِتَحَقُّقِ الحياة، ولو أنها تَظهرُ في هيئةِ لحظاتٍ فوضويةٍ عدميةٍ وعمياء مثلما الموت.
سعيتُ في هذا التحليلِ المقتَضَب، ولو بحدود، إلى شرحِ أسبابِ استحالةِ التعريفِ التامِّ للحياة. فالتعريفُ المطلقُ للحياةِ يقتضي الوحدةَ والعدمَ واللامادةَ بشكلٍ مطلق. ولأنّ هذا يَظَلُّ مجردَ تجريدٍ محض فبلوغُ الحياةِ أو معناها غيرُ ممكنٍ إلا بنحوٍ ثنائيٍّ ونسبيّ.
b ( الحياة الاجتماعية:
على الرغمِ من كونِ الحياةِ الاجتماعيةِ مصطلحاً بسيطاً للغاية، إلا أنه يقتضي الإيضاحَ كمصطلحٍ أساسيٍّ لكلِّ العلوم. وعلى النقيضِ مما يُظَنّ، فهو مصطلحٌ لَم يتمّ بلوغُ معناه رغمَ استخدامِه الوفير. فنحن لا نَعرِفُ ما هي الحياةُ الاجتماعية. فلو كُنا نعرِفُها لَكُنا أصبحنا حُماةً بلا هوادة لحياتِنا الاجتماعيةِ المُمَزَّقةِ إرباً إرباً تحت وطأةِ الأنظمةِ المهيمنة. الجهلُ يَسُودُ الحياةَ الاجتماعية لا الحِكمة. وبالأصل، ما يسَري في الطرفِ المقابلِ لحياةِ الهيمنةِ هو حياةُ الجهل. ذلك أنّه يستحيلُ الاستمرارُ بأنظمةِ الهيمنة دون إسدالِ ستارِ الجهلِ على الحَيَواتِ الاجتماعية. سأعملُ على تعريفِ الحياةِ الاجتماعيةِ مع مُراعاةِ الطابعِ النسبيِّ للحياة. فقبلَ كلِّ شيء لا وجودَ لحَيَواتٍ اجتماعيةٍ رَتِيبَةٍ ولا محدودةٍ ومتشابهةٍ في كلِّ مكان. فالحياةُ النسبيةُ تعني الحياةَ الوحيدةَ الواحدية. فالواحديةُ، مثلما هو معلومٌ أو ينبغي علمُه، لا تَدحَضُ الكونيةَ. فلا هناك واحديةٌ خالصة، ولا كونيةٌ خالصة. أي أنّ الواحديةَ – الكونيةَ قرينةٌ ساريةٌ بقدرِ ثنائيةِ المعنى – المادة. إذ لا تتحققُ الكونيةُ دونَ الواحديِّ الانفراديّ.
وكلُّ واحديٍّ أيضاً لا يعيشُ بلا الكونية. بوسعي تقديم مثالٍ لفهمِ ذلك أكثر: فمئاتُ الورودِ المتباينةِ هي واحديّةٌ انفراديةّ ولكن هناك جانبٌ مشتركٌ يقتضي تسميةَ جميعِ أنواعِ تلك الورودِ بالورود. يعَُبرُِّ هذا الجانبُ المشتركُ عن الكونية. وتسَري هذه القاعدةُ على جميعِ تنَوَُّعاتِ الكون.
نظراً لمحاولتي عرض الحياةِ الاجتماعيةِ بتاريخانيتِها وتنوُّعِها ضمن الفصولِ المعنيةِ من مرافعتي، فلن أُكَرِّرَ ذلك، وسأكتفي بالتذكير. ثمة نسبةٌ هامةٌ من الواقعيةِ في قصةِ هوموسابيانس )الإنسان المفكِّر(، الذي يفُترََضُ أنه عاشَ في شرقي أفريقيا، وأنهّ يعَُودُ إلى ما قبل حوالي مائتَي ألفِ سنة على وجهِ التقريب، ويُعتَقَدُ أنه تَوَصَّلَ إلى اللغةِ الرمزيةِ قبل خمسين ألفِ سنة، وأنه خَرَجَ من مجتمعِ ما قبلَ الزراعةِ مع انقضاءِ العصرِ الجليديِّ الأخيرِ على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس قبل عشرين ألف سنة، ويُجمَعُ عموماً على أنه انتقلَ إلى نظامِ حياةٍ اجتماعيةٍ تتداخلُ فيها الزراعةُ القَبَلِيّةُ مع القطفِ والقنصِ منذ خمسةَ عشر ألفِ سنة تقريباً. وقد أُضِيفَت المدنيةُ المركزيةُ الممتدةُ خلالَ خمسةِ آلافِ عامٍ على نمطِ الحياةِ ذاك، الذي تطََوَّرَ بصفتهِ مجتمعِ الزراعةِ – القرية. كنتُ قد جَهِدتُ لسردِ تَقَدُّمِ ثقافةِ حياةٍ مهيمنة، وعرضِها على شكلِ خطوطٍ عامة أو ضمن مراحل – مدارات، حيث أنها أثرت حتى يومنا الراهن عبر ثنائيةٍ يمكننا تسميتها بمجتمعِ الزراعةِ – القريةِ ومجتمعِ المدينةِ – التجارةِ – الحِرفةِ والصناعة. هذا وقد عَرَضتُ في الفصلِ السابقِ سياقَ هذه الثقافةِ المهيمنةِ في أوروبا خلال القرونِ الخمسةِ الأخيرة.
جليٌّ أنّ هذه الثقافةَ بنشوئِها ونضوجِها، بل وحتى بأزماتِها البنيوية، مشحونةٌ أساساً ببصماتِ مجتمعِ الشرقِ الأوسط. هذه هي الثقافةُ والمجتمعُ الذي سعيتُ لسردِ معناهما. ورغمَ وفرةِ واحدياتهِا الانفرادية، ورغمَ تشكيلِ الحداثةِ الأوروبيةِ إحدى أهمِّ واحدياتهِا؛ إلا إنّ القيامَ بتجريدٍ وتصنيفٍ بمعنى واحديِّ الواحديات، أمرٌ ممكنٌ في كلِّ الأوقاتِ من حيثُ التوقيتِ والمكان.
حالةُ المجتمعِ بوصفِه واحدياً تُحَدِّدُ حياةَ النوعِ البشريّ. أي أنّ الواحديةَ والفرقَ بين حياةِ الإنسانِ الذي في أفريقيا وحياةِ ذاك الذي في الشرقِ الأوسط تحَُدِّدُهما حالةُ ذاك المجتمع. بينما العِرقُ والخصائصُ الطبيعيةُ الأخرى غيرُ مُحَدِّدة.
فالإنسان الذي بلا مجتمع، إنْ لمَ يمَُتْ سريعا،ً لا يَغدو إنساناً حكيماً وحسب، بل قد يَغدو نوعاً قريباً من الحيواناتِ المتفاهمةِ بلغةِ الإشارةِ أيضاً. فالإنسانُ بلا مجتمع هو لاإنسان. ذلك أنّ أشَدَّ عقابٍ يُمكِنُ التعرُّض له هو طردُ إنسانٍ خارجَ المجتمع، أو التحولُ إلى إنسانٍ بلا مجتمع. فالإنسانُ يَستَقي كلَّ قوتِه من المجتمع. ومستوى أرقى العلومِ والحِكَمِ مرتبطٌ بالمجتمع. في حين أنّ تقييمَ الحياةِ الاجتماعيةِ على أنها محضُ كمياتٍ ومناظرَ فيزيائيةٍ بسيطة هو أشنَعُ خيانةٍ ارتَكَبَتها الوضعيةُ بحقِّ الإنسان.
من هنا، لا يُمكِنُ لبلوغِ مستوى المجتمعِ البشريِّ أنْ يَجِدَ معناه إلا كحملةٍ كونية. لِنُرَتِّبْ الخصائصَ الطبائعيةَ الأساسيةَ للحياةِ الاجتماعيةِ بصِفَتِها حملةً كونية:
1 – المجتمعُ بوصفِه تاريخاً: تَشَكَّلت المجموعاتُ الواحديةُ الأرقى حصيلةَ مساعي المجموعاتِ البشريةِ وجهودِها التي امتدَّت على مدارِ ملايين السنين، ومَرَّت بشكلٍ مؤلِمٍ للغاية في الأماكنِ العصيبة، وتَطَلَّبَت كفاحاً عظيماً. وقد كانت بعضُ الأماكنِ والمراحلِ معينةً في الطفراتِ الاجتماعية.
2 – المجتمعُ بوصفِه تاريخاً يقتضي رُقِيَّ مستوى الذكاء: فمستوى ذكاءِ النوعِ البشريِّ قد حَدَّدَ مجتمعيتَه. والمجتمعيةُ بدورِها أَرغَمَت مستوى الذكاءِ هذا على التطورِ والعملِ كذهنية. فالطبيعةُ الاجتماعيةُ تتطلبُ بُنيةً مَرِنةً ذات مستوى ذهنيٍّ راقٍ.
3 – اللغةُ ليست وسيلةً للذهنيةِ الاجتماعيةِ فحسب، بل هي في الوقتِ نفسِه عنصرٌ بَنّاءٌ فيها. فاللغةُ هي إحدى الخصائصِ الأساسيةِ التي تَخلقُ مجتمعاً ما. كما تُطَوِّرُ بسرعةٍ فائقةٍ مرونةَ الطبيعةِ الاجتماعيةِ باعتبارِها وسيلةَ ذكاءٍ جماعيّ.
4 – الثورةُ الزراعيةُ هي ثورةُ التاريخِ الأكثر تجََذّرا وعَراقةً في ثقافةِ المجتمعِ الماديةِ والمعنوية. فقد تَشَكَّلَ المجتمعُ البشريُّ أساساً حول الزراعة. ولا يُمكِنُ التفكير بمجتمعٍ بلا زراعة. لا تقتصرُ الزراعةُ على تأمينِ حلِّ قضيةِ المَأكَلِ فحسب، بل وتُمَهِّدُ السبيلَ لتَحَوُّلاتٍ وتغييراتٍ جذريةٍ في وسائلِ الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ الأساسية، وعلى رأسها الذكاء، اللغة، السكان، الإدارة، الدفاع، الاستقرار، الدين، التقنية، المَلبسَ، والبنية الأثنية.
5 – تؤدي المرأةُ دوراً رئيسياً أكثر في المجتمعيةِ مقارنةً مع الرجل، نظراً لكونِها صاحبةَ الجهودِ الدؤوبةِ على الإطلاق في تأمينِ السيرورةِ الاجتماعية. فالإنجابُ وتنشئةُ الأطفالِ وحمايتُهم يحَقِّقُ تَطَوُّرَ المجتمعيةِ في المَسارِ الأموميّ. لذا، غالباً ما يَحمِلُ المجتمعُ هويةَ المرأةِ
– الأم. ووجودُ العناصرِ المُؤَنثَّةَِ في أصولِ اللغةِ والدين إنما يُؤَيِّدُ هذه الحقيقة. فهويةُ وحضورُ المرأةِ في مجتمعِ الزراعةِ – القريةِ يستمرّان في صَونِ قوتهِما.
6 – الطبيعةُ الاجتماعيةُ أخلاقيةٌ وسياسيةٌ في صُلبِها: فالأخلاقُ تُحَدِّدُ نظامَ قواعدِ المجتمع، بينما تُحَدِّدُ السياسةُ إدارتهَ. وبينما تؤُّمنُ الأخلاقُ نظامَ المجتمعِ وبقاءَه، تقَوُمُ السياسةُ بتأمينِ تَطَوُّرِه المبدِع. لذا، يستحيلُ التفكير في مجتمعٍ بلا أخلاقٍ وسياسة. فالتفسُّخُ في المستوى الأخلاقيِّ والسياسيِّ للمجتمعِ يُعاشُ بالتداخلِ مع تصاعُدِ شتى أنواعِ العبوديةِ واللامساواة.
c ( الهرميةِ الاجتماعية والدولة:
تتمثلُ أرضيةُ النظامِ الهرميِّ في قيامِ الرجل، الذي اكتَسبَ قوةً كبيرةً في الحيلةِ والطغيان، بانتزاعِ الاقتدارِ الاجتماعيِّ المترسخِ عضوياً حول المرأة، واستيلائِه عليه عبر تقاليدِ مجتمعِ القنص. أي أنّ النظامَ الهرميَّ يَجلبُ معه ولوجَ الطغيانِ والحيلةِ في حياةِ المجتمع. ويتمُّ تمثيلُ الهرميةِ أساساً من قِبَلِ الكاهنِ ممثلِ الحيلة، والعسكريِّ صاحب الجبروتِ والطغيان، والرجلِ المُسِنِّ صاحب الخبرةِ الاجتماعية. هكذا تبدأ أولى مراحلِ الصراعِ الاجتماعيِّ الكبيرِ بين المرأةِ – الأمِّ وبينهم. وينتقلُ الاقتدارُ في سياقِ المدنيةِ البِدئيةِ إلى هرميةِ الرجلِ بنسبةٍ كبيرة. بينما تبدأُ الدولةُ مع تمأسُسِ الحُكمِ الهرميِّ في مجتمعِ المدينة. ومع تنامي الشرائحِ الهرميةِ والدولتيةِ في المجتمعات يَفسُدُ النظامُ الأخلاقيُّ والسياسيّ، وتَكتَسِبُ الأحداثُ المعاديةُ للمجتمعِ سرعةً ملحوظة. وبالإمكانِ ترتيبها على النحوِ التالي:
1 – مجتمعُ المدينة: بينما يُفسَحُ المجالُ أمام تطورٍ اجتماعيٍّ مختلطٍ حصيلةَ تقسيمِ العملِ الذي شَرَعَ به مجتمعُ المدينةِ مع مجتمعِ الزراعةِ تأسيساً على التجارةِ والحِرفة، فإنّ التطوراتِ الاجتماعيةَ المضادةَ الحاصلةَ نتيجةَ تمأسُسِ الشريحةِ الهرميةِ والدولتيةِ في الأعلى تكتَسِبُ سرعةً بارزةً مع المدينة. تتسترُ مناهَضةُ المجتمعيةِ هذه في أساسِ التناقضاتِ والمشاكلِ الاجتماعية.
2 – المجتمعُ الطبقيّ: اكتسابُ تمأسُسِ الهرميةِ والدولةِ العمقَ والاتساعَ يؤدي إلى تَصَدُّعِ المجتمعِ إلى شِقَّين. طابعُ الطبقيةِ هو عنصرُ فرضِ الاغترابِ على الطبيعةِ الاجتماعية. حيث يُطَوِّرُ هجوماً أيديولوجياً وتنظيمياً مضاداً للمجتمعِ على جميعِ المستويات. أما الهرميةُ والدولة فتقومان بإحلالِ المجتمعِ الطبقيِّ المُصطَنَع، الذي يَسُودُه الكذبُ والرياءُ والطغيان، مَحَلَّ المجتمعِ الطبيعيّ. وتُطَوِّران ضمن الشرائعِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفلسفيةِ والعلميةِ عبارات ومقولات التحريفِ والتعتيمِ والتشويهِ المضادِّ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ.
3- المجتمعُ الاستغلاليّ: تُشادُ مؤسسةُ الهرميةِ والدولةِ أساسا على ترَاكُماتِ قِيمَِ المجتمعات. حيث توَُحِّدُ الحاجةَ البارزةَ قسميا لوجودِ إدارةٍ مع احتياجاتِ الدفاعِ والمَأمَن، مُحَقِّقةً مقابلَ ذلك نهبَ القيمةِ الاجتماعية، والذي يغَدو تدريجيا حالةً لا تطُاق. ويؤدي العنفُ والوسائلُ الأيديولوجيةُ معاً وظائفَهما في ذلك. ثم تنقسمُ المجتمعاتُ الاستغلاليةُ إلى مجالاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ وماليةٍ ارتباطاً بأشكالِ وميادينِ تحقيقِ الاستغلال.
4 – المجتمعُ المحارب: هو شكلُ المجتمعِ الذي يتحققُ فيه نهبُ القيمةِ الاجتماعيةِ بالعنفِ بدل الإقناع. فالحربُ هي أكثر أشكالِ الاغترابِ تَطَرُّفاً ووحشيةً داخل الحياةِ الاجتماعية. فهي تَجرَحُ الطبيعةَ الاجتماعيةَ من الصميمِ وتَجعلها معلولة. وفي هذه الحالة تنتعشُ ردودُ أفعالِ المجتمعاتِ لحمايةِ ذاتِها، مُتَّخِذَةً شكلَ حربِ الدفاعِ الذاتيِّ لحمايةِ الوجودِ الاجتماعيِّ في وجهِ حربِ الاغترابِ المفروضة.
d ( الهوية الاجتماعية:
الواحدياتُ الاجتماعيةُ ذات مُكَوِّناتٍ غنية. حيث تشَُكِّلُ الواحدياتُ في داخلِها عدداً جماً من تصنيفاتِ واحديةِ الواحديات. أما الموقفُ الذي ينظرُ إلى المجتمعاتِ بأنها ذاتُ هويةٍ أحادية، فينبعُ من الأنظمةِ الهرميةِ والدولتيةِ التي هي عناصرُ الاغتراب. أي أنّ مفهومَ الهويةِ المنغلقةِ والصارمةِ هو إرغامُ من تلك الأنظمة. والدولةُ القوميةُ أرقى أشكالِ هذا النظام. بينما الهوياتُ أشكالٌ اجتماعيةٌ تتماشى وخصائصَ تَطَوُّرِ المجتمع. وهي منفتحةٌ على تأليفِ تركيبةٍ جديدةٍ مع الهوياتِ الأخرى. ما من مجتمعٍ بلا هوية. ذلك أنّ الهويةَ أيضا وجوديةٌ بقدرِ الأخلاقِ والسياسةِ على أقلِّ تقدير. بإمكاننا ترتيب أبرزِ الهوياتِ الاجتماعيةِ المتميزةِ بالمجالاتِ التعدديةِ على الشكلِ التالي:
1 – الهوياتُ القَبلَيِةُّ والعشائرية: أولُ هويةٍ في تطوُّرِ المجتمعاتِ كانت على شكلِ قبائل. حيث أن من العسير نعت الكلان بالهوية، لأنها لا تزالُ في بداياتِ الاختلافِ والتباين. ولكن، بالإمكان تقييم الكلان كهويةٍ بدئية، أي كهويةٍ تمهيديةٍ هي بمثابةِ الخليةِ أو العائلةِ النواةِ لجميعِ الهويات. من هنا، فالعشائرُ وكذلك القبائلُ، باعتبارِها اتحادَ العشائر، هي الهويةُ الأكثر متانةً في الحياةِ الاجتماعية. وعلى الرغمِ من القوى المضادةِ للمجتمعية إلا أنه لا مَهرَبَ من تشكيلِ القبائلِ والعشائرِ – التي خَبا نجمُ عهدِها
-على شكلِ ضربٍ من ضروبِ مظاهرِ المجتمعِ المدنيّ. ذلك أنه كما لا تتَكُونُ المجتمعاتُ بلا كلانٍ أو عائلة، فمن غيرِ الممكنِ أنْ تَتواجدَ دون قبائلَ وعشائر أيضاً.
2 – الهويات القومية: وتتطورُ كشكلٍ أرقى للعشائرِ المرتكزةِ إلى أصولٍ لغويةٍ وثقافيةٍ مشتركةٍ على مدى التاريخ. وهي غالباً ما تُوجِدُ لنفسِها مكاناً مشتركاً تَنظُرُ إليه كبلَدَأو وطن. ومن الأصحِّ والضروريِّ إضفاء المعنى على مصطلحَي البلدِ والوطنِ بوصفِهما ثقافة. لا يُشتَرَطُ أنْ يَبلغَ كلُّ مجتمعٍ مستوى القوم. هذا وقد يَحيا عددٌ جمٌّ من مختلفِ الكلاناتِ والقبائلِ والعشائرِ وحتى الأقوامِ الأخرى ضمن ثنايا القوم. أما مفهومُ الهويةِ المتجانسة فهو إرغامٌ تَفرضُه فاشيةُ الدولةِ القومية.
3 – الهوية الوطنية: في حالِ إحياءِ هويةِ القومِ على شكلِ إدارةٍ مستقرةٍ ودائمة بالمستطاعِ تسمية الهويةِ التي ستتشكلُ عندئذٍ بالأمة أو الهوية الوطنية. الجانبُ الذي يَسُودُ الأمةَ هو قدرتهُا على إدارةِ نفسِها بإرادتهِا الذاتية. هذا وقد تتطورُ الإدارةِ وفق الشكلِ الديمقراطيِّ أو الدولتيّ. وفي هذه الحالة فالأممُ الأخرى، أو بالأحرى الشعوبُ ومجموعُ القبائلِ الخاضعة لإدارةِ الأقوامِ ذاتِ الحُكمِ الدولتيّ، تسُمى حينها بالعبيد، لا الأمة. ففي المجتمعاتِ الاستغلاليةِ يتمُّ تأمينُ النمطيةِ باسمِ الأمةِ الواحدة، ولا تُتاحُ فرصةُ الحياةِ بحريةٍ ومساواةٍ للأممِ الأخرى، بل وحتى للوحداتِ والخلايا السفليةِ ضمنها. في حين أنّ الأنظمةَ الديمقراطيةَ تنفصلُ وتتمايزُ عن الأنظمةِ المضادةِ للمجتمعية من خلالِ إفساحِها المجالَ أمام الهوياتِ التعددية.
e ( المقدسات الاجتماعية:
مصطلحُ القدسيةِ تعريفٌ مجتمعيٌّ لِما هو ساحرٌ ومعجزيٌّ خارق. أي أنّ المقدسَ هو المجتمعُ بالذات. ولكنّ المجتمعَ لا يستَقبِلُ ذلك بوعيٍ علميّ، بل بأشكالِ الوعيِ التي نُسَمّيها بالدينيةِ والميثولوجية. والمجتمعُ بذلك – في حقيقةِ الأمرِ – يعَُرِّفُ عن ذاتهِ. قد يكَُونُ من المفيدِ المقارنة بين التعريفِ بالوعيِ الدينيِّ والميثولوجيِّ والتعريفِ بالوعيِ العلميّ. هذا وينبغي عدم النسيان أنّ الميثولوجيا والدينَ والفلسفةَ تَكمنُ في جذورِ العلم. ونشاط المجتمعِ الذهنيُّ يتركزُ دوماً على تعريفِ ذاته، سواءً كان مقدساً أم وضعياً. وهذه هي بعضُ المقدساتِ الهامة:
1 – الألوهيات: الأديانُ الكبرى الثلاثةُ على السواءِ تُقابِلُ ما هو كونيٌّ في المثاليةِ الشيئانية. فالروحُ المطلقةُ لدى هيغل هي الذكاء ) Geist (. وهي الشيوعيةُ عند كارل ماركس، بينما هي الدولةُ القوميةُ في القومويات. معنى الألوهيةِ في علمِ الاجتماعِ مرتبطٌ بالهويةِ الاجتماعية. وقد تقُابلُِ الاصطلاحَ الذي يعَُبرُِّ عن أرفعِ مستوياتِ التجريدِ المجتمعيّ. إذ لا معنى لعظمةِ اللهِ خارجَ إطارِ المجتمع. ولا يُمكِنُ أنْ يتواجَدَ اللهُ إلا بالمجتمع. وسواءً استَقبَلَه المجتمعُ على أنه الكونُ برمتِه أم وَطَّدَه في داخلِه كعقيدة؛ فلن يختلفَ في الأمرِ شيء. وتجسيدُ ذلك في الفلسفةِ هو المثاليةُ الذاتانيةُ والشيئانية. في حين أنه يقَتصَرُ في العلمِ على الذاتِ والموضوع. وبهذا الأسلوب، بالإمكانِ استنباط كلِّ شيءٍ من الإله )الله( على أنه شيءٌ ومعنى.
وإذ ما عَبَّرنا عن ذلك باللغةِ العلمية، فمستوى المعنى لدى الإنسانِ يتناسَبُ طردياً مع مجتمعيتِه. فقوةُ المعنى لديه تتحدَّدُ برُقِيِّه الاجتماعيّ. أما قوةُ المعنى لدى الفردِ المبتورِ من المجتمع، والذي تَفرضُه الليبراليةُ الرأسمالية، فهي كذبٌ ميثولوجيٌّ بكلِّ معنى الكلمة. فالفردُ المبتورُ من المجتمعِ لا يُمكِنُه أنْ يحيا المعنى والرُّقِيَّ العقليَّ إلا بقدرِ ما لدى عضوٍ ضمن مجموعةِ قِرَدة.
2 – النبوة: هي الحلقةُ الثانيةُ من المقدساتِ الاجتماعية. وتَدُورُ المساعي لتعريفِها بصفاتٍ من قبيلِ التَّنَبُّؤِ بالغَيبِ والتحوُّلِ إلى رسولِ الإله. فالنبيُّ يتشاطرُ التصنيفَ نفسَه مع طبقةِ الرهبانِ الفوقية. وبينما يَكُونُ الفيلسوفُ مُرادِفَه المُقابِلَ له في الفلسفة، فهو الأكاديميُّ في العلم. هذا ويتشاطرُ المتنورون الرفيعو المستوى التصنيفَ عينَه أيضاً. والميزةُ المشتركةُ لجميعِهم هي مكانتُهم التي تُخَوِّلُهم لإيضاحِ المعنى الاجتماعيِّ على أعلى المستويات.
وتقييمُ المجتمعِ بهذا المستوى الرفيعِ لمكانتِهم في المعنى إنما يتأتى من تجسيدِهم الجوهريِّ لوجودِه. فهم بمثابةِ مرآةِ المجتمعِ وضميرِه. والمجتمعُ من حيث المضمونِ يُقَدِّسُ ذاتَه المتمثلةَ في شخصِ هؤلاء. هذا وبالمقدورِ تعريف التقديسِ على أنه إضفاءُ القيمةِ والمعنى على الذاتِ والسموُّ بها وتَجميلُها.
3 – الحِكمة والشاعرية: هما حلقةُ تقديسٍ من المرتبةِ الثالثة، وتقومان بالوظيفةِ عينِها. فهما حامِلَتا القيمةِ والمعنى والكلمةِ للمجتمع، وتُعَبِّران عن الموقفِ الأخلاقيِّ والشاعريّ. إنهما ممثلتا الكلامِ والفنِّ للعِزّةِ والقيمةِ الاجتماعية. هذا وتتميزان بعيشِ المعنى المجتمعيِّ والتعبيرِ عنه بأعلى الدرجات.
– الأشياءُ المقدسة، الفَتَشيات: يتمُّ تقديسُ الأشياءِ الأكثر مساهمةً في حياةِ المجتمعِ وبقائِه متماسكاً ومتمكناً من إنجازِ الحَمَلات. وانتقالُ القدسيةِ إلى الأشياءِ يعَودُ إلى تعبيرِها عن قيمتِها في تلبيةِ حاجةٍ من حاجاتِ المجتمعِ المصيرية. فبقدرِ ما يَكُونُ شيءٌ ما قَيِّماً وثميناً ويُجعَلُ فَتَشِيَّاً؛ فهو يَتَمَتَّعُ بالقدسيةِ بالمِثل؛ من قبيلِ القمحِ والزيتونِ والغَنَمِ والبَقَرِ والحصانِ وغيرهم على سبيلِ المثال.
f ( الحقيقة الاجتماعية وفقدانها:
الطبيعاتُ الاجتماعيةُ طبيعاتٌ جانبُها الذهنيُّ راقٍ ومَرِن، ومشحونةٌ بالمعنى. وحِملُ المعنى لدى الأحياءِ أكثرُ عموماً مما لدى الجوامِد. موضوعُ الحديثِ هنا هو زيادةُ المعنى بالتوجُّهِ من أبسطِ جُسَيماتِ الذّرّةِ صوبَ أعقَدِ مُكَوِّناتهِا. ولزيادةِ المعنى صِلةَ مع الحرية. فالطَّرَفُ المسمى بالجُسَيمِ الماديِّ المُتَصَلِّبِ ضمن ثنائيةِ الطاقةِ – المادة، مُكَلَّفٌ دوماً بعرقلةِ المعنى، مثلما الجدارُ تماماً. فالجدارُ يصَُونُ ما في داخلهِ، ولكنه في الوقتِ نفسِه يحَبسِه.
هذه القرينةُ موجودة في كلِّ ظاهرةٍ في الكون. فبينما يَكُونُ الجدارُ وسيلةَ دفاعٍ وحمايةٍ تامّةٍ أحياناً، فإنه يَغدو وسيلةَ سجنٍ أيضاً في بعضِ الأحايين. وهكذا ميزة تتواجَدُ دائما في قِسمِ المادة. ثمة ترَاكُمٌ في المعنى راقٍ للغاية ضمن الطبيعةِ الاجتماعية )في الكون، في المادة(. فالأنسجةُ والأعضاءُ والبنى والأنظمةُ الاجتماعيةُ تُحَدَّدُ مضموناً من حيث المعنى. فالمجتمعاتُ التي وَصَلَت بمعانيها إلى أفضلِ لغةٍ وكلامٍ وبُنية تَبلغُ بذلك تعريفَ المجتمعاتِ الأرقى. أي أنها مجتمعاتٌ بلغَت مستوى رفيعاً من التحرر. والمجتمعاتُ الحرةُ هي تلك التي تَعِي ذاتَها وتَجعلُ صوتَها مسموعاً وتَكُونُ ضليعةً في التعبير عن نفسِها وتَبني ذاتَها بمنوالٍ متعددِ الجوانبِ بما يتوافقُ واحتياجاتِها. أما المجتمعاتُ المفتقرةُ إلى الحرية، على النقيضِ من ذلك، فهي تلك المجتمعات العاجزةُ عن تطويرِ لغتِها اللازمة للتعبيرِ عن نفسِها علناً، وعن بناءِ ذاتِها بنحوٍ متعددِ الجوانب.
تقييمُ المعنى الاجتماعيِّ وتَقَدُّمِ الحقيقةِ على مدارِ العصورِ ضمن هذا الإطار يشَُكِّلُ صُلبَ عِلمِ الاجتماع. فالحقيقةُ أساساً هي حالةُ انعكاسِ المعنى الاجتماعيِّ المتنامي طيلةَ العصورِ على وعيِ الإنسان. أي بإمكاننا تسميةَ عملِ التعبيرِ عن النفسِ بالسبلِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفلسفيةِ والفنيةِ والعلميةِ على أنه عملُ تَقَصّي الحقيقةِ والتعبيرِ عنها. المجتمعاتُ ليست نسيجاً من الحقيقةِ فحسب، بل هي قوةٌ إظهاريةٌ وتوضيحيةٌ في الوقتِ عينِه. ومَن يعجزُ عن إظهارِ حقيقتِه يمثل أثقل أوضاعِ العبوديةِ والصهرِ والإبادة. وهذا ما يشُِير بدورِه إلى السقوطِ في وضعٍ أشَبهَ بضربٍ من الانقطاعِ عن الوجودِ والخروجِ من كَونِه واقعاً قائماً. والمجتمعُ – بل وحتى الفردُ – بلا حقيقة يعني أنه بات كائناً بلا جدوى أو معنى، منصهراً في بوتقةِ حقيقةِ ذواتٍ أخرى، ومفتقراً لهويتِه هو. أو بالأحرى، طَرَأَت عليه حالةُ كائنٍ بات بلا معنى. وفي هذه الحال ثمة عُرىً وثيقةٌ بين المعنى والحقيقة. فالمعنى بمثابةِ ضربٍ من الطاقةِ الكامنةِ للحقيقة. وكلما تمَّ التعبيرُ عن هذه الطاقةِ الكامنة، وتمَّ التحدثُ عنها وبِناؤُها بِحُرّية، ستَكُون قد بَلَغَت حالةَ الحقيقة.
الترديدُ الدائمُ لعبارةِ «الحقيقة التي في داخلي »، مفادُه «الطفل العاجزُ عن التكلمِ في داخلي ». وهذا ما يعني بدورِه أسوأ الأوضاعِ الاجتماعية، والسقوطَ والاختزالَ إلى حالةِ الفرد. ذلك أنهّ لا يمُكِنُ أنْ تكَتسَبَ المعاني الاجتماعيةُ الحياةَ، ما لَم تتحَوَّلْ إلى حقيقة )بالأساليبِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفلسفيةِ والفنيةِ والعلمية(، وما لَم تَبلغْ هذه المرحلةَ والفَعالية )التحوُّل من طاقةِ كامنةٍ إلى معرفة(. فعدمُ التخلصِ من الطفولةِ يعني عدمَ التمكنِ من تخَطّي اللغةَ السُّوقيةِ المُبتذَلةِ والتهَّكمِيةّ. وهذا الوضعُ بدورِه أيضاً يُشِير إلى العجزِ عن بلوغِ حالةِ الحقيقة. والوقائعُ الاجتماعيةُ القابعةُ تحت نيرِ القمعِ والاضطهادِ تحيا هذا الوضعَ بكثافة. وإذا ما نظََرنا في الواقعِ الاجتماعيِّ من زاويةِ الحقيقة فسنُلاحِظُ أنه من الممكن الانتقال من حالةِ المجتمعِ الواعي إلى حالةِ المجتمعِ الذي يَملكُ الحقيقة، فيما إذا تَمَكَّنَت الوقائعُ )الطبيعاتُ والبُنى الاجتماعية( من إعادةِ بناءِ وتنشيطِ وتنظيمِ ذاتِها والتعبيرِ عن نفسِها من خلالِ أساليبِ البحثِ عن الحقيقة، أياً كانت الأساليب )ميثولوجيةً أم دينيةً أم فنيةً أم فلسفيةً أم علمية(. ولدى رَصدِنا العصورَ الاجتماعيةَ من جهةِ الحقيقة، فبوِسعِنا تَبيانَ ما يلي:
1- عصر الكلانات الاجتماعية: نظراً للعجزِ السائدِ عن اكتسابِ معنى مُعَقَّد في هذا العصر، فعادةً ما يُعَبَّرُ عن الحقائقِ في مجموعاتِ الكلان بإطارٍ محدودٍ جداً وبلغةٍ غيرِ متطورة، وأحياناً بسرودٍ شفهية، وغالباً بلغةِ البَدَن.
2 – عصر مجتمع الزراعة – القرية: نظراً لسيادةِ بُنيةٍ أكثر تعقيداً في مواضيعِ المَلجَأِ والمَأكلِ والمَلبَسِ والتوالُدِ والمَأمَن فما هو قائمٌ هنا هو وقائعٌ اجتماعيةٌ ذاتُ آفاقٍ وفيرةٍ جداً في المعنى. إذ يَبدأُ بالتطوُّرِ عصرُ حقيقةٍ تتوازى وآفاقَ المعنى. ونخصُّ بالذكرِ أنّ عصراً من الحقيقةِ الميثولوجيةِ والدينيةِ والفنيةِ المتناميةِ بالتمحوُرِ حولَ المرأةِ – الأمِّ )عصر هياكلِ المرأةِ – الأمِّ البدَِينة( يَظهَرُ على المسرحِ بكلِّ قدسيتِه، فتَبدأُ اللغاتُ بالتطور. وتَبتَدئُ قدرةُ التعبيرِ الميثولوجيِّ والدينيِّ والفنيِّ عصراً ذا قيمةٍ عريقةٍ عُليا. إنه أبهى عصورِ ما قبل التاريخ. وهو العصرُ الذي يُصَرِّحُ فيه المجتمعُ عن نفسِه لأولِ مرةٍ على شكلِ حقائق مقدَّسة )بالأساليبِ الميثولوجية والدينيةِ والفنية(. ولا تَفتَأُ البشريةُ تقتاتُ على إرثِ تلك الحقبة. هذا ورُصِفَت أرضيةُ شكلَي الحقيقةِ الآخرَين أيضاً، وفي مقدمتِهما الحِكمةُ الفلسفيةُ والطبُّ العلميّ. ذلك أنّ حِكمةَ المرأةِ وطبَّها احتَلا مكانةً هامةً في الحياة، بصفتِهما الحقائقَ الأكثرَ تأثيراً في تلك الحقبة. ويُعزى سببُ كونِ ألوهيةِ المرأةِ سائدةً في تلك الحقبةِ إلى القوةِ التي تَمَتَّعَت بها المرأةُ في الميادينِ الخمسةِ الهامةِ للحقيقة. وتأديتها دوراً رئيسياً في تطويرِ الزراعةِ والاقتصادِ المنزليّ يتسترُ وراءَ اكتسابهِا هذه القوةَ دون أدنى شك.
3 – عصر مجتمعِ المدينةِ والمدنية: طَوَّرَت المجتمعيةُ المتزايدةُ مع التمدنِ نقيضَها أيضاً، بِحُكمِ الدياليكتيك. وقد وَلَّدَ التضادُّ الدياليكتيكيُّ في هذا العصرِ التفاوُت الطبقيَّ الاجتماعيَّ والدولة. هذا التحوُّلُ الطبقيُّ والدولتيُّ المتصاعدُ كانحرافٍ وشذوذٍ اجتماعيّ، أَفضى إلى تَصَدُّعٍ وانقسامٍ غائرَين في مضمارِ الحقيقةِ الاجتماعية. ونظراً لأنّ التصدعاتِ والانقساماتِ تكَوَّنتَ على أساسِ التضادّاتِ المشتملةِ على العنف فإنّ عصرَ قمعِ الحقائقِ بالعنفِ أيضاً يكَونُ قد بدأ. ويظُهِرُ هذا الوضعُ نفسَه في الواقعِ العَينيِّ في هيئةِ حربِ الحقائقِ أيضاً.
تحميلُ الحقائقِ بمعنى الطبقةِ والدولةِ قد اختَزَلَها إلى حالةِ جوهرِ التاريخ. فقد أُنشِئَ التاريخُ ودُوِّنَ بمنوالٍ سيظلُّ ممهوراً بطابعِ الطبقةِ والدولة، أيَّما وكيفما كان الأسلوبُ المُتَّبَعُ في التعبيرِ عنه. إنّ تَصَدُّعَ الواقعِ الاجتماعيّ، وبالتالي الحقيقة الاجتماعية، هو أساسُ جميعِ أشكالِ الاغتراب. وارتباطاً بتحريفِ المعنى الاجتماعيّ فإنّ الاغترابَ يعني عَرقلةَ حقيقتِه عن التعبيرِ عن الواقعِ القائم. و يُفيدُ أيضاً بالانتقالِ بها إلى أشكالِ التعبيرِ عن الواقعِ القائمِ معكوساً. من هنا، فاغترابُ الفردِ الاجتماعيِّ جذريّاً هو أسوأُ السيئاتِ في التاريخ. وبالمستطاع تفسير الاغترابِ الاجتماعيِّ على أنه خيانةٌ تاريخيةٌ أيضاً.
يَجري الاغترابُ على جميعِ المستويات، ويَشملُ كافةَ ميادينِ الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ في المجتمع. ولدى توحيدِ الاغترابِ عن الكدح مع الاغترابِ الذهنيّ سيغَدو نظامُ المدنيةِ المهيمنةِ قادراً على الاستمرارِ بذاته. بناءً عليه، فلا يُمكن تعريف عصرِ المدنية، الذي يُعَدُّ نظامَ المجتمعِ الطبقيِّ والدولتيّ، إلا بأنه تطبيقٌ على أساسِ تَصَدُّعِ واغترابِ الميادين الاجتماعيةِ حتى أعمقِ الأعماق.
المدنيةُ واقعٌ تَجَزَّأَت مجتمعيتُه بحيثُ تَجعلُ الاشتباكَ أمرا واردا على الدوام. وتنُشِئُ وجودَها بصفتهِا بحثا غائراً عن الحقيقةِ وصراعاً مُحتَدّاً عليها. وبقدرِ ما تَقومُ القوى التَّحَكُّميةُ المُمسِكةُ بزمامِ احتكارِ الاستغلالِ والعنفِ في يدِها بقمعِ وتحريفِ وتشويهِ الحقيقةِ الاجتماعية، فإنها تُنشِئُ بالمِثلِ المجتمعاتِ المتكونةَ من المجموعاتِ والأفرادِ والشعوبِ المسحوقةِ والمستَغَلّة. وتَغدو هذه الشرائحُ تابعةً لها على شكلِ حشدٍ وقطيعِ رُعاعٍ فاقدٍ لمعناه، وبالتالي لحقيقتِه. فهذه الشرائحُ المذكورةُ لا يُمكنُ أنْ تصبحَ في وضعٍ مساعدٍ للتبعيةِ والتوجيه إلا عندما تفقدُ حقيقتَها. وما تاريخُ المدنيةِ بمعناه الضيقِ سوى تاريخُ إنشاءِ وتأمينِ سيرورةِ هذه التبعيةِ والخنوع، سواءً كمعنى أم كحقيقةٍ قائمة.




