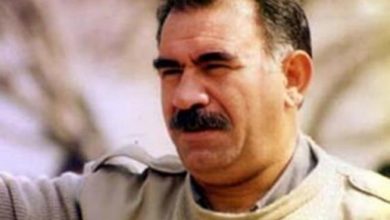المقاومةُ حياة
المقاومةُ حياة

 سرفراز شباب
سرفراز شباب
مهما بلغتِ الأمم من درجاتِ التحضّرِ وحقّقت من إنجازات في ميادينِ الحياةِ, فإنّها تبقى مدينةً لتاريخها وعلى وجهِ التحديدِ نضالاتِ أبنائها في سبيلِ الحفاظِ على الوجودِ وإنجاز التحرّرِ وتجسيدِ مفرداتِ الهويّة بما تشتمل عليه من خصوصيّةٍ وفرادةٍ تميّزها عن سائرِ الأممِ والقوميّات. وما من أمةٍ إلا وتعتبرُ مرحلةَ المقاومةِ أنصعَ ما في تاريخها, تجدّدُها في حياتها على كلِّ المستوياتِ وتعتزُّ بالانتماء إليه, في تأكيدٍ على استمراريّتها ومواصلتها لحالةِ المقاومةِ نهجاً للحياةِ لا يتوقّفُ على ظرفيّةٍ محدّدةٍ ولا يتعلّق بشروطٍ.
من نافلةِ القولِ أنَّ تاريخ الأممِ والدولِ حافلٌ بشتّى أنواعِ الصراعِ والاقتتالِ, وأنّه شهِد تجاوزَ دولٍ وممالك على أخرى مجاورةٍ وضمِّ أراضيها واستلحاقِ شعبها, أو أنّ الامبراطورياتِ تشكّلت عندما جرّدت دولٌ قويّة حملاتٍ عسكريّةً ضخمةً وسيّرت الجيوشَ تجوبُ أنحاءَ المعمورةِ وتُخضِع الشعوبَ على اختلافها لحكمِها كما فعل الاسكندرُ المقدونيّ والتتارُ والمغولُ والعربُ المسلمون والصليبيون والعثمانيون ودولُ الغرب الاستعماريّ, وغير ذلك كثيرٌ, لدرجة أنّه يمكنُ القولُ أنَّ الحروبَ تؤرّخُ فعلاً للوجودِ الإنسانيّ, وأنَّ السلامَ والتعاونَ حالةٌ طارئةٌ في علاقاتِ الأممِ بانتظارِ امتلاكِ القوة التي تمكّن من انقلابِ أحدهما على الآخر, وما علاقاتُ التحالفِ والتنسيقِ التي يشهدها عالم اليوم ويتمُّ في ظلّها تبادلُ المصالحِ واقتسامُ مناطقِ النفوذِ إلا شكلٌ مقنّعٌ للتنافسِ والحربِ الباردةِ تمليها الضرورةُ, نظراً لعدمِ ضمانِ نتائجِ الصراعِ المسلّحِ. كما وتعدّدت أسبابُ ومظاهرُ الانقلابِ في علاقاتِ الأممِ, إلا أنّ القاسمَ المشتركَ بينها كلّها كانَ الاحتكامَ إلى مبدأ القوةِ, سواءٌ كانت عسكريّةً أو اقتصاديّةً أو ثقافيّة, وبالنتيجة كان القويُّ ينتهجُ سياسةَ الهيمنةِ مقابلَ فرضِ التبعيّةِ على الضعيفِ, وهي سياسةُ تنطوي على إقرارٍ بالوجود والثقافةِ والحقوقِ لجهةٍ وإنكارها لجهةٍ أخرى, وبالمجملِ هو إحياءٌ لأمةٍ على حسابِ موتِ أمةٍ أخرى استناداً لمنطقِ القوةِ.
وإذا كانت الأمةُ قد مرّت بمرحلةِ الضعفِ نتيجةً لظرفيّة تاريخيّةٍ معينةٍ أو لأسبابٍ ذاتيّةٍ موضوعيّةٍ فوقعت أسيرةَ الهيمنةِ الخارجيّة أو أنظمةِ الاستبدادِ ومصادرةِ إرادةِ الحياةِ, فإنّها ستحاول تلمّسَ أسبابَ استعادةِ قوّتها وبذلِ الجهدِ للخلاصِ والتحرّرِ وامتلاكِ ناصيةِ قيادةِ نفسها وصولاً لإزالةِ أدنى أشكالِ الوصايةِ المفروضةِ على أيّ جانبٍ من جوانبِ الحياةِ والتحكّم بمقدّراتها الوطنيّة, واستعادةِ دورها الطبيعيّ كأمّة مستقلّةٍ حرّةٍ تجسّد معانيَ الأصالةِ وتفاصيلِ منظومةِ قيمِها الأخلاقيّةِ والمبادئِ الثابتةِ التي تؤكّدُ هويتَها وتميّزَها. وبالتالي تصحيحَ مسارِها.
وفقَ هذه المعطياتِ يمكنُ فهمُ المضمونِ الحقيقيّ للمقاومةِ بأنّها الحركةُ المنظّمة لأبناءِ الأمّة في مواجهةِ محاولاتِ الانتقاصِ أو المسِّ بوجودها, إن كان على مستوى الكيانِ السياديّ السياسيّ أو الوجود الواقعيّ على الأرضِ أمام حملاتِ العدوانِ المسلّحِ والاجتثاثِ من الوجودِ وما يتصلّ به من خصوصيّة فكريّة وثقافيّة واجتماعيّة كالصهرِ في بوتقةِ الأممِ الأخرى وحملاتِ الإبادةِ الثقافيّةِ. وبالتالي فإنّ حالةَ المقاومةِ لا يمكن اعتبارها موقفاً ارتجاليّاً عابراً في تاريخِ الأمةِ أو وصفُها على أنّها ردّةُ فعلٍ إزاءَ واقعٍ حاقَ بها على نحوٍ طارئٍ, إذ لطالما كانتِ المقاومةُ وعلى الدوامِ هي خيارَ بقاءَ الأمةِ واستمرارِها في الحياةِ لأنَّ البديلَ هو الاندثارُ والمحوَ من الوجودِ.
ولما كانت كلُّ الأممِ وبصرفِ النظرِ عن أعراقِها وألوانِها وأديانِها ومعتقداتِها وحتى تعدادِها تتمتعُ بحقِّ الوجودِ على قدمِ المساواةِ دونما تمييزٍ بينها, فإنَّ الأعرافَ قديمها وحديثها والمواثيقَ والقوانينَ الدوليّة اليوم تقرُّ لها ذلك وتضمنُ حقَّ الأمة في الدفاعِ عن ذاتِها وهويتِها وأن تسلكَ فيما يعزّز هذا الوجودَ ما تراه مناسباً وتستخدمَ ما يلزمُ من أدواتٍ ووسائلَ في الإطارِ المتعارفِ عليه لمفهومِ المقاومةِ, وبهذا المعنى فإنَّ العدوانَ على مرِّ التاريخِ وأيّاً كان شكلُه ومستواه كان يُقابلُ بالمقاومةِ التي تؤكّد حالةَ الرفضِ للتبعيّةِ والاندثارِ.
وفي مقاربة أكثر وضوحاً للفكرة, يمكن القول أنّ الأمة في حالةِ المقاومةِ تخوض الصراعَ من أجل البقاء, وما قصصُ الدولِ والممالكِ البائدةِ إلا أمثلةٌ لجهةِ قصورِ المقاومةِ عن تحقيقِ الهدفِ, فكانت النتيجةُ هي الفناءُ والزوالُ ككياناتٍ سياديّةٍ وتحوّلُ الشعوبِ والقومياتِ إلى أقليّاتٍ محكومةٍ من قبل غيرِها على أرضِها, فالأوروبيون البيضُ المهاجرون إلى أرضِ الأحلامِ أمريكا مثلاً أقاموا دولتَهم الحديثةَ وهي الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيّةُ على حسابِ جماجمِ عشراتِ الملايين من الهنودِ الحُمرِ سكانِ الأرضِ الأصلاءِ في أسوأ حربِ إبادةٍ عرقيّةٍ عرفتها البشريّة.
بالمقابل فإنَّ حركات التحرّر الوطنيّ في أنحاء مختلفة من العالم استطاعت اجتراحَ معجزةِ النصرِ وإنجازِ الاستقلالِ الوطنيّ ضدَّ قوى الاحتلالِ, فالفيتناميون مثلاً خاضوا حربَ مقاومةٍ على مدى حوالي ثلاثة عقودٍ ضدَّ القواتِ الأمريكيّةِ الغازيّةِ وأصبحت هانوي ليست مجرّد عاصمةَ البلادِ بل عاصمةَ المقاومةِ في العالمِ ورمزاً لها. وكذلك كانت الحركةُ البوليفاريّة في أمريكا اللاتينيّة بقيادة سيمون بوليفار والحزب الشيوعيّ الكوبيّ بقيادة المناضل فيدل كاسترو ورفيق دربِه أرنستو تشي غيفارا الذي غدا أمثولة النضالِ التحرّريّ في العالم, وأصبح المهاتما غاندي رائدَ النضالَ السلميّ في العالم عندما واجه آلةَ القتلِ للمحتلِ البريطانيّ لبلاده بصدرٍ عارٍ حتى تحقّق الاستقلالُ الوطنيّ.
وصفحاتُ التاريخيّة تزخرُ بأمثلةٍ كثيرةٍ لأقوامٍ وشعوبٍ وجماعاتٍ بشريّةٍ كافحت وناضلت ووصلت إلى أعلى درجات البطولةِ ومرّت بمراحلَ جسّدت فيها أسمى معاني التضحيةِ ونكرانِ الذاتِ في سبيلِ الوجودِ والدفاعِ المشروعِ عن النفس، متسلّحة بروح الفداء وامتلاك الإرادة في وجه نظمِ التبعيّة والعبوديّة عبر النضال والتنظيم والوعي. والقصةُ قديمةٌ قدمَ التاريخِ الإنسانيّ, وهي لا تنحصر بمفهومِ الدولة ككيانٍ سياسيّ مستقلٍ أو صراعِ على جغرافيا محدّدة على الأرض ذاتِ خيراتٍ وثرواتٍ بقدرِ تتعلّق بإرادةِ الحياةِ نفسها كحقِّ مكتسبٍ على مستوى القبائلِ والعشائرِ والممالكِ وصولاً للدولِ, وما قام به الأنبياء والرسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد(ص) في مجتمعاتهم عبرَ الوعظِ والإرشادِ وحتى الهجرةِ والترحالِ والفداءِ إلا أمثلة أخرى لمقاومةِ الفسادِ والانحلال الخلقيّ ونظمِ الاستبدادِ والظلمِ والقهرِ والعبوديّةِ القائمة كنتيجةٍ للهوة الاقتصاديّة السحيقةِ بين أبناءِ المجتمعِ الواحدِ والمتمثّلةِ في المدنيّة الطبقيّة الدولتيّة, ونظامِ تأليه السلطانِ والحاكمِ.
وإذا كانت الثورة في معناها الشاملِ هي الانقلابُ على وضعٍ معيّنٍ والانتقالُ به من حالةٍ إلى أخرى تستجيبُ وتستوعبُ تطلعاتِ الناسِ وطموحاتِهم وتجسّد إرادتهم بما في ذلك التحرّر والاستقلال والسيادة الوطنيّة ورفع الظلم والقهر والمعاناة, فإنَّ المقاومةَ هي جوهرُ الثورةِ والتعبيرُ الأمثلُ لحالةِ الرفضِ, ولا ثورةَ حقيقيّة بلا مقاومة. فثورةُ الاستقلالِ تعني مقاومةَ وجودِ المحتلِّ بكلّ الوسائل وثورة العدالةِ الاجتماعيّةِ والحريّةِ هي مقاومةُ الاستبدادِ والقمعِ وتغييرِ النظامِ, وثورةُ العلمِ والمعرفةِ هي مقاومةُ الجهلِ والتخلّف, وبالمجملِ فالثورة من أجل تحقيقِ أيَّ هدفٍ تعني مقاومة النقيضِ القائمِ.
العملُ أيّاً كان هو إيجادُ أثرٍ أو تغييرٍ في الواقعِ أو ضمنَ إطارِ محيطِ الحياةِ ويمكنُ تلّمس آثارِه الماديّة أو المعنويّة, بصرفِ النظرِ عن كونِه عملاً عاقلاً من فعلِ الإنسانِ أو غير عاقلٍ بفعلِ الكائناتِ الأخرى أو ظاهرةً طبيعيّةً, ولكنّه عند الإنسانِ هو عملٌ هادفٌ وله غايةٌ, ويستندُ لتصوّرٍ مسبقٍ في العقل يحدّدُ حجمَ العملِ وإمكانيّته وغايته وآليةَ تنفيذه, أيّ أنّه فِعلٌ محدّدٌ بفكرٍ يوجّهه ويبرّر أسبابَه, وعلى هذا النحو يتمُّ تقييمُ عملٍ ما بأنّه ضربٌ من التبصّرِ والعقلانيّةِ أو التهوّرِ والارتجالِ, الضرورةِ أو الترفِ, وصولاً لاعتبارِه ضرورةَ حياةٍ أو سبيلَ انتحارٍ.
المقاومةُ في هذا المنحى عملٌ يستندُ في أسبابِه إلى مبرراتٍ ودواعٍ وجوديّةٍ لها إسقاطاتُها على محاورَ وطنيّةٍ وأخلاقيّةٍ وحتى دينيّةِ, ولتشكّل في تكاملها حالةَ ثقافةٍ ومحرّكاً للنضال ودافعاً لعطاءٍ غير محدودٍ وصولاً للتضحيةِ بالنفسِ, والمقاومةُ هي ذلك النوعُ من الثقافةِ المجتمعيّة التي لا تنطلقُ من مجرّد الانتماءِ الصوريّ للمجتمعِ كنسبٍ مفروضٍ لا إرادةَ اختيارٍ للمرءِ فيه, وإنّما هي حالةُ وعي لمقتضياتِ هذا الانتماءِ وما ينطوي عليه من مشاعرَ منطلقُها الإنسانُ الفردُ ومآلها المجتمعُ على اتساعِه والذي يشكّل البيئةَ الحاضنةَ لمنظومةِ القيمِ الأخلاقيّةِ والوطنيّةِ والتقاليدِ والأعرافِ الاجتماعيّةِ الموروثةِ والتي يجمعُها مفهومُ الأصالةِ, وليكونَ الضميرُ والوجدانُ الجمعيّ جسرَ تواصلٍ بين الفرد والمحيطِ الاجتماعيّ وليصل في أقصى درجاتِ تصعيدِه لحالةِ تماهٍ بين الفردِ والجماعةِ, والقول بأنّ القادةَ العظامَ كانوا ضميرَ وإرادةَ أمتهم ليس بمبالغةٍ.
من خلالِ العمل المقاوم يجسّد الإنسان أعلى درجاتِ التحرّر من الأنانيّة والروح الانتهازيّة والنزعةِ الوصوليّةِ والطفيليّةِ ويضعُ حدّاً لكلِّ المشاعر السلبيّة كالخوفِ والضعفِ واليأسِ ويمتلأ بالشعورِ بالثقةِ الكاملةِ والتفاؤلِ بتحقيق النصرِ ويتحلّى بالشجاعةِ والإقدامِ والكرمِ ونكران الذات, ولا يمكن اعتبارُ العملِ المدفوعِ بقوةِ اليأسِ وفقدان الأملِ على أنَّه من ضروبِ المقاومةِ, لأنّه مستمدٌ من حالةِ هزيمةٍ على المستوى النفسيّ ويقود إلى الانتحارِ حتى لو حقّق نتائج إيجابيّة, إذ أنّه فاقدٌ للعاملِ المحفّز ولا يرتقِ أن يكونَ قدوةً نضاليّةً, المقاومُ هو طالبٌ وصانعٌ للحياةِ الكريمةِ, وهذا فرقٌ جوهريّ بين الشهادةِ والانتحارِ في مستوى الغايةِ, هي تلك المسافة الكبيرة بين الوهمِ والحقيقةِ غير القابلة القياس, وضمن هذا الفرق يتمُّ صناعة المقاتلين المرتزقة والتلاعب بعقولِهم ليكونوا مجرّد أدواتٍ وقرابين مجانية على مذبح المصالح وكأسوأ حالةِ استثمارٍ لا تتورع عن توظيف العقائد والمشاعر وحتى الرغبات وكلّ ما تنطوي عليه النفس من ضعفٍ.
المقاومة هي حركةٌ فاعلةٌ قوامها المبادرة وليست منفعلةً بانتظارِ نتائجِ أفعال الآخرين, بل تمثّل حالة جهوزيّة مجتمعيّة تقطع الطريق على كلّ ما من شأنه المسَّ بكرامة الأمة فتحاصره وتردّه. وقولنا أنّ المقاومةَ حياةٌ نقصدُ به أنَّ الأمةَ تعيشُ المقاومةَ في حياتها الطبيعيّةِ وفي السلوكِ اليوميّ وفي عمقِ ثقافتها وليس كحالةٍ طارئة تمليها الظروفُ وحالاتُ الضرورةِ كمظلةٍ تُطوى وتُوضع جانباً حالَ انقطاعِ المطرِ, ذلك لأنّها الحالةُ التي تتمتّعُ فيها الأمة بمناعةٍ في مستوى الفكر والثقافة أمامَ محاولاتِ الصهرِ في بوتقةِ الأممِ الأخرى والصمودِ في وجهِ الإبادةِ الثقافيةِ ناهيك عن الوجوديّة والاستئصال والاجتثاث من التاريخ والجغرافيا والتشويه والتماهي في ثقافاتٍ أخرى مستوردةٍ على حساب الخصوصيّة القوميّة والوطنيّة واللغويّة تحت عناوين التمدّن والتحضّر لأنّ الثابت تاريخيّاً أنَّ تفاصيلَ خصوصيّةِ الشعوبِ لم تقف يوماً عائقاً أمام تطوّرها وأخذها بأسبابِ النموِ والارتقاء, وأنصارُ هذا المنهج إنّما يستهدفون إسقاط الأمة من الداخل, إذ لطالما كانت القلاعُ حصينةً منيعةً من الخارجِ حتى إذا أُتيحتِ الفرصةُ للعملاءِ في الداخلِ فتحوا البواباتِ ليدخلَ الغزاةُ بكلِّ يسرٍ, وبهذا المعنى تحديداً كانت جهودُ المحتلين للتضييق على الشعوب وعدمِ الإقرارِ لهم بممارسةِ ثقافتها ومنعِ لغاتها ومحو تراثها لإخراجها من التاريخِ.
المقاومة في الإطار الوطنيّ تتطلّب التضحية ونكران الذات والمبادرة لتحقيقِ الأهدافِ الاجتماعيّةِ والغاياتِ المصيريّة المتصلّةِ بالقضية الوجوديّةِ, لذا فإنّ الغايةَ الأسمى هي التأسيسُ لبناءِ المجتمعِ الأخلاقيّ السياسيّ والمؤطّر بالحرّيّة والعدالة والمساواة والأخوة والسلامِ كغاياتٍ أساسيّةٍ للمجتمعِ الإنسانيّ بدل مؤسسات القمع والتسلط المتمثّلة بالدولة كظاهرة تنطوي على شكلٍ من التنازلِ من حريّةِ الأفراد وخصوصيّاتهم لصالحِ الكيانِ السياسيّ دون المجتمعيّ بدعوى السيادة والأمنِ القوميّ ويقوم على إدارةِ مفاصلها طبقةٌ من الطفيليين المعتاشين على حساب جهد الأفراد، ويكرّسون حالة الفساد الإداريّ والهبوط الأخلاقيّ درجةَ الابتذالِ ولكنهم بالمقابل محصّنون بالمؤسسات الأمنيّة التي تنقلبُ إلى مصدرِ خوفٍ للناس بدل أمنهم والحرصِ على سلامتهم وكذلك بقوانين وقواعد قاصرةٍ عن استيعاب حركةِ الحياةِ الطبيعيّةِ كأنما وّضعت لضمانِ مصلحةِ طبقةِ محدّدة, والنتيجة النيلُ من إرادةِ المجتمع عبر تدجينه وترويضه وكسرِ إرادته بإدارةِ شؤونِ حياتِه بنفسه، والتضحية ونكران الذات هي قمة هرم النظام الأخلاقيّ للمجتمع وهو الذي يمكّنه من استعادة لأخلاقياته الاجتماعيّة والكوميناليّة وإرادته الحرّة، هنا يمكن جوهر الاختلاف بين المجتمع الحرّ الممتلك لإرادته والعبوديّة التي يتمُّ فيها استلاب هذا الحقّ ويعتاده درجة الإدمان, وما نقصده هو أن تستندَ السياسةُ إلى ثوابتَ أخلاقيّةٍ تقرُّ بالحقيقةِ الاجتماعيّةِ وحقّ الوجود، وفي هذا الصدد يذكرُ القائد عبد الله أوجلان في سوسيولوجيّة الحرّيّة، «إنّ أيّ مجتمع يفقد الأخلاق والسياسة فإنّه يفقد الحرّيّة أيضاً، والعكس هو الصحيح » و »أن وظيفةَ السلطةِ والسياسةِ في كلِّ مرحلةٍ تتجسّد في تجريدِ المجتمعِ من قوّة الأخلاقِ والسياسةِ لديه .»
إنَّ اقتصار اعتبار المقاومة شكلاً من العمل المسلّح هو اختزالٌ لمعناها, والصحيح أنّه أحدُ وجوهها, وقد لا تتأتى للأمة فرصٌ حقيقيّة لإنجازاتٍ كاملةٍ في مستوى العملِ المسلّحِ لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادتها وتكالبِ الأعداءِ عليها, لكنَّ ذلك لا يفترضُ تمييعَ القضايا المصيريّة والاستهانة بها أو الرضوخَ لحالةِ الاستسلامِ والاستكانةِ للواقعِ وتقبّله على أنّه النهاية الحتميّة والقطعيّة لمصيرها, ذلك لأنّ معنى الأمة عابرُ للزمانِ وما يُشار إليهم اليوم كأمةٍ هم في الواقعِ جيلُ الحاضرِ منها فقط, وهو أمام مسؤوليّةٍ تاريخيّةٍ لأنّ ما يتركُه وراءَه سيشكّلُ ميراثَ الجيلِ اللاحقِ, لذلك فالحدُّ الأدنى للمقاومةِ أن تضمنَ استمرارَ وجودِ الأمّةِ في مستوى الصمودِ الثقافيّ والاجتماعيّ بانتظار متغيراتٍ سياسيّةٍ واقعيّةٍ وامتلاك مزيدٍ من القوةِ, وبذلك فإنَّ استمرارَ النضالِ مستقبلاً يستمدُّ قوته من مصادرِ التاريخِ والتراثِ كأرضيّةٍ متينةٍ ومنطلقٍ وطيدِ الأركانِ.
إنّ الواقعَ الكرديَّ المعاصرَ في سائرِ دولِ تواجدِهم هو متشابهٌ, ولا يختلفُ من حيثُ النتائجِ ومستوياتِ الإنكارِ والإلغاءِ والصهرِ إلا باختلافِ البوتقةِ وشكلِ الثقافة التي يُراد إذابتهم فيها, والقاسمُ المشتركُ بينها هو استمرارُ محاولاتِ محو الشخصيّة الكرديّة في مستواها الفرديّ والقوميّ, وقد شاءت إرادةُ دولِ الغربِ الاستعماريّ في مرحلةِ ما بعد نهايةِ الدولةِ العثمانيّةِ توزيعَهم وفقَ مقتضياتِ مصالحِها, رغم التواصل الجغرافيّ للمناطقِ التي يعيشون فيها ليبقى الجرحُ الكرديّ نازفاً عبرَ عقودٍ طويلةٍ, وليصبح الكردُ مجرّد أقلياتٍ ديمغرافيّة مسلوبةِ الحقوقِ الثقافيّةِ والسياسيّةِ ممنوعة من الشراكةِ الحقيقيّةِ في بناءِ الوطنِ والسلطةِ, ولتتحوّل قضيتهم إلى ملفٍ للتداولِ والضغطِ تحتَ الطلبِ, ومن جهةٍ أخرى تصبحُ قضيةً تُناط بالمؤسساتِ الأمنيّةِ والعسكريّةِ, وليُواجهوا التهمةَ بنزعةِ الانفصاليّة وزعزعةِ الأمنِ القوميّ أو الإرهابِ أو أنّهم طابورٌ خامسٌ في حالِ مطالبتهم بحقوقِهم المشروعةِ. علماً أنَّ تاريخَ العلاقاتِ البينيّةِ للدول التي يعيشُ فيها الكردُ لا تتّسمُ بالانسجامِ والتعاونِ وحسنِ الجوارِ إلا أنَّ الموقف إزاءَ القضية الكرديّة كان محلَّ التوافق بينها, إذ أنَّ أيَّ صيغةٍ لحلٍّ ديمقراطيّ في أيّة دولةٍ سيؤدي بالضرورةِ لانتقالِ التجربةِ إلى الدولةِ المجاورةِ, وبعبارةٍ أخرى هو إقرارٌ غير مباشر من جانبِ تلكَ الدولِ بوحدةِ القضيةِ والتأثيرِ المتبادلِ فيما بينَ الأجزاءِ المفصولةِ عن بعضِها بالحدودِ المصطنعةِ, وبذلك فإنّ صيغة اللا حلّ هي المعتمدة وعلى أساسِها يتمُّ بناءُ العلاقاتِ. وبالمقابلِ فإنّ ذلك يفترضُ على الكردِ أن يعيشوا حالاتٍ من المقاومةِ تختلفُ في مستوياتها وفقاً لتغيّر الظروفِ والسياساتِ اعتباراً من الدخولِ في عمليةِ السلامِ والحلّ السلميّ التفاوضيّ وصولاً للكفاحِ المسلّح, على أنَّ المقاومةِ في شكلِها الثقافيّ والاجتماعيّ كانت مطلوبةً على الدوامِ.
انطلقت الحركة الآبوجيّة بداية سبعينيّات القرن الماضي «كحركةِ انبعاثٍ في مواجهةِ الإبادةِ الوطنيّةِ حيث استهدفَ pkk خلقَ الشعبَ الكرديَّ الذي بات على عتبةِ الزوالِ من جديدٍ على أسسٍ معاصرةٍ وحمله على الحريةِ », وبالتالي كانت حركةَ مقاومةٍ وطنيّة جوهرُها إنسانيّ وقوامُها التضحية والنكران للذات في ظروفٍ بالغةِ التعقيدِ مستمدةً عنفوانَها من قوّتها الذاتيّة والمناقبيّة العالية للشخصيّةِ الكرديّةِ المتخلّقة بقيمٍ مجتمعيّةٍ, متطلعةً إلى تحقيقِ أسمى الأهدافِ الاجتماعيّةِ المتمثّلةِ في الحرّيّة وإلغاءِ العبوديّةِ والتبعيّة البغيضةِ والتسلّطِ والانهيارِ الأخلاقيّ والممارسات القمعيّة لأجهزةِ الدولةِ الفاشيّة القومويّة التركيّة, وتجاوزتِ الحركةُ حالةَ الانغلاقِ في القوميّة الكرديّة, وجعلت منها منطلقاً لتؤكّد المضمونَ الإنسانيّ للقضية وتنادي بحرّيّةِ الشعوبِ وجلاءِ الحقيقةِ وترسيخِ مبادئِ العدالةِ من منطلقِ المساواةِ بين الشعوبِ، بدأتِ الحركةُ بعد سنين عجافٍ من الاستكانةِ والرضوخِ ترسّخت خلالها مفاهيمٌ سلبيّةٌ كعبثيّةِ المقاومةِ وعدم جدواها وعلى أنّها ضربٌ من المحالِ أقرب للجنونِ, ولذلك كان من الضرورةِ بمكان أن تكونَ البدايةُ بتنميةِ الوعي والتعبئةِ الفكريّة وتحريرِ العقولِ من زنزاناتِ الخوفِ ورهبةِ الدولةِ التي فُرِضت من قبلِ أدواتِ الدولةِ الفاشيّةِ على المجتمعِ، وذلك بهذا الشكلِ بدأ القائد عبد الله أوجلان بعمليّة إعادة صياغةِ العقلِ وترميمه وتأهيله لأبناءِ المجتمعِ الذي كان يسيرُ إلى النهايةِ والانهيارِ والفناءِ، في فهمٍ صحيحٍ للواقعِ يستندُ لعبرةِ الماضي ويحلّلُ معطياتِ الحاضرِ ويستشرفُ آفاقَ المستقبلِ, ومن خلال ذلك تمّ بناءُ منظومةٍ فكريّةٍ تعي ظرفيّة المرحلةِ ويمكنها اختيارُ الآليّةِ الصحيحةِ لتحقيقِ الأهدافِ ضمنَ إطارٍ تنظيميّ تمارسُ حالةَ المقاومةِ فعلاً عمليّاً ولا تستغرقُ في التنظيرِ, وهذا ما جعلها تمتلكُ أسبابَ الاستمراريّةِ والصمودِ ولا تهابُ المصاعبِ ولا تعرفُ النكوصَ والتراجعَ أمام التحدّياتِ مهما عظُمت وعلى استعدادٍ كاملٍ لدفعِ الثمنِ مهما غلا ولو كان دون ذلك التضحيةُ بالنفسِ. وفي بيئةٍ مفعمةٍ بروحِ النضالِ وبإرادةٍ صلبةٍ انطلقتِ الحركةُ لتطلقَ صرخةً مدويّة ردّدت صداها كلّ أرجاء الأناضول وكردستان، وتمثّلتِ الانطلاقةُ بثلةٍ من الشبابِ الذين شكّلوا النواةَ الأولى للمقاومةِ والروادَ الأوائلَ لصياغةِ معالمِ الشخصيّةِ المناضلةِ من أمثالِ «حقّي قرار، محمّد خيري دورموش, كمال بير, مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز «عكيد » وسواهم, وقد اضطلع المناضلُ عكيد بدورٍ رياديّ في التبشيرِ للثورةِ والدعوةِ لها, ومن ثم المباشرةِ الفعليّة بمرحلةِ الكفاحِ المسلّحِ وتنفيذِ العملياتِ النوعيّةِ ضدَّ قواتِ الجيشِ التركيّ في ظروفٍ استثنائيّةٍ من حيثُ قلّة الدعمِ والتموينِ والطبيعةِ الجغرافيّةِ لمناطقِ العملِ, ليصبحَ اسم الكريلا علامةً فارقةً تميّز هذا النضالَ, إذا ما أخذنا بالاعتبارِ الثقافةَ الانهزاميّةَ التي سادت أوساطَ المجتمعِ, ولنتأكّد أنَّ الرفيق عكيد ومن معه كانوا فدائيين على طريقِ الحريّة والحقِّ المشروع, وأنّ الشهادة كانت ثمنَ إيقاظِ الضمائرِ وشحذِ النفوسِ وصناعةً للأملِ, وبالتالي فإنَّ حركةَ المقاومةِ ماضية في سبيلِ أهدافها لا تألو على شيءٍ, وتستمدُّ من قادتها العزمَ والإصرار والثبات, فالردُّ على استشهادُ الرفيق حقّي قرار كان إعلان حزب العمال الكردستانيّ, وشهادةُ الرفيق «عكيد » معصوم قورقماز إعلان »ARGK« ومع استشهاد خبات ديرك مؤسّس وحداتِ حمايةِ الشعبِ أصبحت هذه الوحداتُ أكثرَ إصراراً فعقدت كونفراسها الأول 14/1/2013 لتكونَ أكثر تنظيماً وتقرَّ نظامَها الداخليّ وتُحدّد أبعادَ موقفِها السياسيّ.
ومع بداية الثمانينات كان التحوّلُ النوعيُّ إذ استطاعت الحركةُ توسيعَ نشاطِها مخترقةً حُجبَ الظلامِ لتتواصلَ مع الناسِ أكثر وتقتربَ من مختلفِ الشرائحِ وتمتدَ على كاملِ جغرافيا كردستان وتختزلَ المسافةَ مع الفئاتِ المتنوّرةِ والمعبأةِ وطنيّاً, وفي هذه المرحلةِ كانتِ السجونُ ساحاتٍ نضاليّةٍ قلَّ نظيرُها, فالدولةُ التركيّةُ لم تدّخر جهداً في ملاحقةِ واعتقالِ المناضلين, ولعل ما تلقّاه دوغان من التعذيبِ الجسديّ والنفسيّ يفوقُ إمكانيةَ التصوّرِ, فإذا كان كاوا الحدّاد قد أوقدَ شعلةَ النوروز الأولى, فإنَّ احتفاليّةَ دوغان بالنوروز بين جدرانِ السجنِ عام 1982 جعلته مستحقّاً بجدارةٍ اسمَ كاوا العصرِ, ليجسّدَ واقعاً ما كان يردّدُه بنفسه (المقاومةُ هي الحياةُ والاستسلامُ هو الموتُ), وعلى هذا النحو فإنَّ السجنَ والاعتقالَ أصبحا ميداناً آخرَ ليس للمقاومةِ وحسب بل لتحقيقِ النصرِ, هي مفارقةٌ أن ينتصرَ الشهيدُ بخلوده على قاتلِه والسجينُ المُعذّبُ يكون حرّاً أكثر من سجّانه, ذلك لأنَّ عدالةَ القضيةِ كفيلةٌ بقلبِ المعادلةِ, وتدع القاتلَ والسجّانِ يجترّان مرارةَ الخيبةِ والهزيمةِ, والحديث عن مقاومة السجون لا بد وأن يتوقف عند الشهيدة ساكينة جانشيز كنموذجِ قدوةٍ للمرأة الكرديّة المناضلةِ.
نقول هذا مع دخولِ السنةِ السابعةِ عشرةِ على اعتقالِ قائد الشعب الكرديّ عبد الله أوجلان في سجنِ الفاشيّةِ التركيّةِ في جزيرة إيمرالي التي حوّلها بصمودِه لميدانٍ آخر للمقاومةِ والثباتِ والصمودِ.
ما نشهده منذ خمس سنوات في روج آفا من حالة صمودٍ وبسالةٍ للتصدّي لمختلفِ تنظيماتِ المرتزقةِ وقوى الإرهابِ المدعومةِ إقليميّاً ودولياً هي صورٌ نادرةٌ للمقاومةِ الحقيقيّةِ المشروعةِ, إذ لطالما كانت المقاومةُ هي كلُّ عملٍ بمواجهة محاولات الاجتثاث والاستئصال والإبادة, التي ترتقي لتكون شكلاً من الجريمة المنظّمة بحقِّ الوجودِ الإنسانيّ والحياة, ولتبقى شعلة كاوا الرمز متوهّجة ينقلها الرفاقُ من يدٍ إلى يدٍ في كلِّ الساحاتِ في كوباني وقراها وعلى حدود عفرين وسري كانيه دون وهنٍ أو ضعفٍ أو يأسٍ, ولتتواصل ميادين النضال, رغم محاولاتِ فصلِ الجغرافيا, لتكونَ نصيبين وسور وجزرة في باكور كردستان صدىً مباشر لثورة روج آفا في مواجهة إرهاب الدولة المنظّم والسياسات القمعيّة والوحشيّة لحكومة العدالة والتنمية, وما يجري في حيّ الشيخ مقصود قلعةِ الصمودِ بحلب هو مأثرةٌ نضاليّةٌ جديدةٌ تُضاف إلى سجلِ التاريخِ فالمعتدون المجرمون الموتورون لم يتوقفوا عن قصفِ وإمطارِ الحيّ بقذائفِ الحقدِ المتفجّرة وتجاوزوه لاستخدام الأسلحة الكيماويّة إمعاناً بالجريمة ولإيقاعِ أكبرِ عددٍ من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء, كلّ ذلك يحدث على مرأى العالم ومسمعه إلا أنّه يتعامى ويصمّ أذنيه عن المشاهدِ المروّعةِ القاسيةِ وصرخاتِ الثكالى وبكاءِ الأيتامِ, لأنّه مأخوذٌ بصفقاتِ التسويةِ وتقاسمِ النفوذِ وضمانِ المصالحِ في منطقتنا التي انقلبت نعمةُ الخيراتِ والثروات وبالاً عليها. نفاقُ العالمِ يجسّده ازدواجيّته في المعاييرِ, فمن جهةٍ ينادي بالحلّ السلميّ إلا أنّه يعطّل الجهود الرامية لذلك, وعندما ينادي بمحاربة الإرهاب يتساهلُ في عبورِ قوافلِ المرتزقةِ عبر الحدودِ, ويشكو أزمةَ المهاجرين ولا يتصدّى لجذرِ المشكلة وهي الحربُ, وإذا كان الإرهابيون مجرّد حاملو السلاح ومستخدموه ، فمن هو إذاً صانعه ومورده ومموله ؟ والحق أنَّ العالمَ لازال متثاقلاً عمداً عن التوافقِ على تعريفِ محدّدٍ للإرهاب ويخلطُه مع النضالِ المشروعِ الذي تمثّله حركاتُ المقاومةِ, هذه الحقيقة تحدّث عنها صراحةً روهان بيريرا رئيسُ لجنةِ الأممِ المتحدة الخاصّة بمكافحةِ الإرهابِ في تصريحٍ لوكالة انتر بريس سرفيس inter press service فقال: «السبيلُ الوحيدُ للتوصّل إلى توافقٍ في الآراء بشأنِ تعريفِ الإرهابِ في مشروعِ الاتفاقيّة الدوليّة يكون باعتمادِ تعريفٍ عمليّ أو قانونٍ جنائيّ للإرهابِ بدلاً من تعريفٍ شاملٍ له », و »إنَّ قضيةَ إرهابِ الدولةِ لا تزال تحكمُها المبادئُ العامّةُ للقانونِ الدوليّ, فليس من الممكنِ التعاملُ معها على صورةِ أداةٍ قانونيّةٍ نافذةٍ أو التعاملُ مع مسؤولياتٍ جنائيّةٍ فرديّةٍ على أساسِ نظامِ التسليمِ أو المحاكمةِ », أما أعمالُ حركاتِ التحرّرِ الوطنيّةِ والقوميّةِ التي تظهرُ في سياقِ الصراعاتِ المسلّحةِ فإنّها وفقاً لبيريرا «ستظلُّ خاضعةً للقانونِ الدوليّ الإنسانيّ وإنّ وضعَ تعريفٍ موضوعيّ للإرهابِ وتطبيقُهُ قد يكونُ مسألةً جانبيّةً, فالإرهابُ أصبحَ لقباً سياسيّاً لتصنيفِ الأعداءِ أكثرَ منه مصطلحاً تقنيّاً لتعريفِ أعمالٍ إجراميّةٍ تنتهكُ قوانينَ الحربِ ويمكنُ بموجبه محاسبةُ مرتكبيها, ووصلتِ الأمورُ لحدِّ توصيفِ أنشطةٍ مسلّحةٍ تستهدفُ أفراداً من الاحتلالِ من قبيلِ المقاومةِ على أنّها إرهابيّةٌ, فيما تُصنّف النشاطاتُ المسلّحةُ التي تستهدف المدنيين عمداً بأنّها أعمالٌ مشروعةٌ للدفاعِ عن النفسِ أو الأمنِ القوميّ .»
المقاومةُ حالةٌ وطنيّةٌ أخلاقيّةٌ تستمدُّ شرعيّتها من شعبها وحقوقه المشروعةِ, وليست رهناً بقرارٍ دوليّ ولا بمواقفِ التعاطفِ الطارئةِ, إذ لطالما تتبدّل المواقفُ وينسخُ بعضُها بعضاً وأصدقاء الأمسِ قد ينقلبون أعداء اليومِ. ولذلك, فمع كلِّ موقعةٍ بطوليّةٍ يسطّرها اليومَ أبناءُ شعبنا شباباً وشاباتٍ في وحداتِ حمايةِ الشعبِ والمرأةِ وكذلك ضمنَ قواتِ سوريا الديمقراطيّة تزدادُ ثقةُ شعبنا بالنصرِ وتطهيرِ الأرضِ من رجسِ المرتزقةِ التي عاثت فيها فساداً وأحرقتِ الأخضر واليابس, وتحريرِ الإنسانِ ورفعِ الظلمِ والمعاناةِ عن كاهله, والوفاءُ للدماءِ الطاهرةِ التي بذلها أبطالُ المقاومةِ وعرفاناً بمآثرهم يتطلّبُ تضافرَ كلّ الجهودِ ورصِّ الصفوفِ لتشكّل كلّ القوى المجتمعيّة الحاضنةَ الطبيعيّةِ لثقافةِ المقاومةِ ولتكونَ في الخطوطِ الخلفيّةِ الرديفَ الحقيقيّ لأبطالنا على الجبهات تمدُّهم بأسبابِ القوةِ والمنعةِ, وتحافظ على الانجازاتِ التي تحقّقت وتترجمها في واقعِ الحياةِ اليوميّةِ استلهاماً من عطائهم ونضالهم, على أنّ ذلك هو الحدّ الأدنى لردِّ الدَّينِ والإقرار بالفضل الذي طوّقوا به أعناقنا, وإنَّ أمّة ما برحت تنجبُ الأبطالَ وتعيشَ قيمَ الشهادةِ وتحييها في تفاصيلِ الحياةِ اليوميّةِ جديرةٌ بالحياة حقاً.