مهام إعادةِ إنشاءِ العصرانيةِ الديمقراطية
مهام إعادةِ إنشاءِ العصرانيةِ الديمقراطية
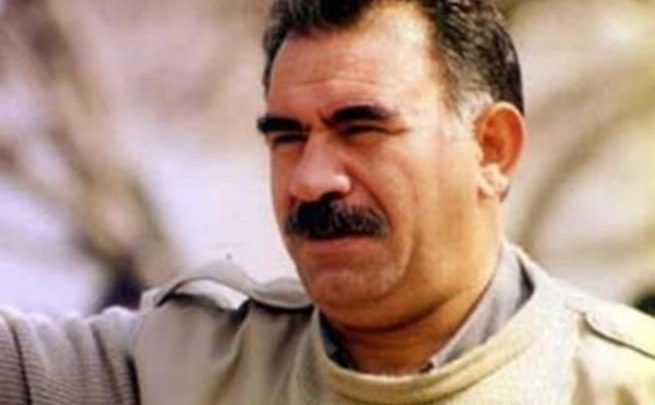
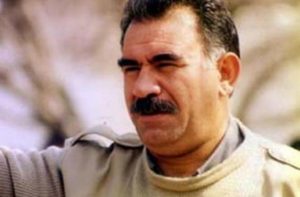 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
عليَّ التنويه سلفاً أني لن أُحَدِّدَ المهام الفكريةَ على أنها تَكوينٌ للوعي بقوالبَ جاهزةٍ مُسبقاً، وبالتالي نَقلٌ إلى المُكَوِّنات. أولُ عملٍ يجبُ القيام به هو تقييمُ ظاهرةِ الفكرِ بذاتها.
لطَالما يقُالُ إنّ «عصرَ التنوير » )أوروبا القرنِ الثامنِ عشر( هو الذي عَينََّ الحداثة. لكنّ الإبادات الجسديةَ والثقافيةَ التي لا حصرَ لها، والمُطَبَّقةَ بشكلٍ ممنهجٍ على يَدِ الدولةِ القومية، وعلى رأسها إبادةُ اليهودِ عرقياً؛ قد أَلحَقَت الضربةَ المُميتةَ بمزاعمِ الحداثةِ في التنوير. إنها اللحظةُ التي قالَ فيها المُفَكِّرُ أدورنو أنه باتَ على جميعِ الأُلوهياتِ أنْ تَلتَزِمَ الصمت. وهي في الوقتِ نفسِه المَحَطَّةُ الأخيرةُ التي بَلَغَتها المدنيات. إنها لحظةٌ هامة، حيث أنه من المحالِ خطو حتى خطوةٍ واحدةٍ إلى الأمام، دون القيامِ بتحليلها. إننا نتحدثُ عن لحظةِ الإفلاسِ التاريخيِّ والرياءِ والإبادة. ولا يمُكِن للنزعةِ الفكريةِ أنْ تجَُرِّدَ نفسَها من هذه اللحظة، بوصفِها ممارسةَ التنويرِ والتوعيةِ وامتلاكِ العلم. بل ينبغي محاكَمَتها باعتبارِها أحدَ المُتَّهَمين الأوائل. بينما تَحميلُ الجُرمِ على عدةٍ من أمثالِ هتلر ليس سوى دعاية الليبراليةِ الأفظع والأشنع. إذ لا يمُكِن إيضاح الحقيقةِ ما لمَ يسَُلطَّْ الضوءُ على النظامِ الذي غَذّى أمثالَ هتلر من المَهدِ إلى اللحَّد. وفي هذه الحال، تكَُون ثمة خيانةٌ للحقيقةِ بأحسنِ الأحوال. ما دامَت وظيفةُ النزعةِ الفكريةِ الأوليةُ المتمثلةُ في «تَقَصِّي الحقيقة » متعرّضةً للخيانة، وما دامت هذه الخيانةُ تُرتَكَبُ على يَدِ المُستَثمِرين والحَمَّالين الفكريين بِرَواجٍ شائع؛ فهذا ما مفادُه أنه ثمة أمورٌ ينبغي إعادةَ النظرِ فيها من الجذور.
ومن دونِ تحليلِ المواضيعِ التي يجب إعادةَ النظرِ فيها جذرياً في الميدانِ الفكري، فالوضعُ الذي سيتمُّ الولوجُ فيه لن يتمخضَ عن نتيجةٍ أبعدَ من التحوُّلِ إلى مستثمِرين وحَمَّالين فكريين جُدُد.
إنْ كان من المُحالِ تأمينُ سيرورةِ الأزمةِ الممنهجةِ العالميةِ إلا بِحُكمِ الأزمةِ الطارئ، فإما أنّ عدمَ الحديثِ عن الأزمةِ الفكريةِ يتأتى في هذه الحالة من العمى، أو أنه ممكنٌ بالتحوُّلِ إلى مستَثمِرٍ وحَمَّالٍ فكريٍّ للنظام، عَقيمٍ ولا فَلاحَ له. إذ أنّ مُفَكِّرا اعتياديا ذا كرامةٍ وعِزّة لن يَستَعصيَ عليه فهمُ كونِ الأزمةِ متعلقةً أصلاً بالانسدادِ الموجودِ في الميدانِ الذهني. علماً بأنّ العلاقةَ بين بُنى النظامِ وذهنياته أَشبَهُ بالعلاقةِ بين الجسدِ والروح. فأزمةُ الجسدِ بُنيوياً لا تقتضي أزمةَ الذهنيةِ روحيا فحسب، بل وتجَعَلهُا رائدةً لها. أي أنّ الأولويةَ تكَمُنُ في الأزمةِ الروحية، لا الجسدية. فكما أنّ موتَ الدماغِ برهانٌ قاطعٌ على موتِ الجسد، فالأزمةُ الذهنيةُ أيضاً لا يمُكِن أنْ تكَُونَ إلا دليلاً جازما على الأزمةِ البنيوية. واضحٌ بجلاءٍ لا يَقبَلُ الجدل أنّ ما يُعاشُ هو أزمةٌ فكريةٌ عميقة.
والردُّ اللازمُ يتطلبُ العُمقَ بحيث يستحيلُ تلافيها بالتحديثاتِ في بعضِ الميادين فقط. بل يقتضي الاهتمامَ والعنايةَ بتَحَوُّلِ النظامِ القائم. أي أنّ حلَّ أزمةِ النظامِ الفكريةِ غيرُ ممكنٍ إلا بتِخََطّيه هو، أي ب «الثورةِ الفكرية ». وقبلَ التطرُّقِ إلى الثورةِ الفكريةِ الراهنة سيَكُون التنويهُ إلى بعضِ الأمثلةِ التاريخيةِ مفيداً لأبعدِ الحدود.
حسب ما يُمكنُ تفسيره، فأولُ ثورةٍ فكريةٍ عظمى في التاريخِ حَصَلَت في ميزوبوتاميا في الحقبةِ ما بين 6000 – 4000 ق.م. إنها الحقبةُ التي شُوهِدَت فيها قدرةُ المجتمعِ والقوى الطبيعيةِ بشكلٍ شاملٍ لأولِ مرة، واستُخرِجَت منها النتائجُ العمليةُ ذات الأبعادِ العملاقة. إنها الحقبةُ التي قالَ فيها جوردون تشايلد أنه لا يُمكِنُ مقارنتَها إلا بأوروبا ما بعدَ القرنِ السادسِ عشر. والقسمُ الأكبرُ من المَكاسبِ الاجتماعيةِ في يومنا، ذهنيةً كانت أم أداتية، يعَودُ إلى تلك الحقبة. الثورةُ الثانيةُ الكبرى هي مرحلةُ تأسيسِ المدنيتَين السومرية والمصرية. وهي ستُبدي مهارتَها خلالَ الحقبةِ الأولى في تحويلِ مُكتَسَباتِ ثورتِها إلى نظامِ المدنيةِ ذهنياً وأداتياً على السواء. فأغلبُ الاختراعاتِ والاكتشافاتِ في العديدِ من الميادينِ هي ثمرةُ التطََوُّراتِ الفكريةِ الثوريةِ المُنجَزَةِ في تلك الحقبة، وفي مقدمتها الكتابة، الرياضيات، الآداب، الطب، علم الفَلكَ، اللاهوت والبيولوجيا. وسيمَُرُّ التاريخُ بتعََلمُِّ وتكَرارِ هذه التطوراتِ إلى حينِ قيامِ الثورةِ الإغريقيةِ – الإيونيةِ فيما بعد. الثورةُ الفكريةُ الإغريقيةُ – الإيونيةُ تُشَكِّلُ الخطوةَ الثالثةَ العظمى. فعهدُ 600 ق.م عهدٌ آخَر شَهِدَ غِنىً وفيراً على صعيدِ الذهنيةِ الفلسفية والعلميةِ في آنٍ معاً. فالعبورُ من الأديانِ المُقتَرِنةِ بالميثولوجيا إلى الثورةِ الفلسفيةِ ثورةٌ فكريةٌ كبرى دون شك. فضلاً عن حصولِ تطوراتٍ ثوريةٍ في ميادينِ الكتابةِ والآدابِ والفيزياءِ والبيولوجيا والمنطق والرياضياتِ والتاريخِ والفنِّ والسياسةِ أيضاً. وقد تمَّ عيشُ التاريخِ إلى حينِ القرنِ السادسِ عشر بنقلِ ثمارِ هذه الثوراتِ وتكرارِها لا غير. لا ريب أنه قد حصلت العديدُ من التطوراتِ الفكريةِ في الأماكن والأزمنةِ الأخرى، لكنها لا تعَُدُّ ثوراتٍ كبرى. هذا وبالمستطاعِ نعت الانطلاقاتِ الدينيةِ التوحيديةِ بالثوراتِ الذهنيةِ الهامة. بالإضافةِ إلى أنّ الثورةَ الزرادشتيةَ الأخلاقيةَ ثورةٌ فكريةٌ عُظمى. وكونفوشيوس في الصين، وبوذا في الهند قِيمَتان فكريتانِ هامّتان. كما أنّ الإشعاعاتِ الفكريةَ الوامِضةَ في الإسلامِ بين القرنَين الثامنِ والثاني عشر هامة. لكنّ عدمَ قدرتهِا على التحََوُّلِ إلى ثورة خُسرانٌ فادح.
الثورةُ الأوروبيةُ الفكريةُ جذريةٌ وشاملةٌ دون ريب. لكن، لا جدالَ في حقيقةِ كونِها انتَهَلَت منابِعَها من الثوراتِ والومضات المُشِعَّةِ التي ذَكَرناها آنفا.ً عليَّ التبيانَ فورا أنّ كلَّ هذه الثوراتِ الفكريةِ لا علاقةَ لها البتةَ باحتكاراتِ الاستغلالِ والسلطة. بل على العكس، فما جرى هو أنّ عدمَ تطََوُّرِها بجَِدارة، وتحريفَها، وضمورَها يُعزى إلى تلك الاحتكاراتِ وإخضاعِها لسيطرتها، مُصَيرَِّةً إياها رأسَ مالٍ لها. وهذا الواقعُ في الثورةِ الأوروبيةِ الفكريةِ الكبرى أكثرُ وضوحاً ولفتاً للأنظار. فالأنظمةُ المُطلَقة وأنظمةُ الدولةِ القوميةِ باعتبارِها احتكاراتٍ رأسماليةً واحتكاراتِ دولة، قد بَذَلَت جهوداً حثيثةً في سبيلِ عرقلةِ الثورةِ الفكريةِ وتحريفِها وإلحاقِها بذاتها، واعتبَرََت ذلك من أولوياتِ أعمالهِا. وقد تمَّ خوضُ صراعاتٍ كبرى في هذا المضمار.
فرجالُ العلمِ وأشخاصٌ من قَبيلِ برونو، أراسموس، غاليليو، توماس مور وأمثالهِم، ولكَِي يصَُونوا كرامتهَم وعِزَّتهَم، وكي لا يخَسَروا استقلاليتهَم الفكرية؛ تصََدّوا للظُّلم المُجحِف الذي طَبَّقَته السلطاتُ عليهم، بدءاً من محاكمِ التفتيشِ إلى محاكمِ الثورةِ الفرنسية، بل ووضعوا الحَرقَ نُصبَ أعينِهم في سبيلِ ذلك.
وَجَدَ رأسُ المالِ الاحتكاريُّ وهيمنةُ الدولةِ القوميةِ انعكاساً قوياً في الميادين والمُكَوِّناتِ الفكرية، مثلما حَصَلَ في جميعِ ميادينِ المجتمعِ ومُكَوِّناته خلالَ القرنَين التاسعِ عشر والعشرين. حيث أُرفِقَ العلمُ والفلسفةُ والفنّ، بل وحتى الدينُ بالسلطات، وخاصةً بِبُنى الدولةِ القوميةِ بنسبةٍ مرتفعة. وأَلحَقَت الاحتكاريةُ الكامنةُ في كِلا الميدانَين ضربةً كبرى بالاستقلاليةِ الفكرية. هكذا صارَ الفكرُ الخاضعُ للتَّبَعِيّةِ فكراً للمستثمِر، أو غالباً ما تَحَوَّلَ إلى حَمَّالِ المعلوماتِ في أنظمةِ الجامعاتِ والمدارسِ الأخرى. وباتتَ المعابدُ الجديدةُ في كلِّ دولةٍ قوميةٍ متجسدةً في بنُى المدارس، وعلى رأسها الجامعات. في هذه الأماكنِ يغُسَلُ دماغُ وروحُ الجيلِ الجديد، صائرا بذلك مُواطِنا عبداً ساجِداً لإلهِ الدولةِ القوميةِ بما لا مثيلَ له في أيةِ مرحلةٍ أخرى. ولا يَنفَكُّ المُدَرِّسون على جميعِ المستويات بمثابةِ طبقةِ الرهبانِ الجديدة. لا شك أنه هناك قلةٌ نادرة من المتنورين والمفكرين الذين يَصونون خاصيتَهم الفكرية، لكنهم استثناءٌ لدرجةٍ لا تخُِلُّ بالقاعدةِ العامة.
الأهمُّ من ذلك معنيٌّ بالمستجداتِ الحاصلةِ في مضمونِ الثورةِ الأوروبيةِ الفكرية. يجب أولاً الإشارةَ إلى أنهم تمََثلَّوا جيداً أديانَ وعلومَ وفلسفاتِ وفنونَ العصورِ السابقةِ لهم. جليٌّ أنهم اعتمَدوا في مساهماتهِم إلى هذا التمََّثلُِّ والاحتواء. كما ينبغي القَبول بأنّ المُفَكِّرين الأوروبيين قَطَعوا مسافاتٍ شاسعةً في التقرُّبِ من الحقيقة. ونجاحُهم أكيدٌ على صعيدِ المنهاجِ والتطبيق. فنجاحُهم بشأن الطبيعةِ الأولى على وجهِ الخصوص )بشأنِ ميادينِ الفيزياءِ والكيمياءِ والبيولوجيا وعلمِ الفلك( سائرٌ في هذا المنحى. إلا أنه من غيرِ الممكنِ تحديد الأمرِ عينِه بشأنِ تعاطيهم العلميِّ والفلسفيِّ والفنيِّ والأخلاقيِّ فيما يتعلقُ بالمجتمعِ كطبيعةٍ ثانية. لقد طَوَّروا الإيضاحاتِ )المانيفستوهات( والضوابطَ العلميةَ والمدارسَ الفلسفيةَ والاتجاهاتِ الفنيةَ العظيمةَ والثَّمينة. لكنهم عجزوا عن النجاحِ لدرجةِ صونِ الطابعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ للمجتمع. بل على النقيض، شارَكوا في ارتكابِ الجُرمِ كُلمَّا ازدادَت تبَعَِيتَّهُم لاحتكاراتِ رأسِ المالِ والسلطة، بحيث أنّ استهدافَهم المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ لدرجةِ البلوغِ به إلى شفيرِ الهاويةِ والفناء، لا يمُكِنُ إيضاحَه بالنواقصِ والأخطاءِ فحسب. هكذا بدأت الأزمةُ الفكرية.
لا ريب أنّ المُفَكِّرين هم المسؤولون بالتأكيد عن جعلِ المجتمعِ والبيئةِ أيضا هدفا للإبادةِ والزوال. وبالأصل، فإلقاءُ المسؤوليةِ المُشتَرَكةِ عليهم بصددِ الأزمةِ العالميةِ، إنما يُعزىإلى كونِ الأزمةِ مشترََكة. الأمرُ الأهمُّ تماما،ً والذي ينبغ تنويرَه هنا، معنيٌّ بكيفيةِ تَطَوُّرِ الهزيمةِ والفسادِ والانحرافِ الفكريِّ استراتيجياً وتكتيكياً. مَن الذي يجب رؤيتَه مسؤولاً عن تَصاعُدِ التعقيدِ والهزيمةِ والخيانةِ الكبرى في ساحةِ العلومِ الاجتماعيةِ على وجهِ الخصوص )أُشَدِّدُ أولاً على قناعتي بأنّ العلومَ المعنيةَ بالطبيعةِ الأولى ذات ماهيةٍ اجتماعية، أو ينبغي أنْ تَكُونَ كذلك(؟ هل ما هو قائمٌ مَرَضٌ مرتبطٌ كلياً بالبراديغما العلمية؟ أَوَيجبُ البحث عن النصيبِ الأوفرِ في ذلك ضمن بعضِ القواعدِ والضوابط؟ هل المَرَضُ بنيويٌّ أم عَرَضِيّ؟ هل معالجتُه ممكنة؟ كيف ينبغي تطويرَ سُبُلِ وأساليبِ العلاج؟ ما الذي يمُكِنُ أنْ تكَونهَُ المؤشِّراتُ الأوليةُ للثورةِ أو البراديغما العلميةِ الجديدة؟ مِن أين علينا البدء استراتيجياً؟ لا يمكننا تحديدَ مهامِّنا البراديغمائيةِ والعلميةِ الجديديةِ، ولا النفاذَ من الأزمةِ الفكرية ما لَم نُجاوِبْ من الصميمِ على هذه التساؤلاتِ وما شابهها.
العلمُ الذي مركزُه المدنيةُ الأوروبيةُ أزمتُه بنيويةٌ معنيةٌ بالتطوراتِ الحاصلة في مراحل مطلعِ المدنية. ذلك أنّ تمََركُزَ العلمِ في المعبدِ يعني التحامَه مع السلطة. ثمة عددٌ جَمٌّ من الأمثلةِ التي تُثبِتُ أنّ العلمَ في المدنيتَين المصريةِ والسومريةِ جزءٌ لا يتجزأُ من السلطة. فالرَّهبَنَةُ التي لَمَّت شَملَ العلم، كانت أصلاً بمثابةِ الشريكِ الأهمِّ للسلطة. علماً أنّ بُنيةَ العلمِ في العهدِ النيوليتيِّ كانت مختلفة. فمعلوماتُ المرأة حول النبات ربما كانت أرضيةَ البيولوجيا والطب. فضلاً عن أنّ رصدَها للفصول والقمرِ كان يُخرِجُ الحسابَ للميدان. بالإمكان التفسير بكلِّ يُسرٍ أنّ ممارسةَ الحياةِ العمليةِ الممتدةِ على مدى آلافِ السنينِ في مجتمعاتِ الزراعةِ – القرية، أَبرَزَت خزينةً عظمى من المعلوماتِ والمعرفة. لكنّ هذه المعارفَ جُمِعَت في عهدِ المدنية، متحولةً إلى جزءٍ من السلطة. وقد شوهِدَ تَحَوُّلٌ نوعيٌّ هنا بالمعنى السلبي.
كانت المعرفةُ والعلمُ ضمن المجتمعاتِ المناهِضةِ في عهدِ ما قبل المدنيةِ جزءاً من المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. حيث لَم يَكُن ممكناً استخدامُ العلمِ بشكلٍ آخَر، ما دامَت المصالحُ الحياتيةُ للمجتمعِ لا تقتضي ذلك. ربما كانَ الهدفُ الوحيدُ للمعرفةِ والعلمِ تأمينَ سيرورةِ وجودِ المجتمعِ، وصونَها، وتغذيتهَا. ولمَ يكَُن ممكنا تصََوُّرُ هدفٍ آخرَ له. إلا أنّ المدنيةَ غَيَّرَت هذا الوضعَ جذرياً، حيث فَصَلَته عن المجتمعِ بتأسيسِ احتكارِها للمعرفةِ والعلم. وبينما بات المجتمعُ مفتقراً للمعرفةِ والعلم، فقد تَعَزَّزت السلطةُ والدولةُ بهما قدرَ المستطاع. إذ وَطَّدَتا احتكاراتِهما بإتْباعِ مُنتِجي وحامِلي المعرفةِ بالسلالاتِ الحاكمةِ والقصور. هكذا كان مفادُ ذلك الانقطاعِ الجذريِّ للعلمِ عن المجتمع، وبالأخصِّ عن المرأة، وانفصالِ أواصرِه عن الحياةِ والبيئة. وفي الوقتِ نفسِه كان الانقطاعُ الجذريُّ لأواصرِ الذكاءِ التحليليِّ مع الذكاءِ العاطفيِّ يَكبُر، والمسافةُ الشاسعةُ فيما بينهما تتعاظَمُ بالتزامُن.
كان معنى العلمِ أُلوهيّاً في الطبيعةِ الاجتماعية. حيث كان المجتمعُ يُؤَلِّهُ مستوى معرفتِه ووعيِه بشأنِ طبيعتِه، باعتبارِه ذلك تعبيرا عن هويته. وكان يسُاوي بين مستواه ذاك وبين الألوهية. وقد غَيرََّت المدنيةُ هذا الوضعَ أيضا.ً فلدى عبورِ العلمِ إلى السلالةِ وشُرَكائِها، تَبَدَّلَت مكانةُ الألوهيةِ. فبينما فُصِّلَت العبوديةُ واللاألوهيةُ لِتَكُونا من نصيبِ المجتمع، أصبَحَت الميثولوجيا والدينُ يَنُصُّان على أنّ السلالةَ ومحيطَها المُجاوِر مِن نسََبِ الإله. أي أنّ المُلوكَ – الآلهة وأنسابَ الإلهِ كانوا ثمرةَ هكذا مرحلة. استمَرَّ انقطاعُ أواصرِ مُنتِجي وحامِلي العلمِ والمعرفةِ مع المجتمعِ بشتى الأشكالِ على مرِّ عصورِ المدنيةِ بأكملها. مع أنه وُجِدَ متصدّون لذلك، إلا أنه تمت تصفيتُهم والقضاءُ عليهم بسهولة. وباتَت المعرفةُ والعلمُ يُشَكِّلان ما هو أَشبَهُ بالكاست )الطبقة المنغلقة على ذاتها(. ولدى الوصولِ إلى المدنيةِ الأوروبية، عاش مُنتِجو المعرفةِ والعلمِ عهداً من الاستقلالِ النسبيِّ بسببِ تنازُعِ الكنيسةِ والمَلَكيةِ خصوصاً، وبسببِ جوِّ شبهِ الاستقلاليةِ النسبيّةِ للأديِرة. فالحروبُ الكثيفةُ على السلطة كانت تَمُدُّهُم بفُرَصِ العثورِ بسهولةٍ أكبر على مَن يحميهم، دون أن يلُحِقَ ذلك الضررَ بأبحاثهِم. كانت مراحلُ النهضةِ والإصلاحِ والتنويرِ على علاقةٍ قريبةٍ بأجواءِ شبهِ الاستقلالِ المتمخضةِ عن حروبِ السلطةِ تلك. كما أنّ عدمَ وجودِ حُكمٍ مُطلَقٍ من النمطِ الصينيِّ والعثمانيِّ كان يُوَفِّرُ الفرصةَ لشبهِ الاستقلالية. والنتيجةُ كانت ثورةً فلسفيةً وعلمية.
إلا أنّ تصاعُدَ هيمنةِ الرأسماليةِ من جانب، وتكََوُّنَ الدولةِ القوميةِ من الجانبِ الآخر، جَلَب معه تأسيسَ احتكارِ رأسِ المالِ والسلطةِ على العلمِ في غضونِ القرنَين التاسعِ عشر والعشرين. هكذا بات العلمُ جزءا لا يتجزأ من رأسِ المالِ والسلطة. هذا الوضعُ المتنامي أصلاً طيلةَ تاريخِ المدنيةِ على حسابِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ، بلَغََ ذروتهَ مع حداثةِ أوروبا.
هذا ما معناهُ أنّ البراديغماتِ العلميةَ الأوروبيةَ المركز كانت بُتِرَت من المجتمعِ قبلَ زمنٍ سحيق. والمُهتَمّون بالمعرفةِ والعلمِ غالباً ما كانوا يَتَخَبَّطون ضمن توجيهاتِ رأسِ المالِ والسلطة. كان قد حُطَّ من شأنِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ منذ وقتٍ بعيد. وتَسارَعَ هذا السياقُ أكثر مع هزيمةِ الكنيسة.
والعلمُ الذي لَم يَعُدْ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ هَمَّه الشاغِل، لمَ يبَْقَ أمامَه هَمٌّ سوى الالتفافَ حولَ أهدافِ رأسِ المالِ والدولة. هكذا، وبينما باتَ العلمُ ينُتجُِ السلطةَ ورأسَ المال، فإنّ رأسَ المالِ والسلطةَ كانا يَجعلان العلمَ مُلكاً لهما بالتمام. كما أنّ قطعَ روابطِ العلمِ مع الأخلاقِ والسياسةِ لآخرِ الحدودِ كان يفَتحَُ البابَ على مِصراعَيه أمام الحروبِ والاشتباكاتِ والنزاعاتِ وشتى أنواعِ الاستغلال. بيَْدَ أنّ تاريخَ المدنيةِ الأوروبيةِ أضحى في الوقتِ نفسِه تاريخاً شاهِداً على أعتى وأكثفِ الحروب. وصارَ الدورُ المُناطُ بالعلمِ هو التركيزُ على ابتكارِ أدواتِ ووسائلِ الحروبِ الرائعةِ التي تجَلبُ النصرَ المؤزر.
هكذا حصلَ تصاعُدٌ إلى حدِّ ابتكارِ الأسلحةِ النوويةِ في نهايةِ المطاف. في حين كان يستحيلُ اختراع حتى مُسَدَّسٍ ألعوبة ضمن مجتمعٍ تَسُودُه قواعدُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ، فما بالكَُ بالسلاحِ النووي. وحتى لو كان اخترُِعَ السلاحُ النووي، لَما كان سيُستَخدَم ضدّ المجتمعِ بأقلِّ تقدير.
الترََّدّي الأخلاقيُّ مِن أهمِّ مؤثرِّاتِ بدايةِ الحروب. أما انقطاعُ العلاقةِ بين العلمِ والأخلاق، فهو أساسُ ابتكارِ شتى أنواعِ الأدواتِ التدميرية. إذ كان من المحالِ تصََوُّر عدم انعكاسِ علاقةِ العلمِ مع السلطةِ والمجتمعِ على البراديغما والأسلوبِ الأولييَّن. كما أنّ إخراجَ المجتمعِ من الأجندة كان يعني تَشييئَه أيضاً، تماماً كتشييءِ المرأةِ والعبيدِ سابقاً. ومن ثَمَّ انتقَلَ الفصلُ بين الذاتِ الفاعلةِ والموضوعِ الشيءِ إلى كافةِ العلوم، بعدما كان ابتدأ مع بيكون وديكارت. وباتَ التحََّوُّلُ الموضوعانيُّ الشيئانيُّ موضوعَ ثَناءٍ في العلم، على الرغمِ من أنّ البابَ قد فُتِحَ أمام الفاجعةِ الأساسيةِ مع حسمِ الفصلِ بين الذاتانيةِ المثاليةِ والموضوعانيةِ الشيئانية، لِتَتَجَذَّرَ لاحقاً مع الفصل بين أنا – الآخَر، صائرةً فيما بعد أطرافاً جَدَليةً تَفني بعضها بعضاً. هذه الثنائياتُ انعكاسٌ قاطعٌ للانفصالِ والتناقضِ بين المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ وبينَ رأسِ المالِ والسلطة.
فاختزالُ الطبيعةِ ومن ثمَّ المرأةِ والعبدِ وأخيراً المجتمعِ برمته إلى منزلةِ الموضوعِ الشيءِ، بَرَزَ أمامنا في هيئةِ «قاعدة الشيئانية » الشهيرة جداً، والتي لا تَزالُ مستَخدَمةً في العلم. أي أنّ علاقةَ الاله –العبد السابقة أضحت علاقة الذات الموضوع. كما تَنَحّى مفهومُ الطبيعةِ الحيةِ الأقدم عمراً عن مكانتِه لِمفهومِ الطبيعةِ الشيءِ الميتة والإنسانِ الذاتِ الإلهية المتحكمةِ بها.
كان تأثيرُ هذه المواقفِ البراديغمائيةِ مُدَمِّراً على العلمِ، وبالأخصِّ على العلومِ الاجتماعية. وعلى سبيلِ المثال، علمُ الفيزياءِ، الذي يَعمَلُ أساساً بالطبيعةِ الفيزيائيةِ التي هي شيئيةٌ كلياً، يُؤمِنُ أنه حرٌّ في التحكمِ بالطبيعةِ واختبارِها بلا حدود. ويَعتَبِرُ نفسَه حراً في تفعيلِ التجاربِ النوويةِ وصولاً حتى شتى أنواعِ الديناميكياتِ الذاتية. ولا يسُاوِرُه أيُّ قَلقٍَ أخلاقيٍّ لدى قيامِه بذلك. فعندما أَسفَرَ مفهومُ الطبيعةِ الشيءِ عن التصرفِ والاستغلالِ اللامحدودَين عن طريقِ المادة، فإنّ النتيجةَ تصَِلُ حتى مستوى القنبلةِ الذَّرِّيَّة. ولدى تَحَوُّلِ العلمِ الإلهيِّ إلى علمٍ أداتيٍّ، لا تبَقى له أيةُ أواصر مع المجتمع، بل يكَتسَِبُ أداتيةً مرتبطةً بقانونِ الربحِ الأعظميِّ بين يَدَي السلطةِ ورأسِ المال. الفيزياءُ ظاهرياً علمٌ حياديٌّ تماماً، ومعنيٌّ بالطبيعةِ الشيء.
ولكن، واضحٌ جلياً أنه مضموناً أحدُ مصادرِ القوةِ الأساسيةِ للسلطةِ ورأسِ المال. حيث ما كانَ لِعلمِ الفيزياءِ أنْ يَصونَ حالتَه القائمةَ في حالِ العكس. وتَحَوُّلُه إلى قوةٍ مضادةٍ للمجتمع، مؤشرٌ صارخٌ على أنه ليس علماً موضوعياً شيئانياً حيادياً. كما أنَّ علاقاتِ القوةِ المسماةَ بقوانينِ الفيزياء لا تعني في نهايةِ المطافِ سوى انعكاسا لقوةِ الإنسان. أما الإنسان، فنحن نعَلمَُ أنه مخلوقٌ اجتماعيٌّ بالمعنى المطلق.
بمقدورنا كشفَ النقابِ على نحوٍ أفضل عن الوجهِ الباطنيِّ للعلاقةِ بين المدنية – السلطة – العلم، لدى تحليلِ الفلسفةِ الوضعيةِ التي تتركُ بصماتِها على كلِّ البنيةِ العلميةِ للحداثة. إننا على علمٍ بِكَونِ الفلسفةِ الوضعيةِ تنطلقُ من الظواهرِ الموضوعيةِ Nesnel الحاسمة، ولا تَعتَرِفُ بأيِّ تَعاطٍ علميٍّ آخر عدا ذلك. لكن، ولدى النظرِ عن كثب، فسيتم الإدراكُ أنّ هذا العلمَ أكثرُ وثنيةً وميتافيزيقيةً من كافةِ عُبَّادِ الأوثانِ والقوى الميتافيزيقيةِ القديمة، بوصفه علاقةَ المواضيعِ الأشياء. وإذ ما استَذكَرنا الدياليكتيكَ التاريخيَّ باقتضاب في هذا السياق، فسوف نتَنَوََّرُ أكثر. فكما أنّ الأديانَ التوحيديةَ والتجريديةَ شَكَّلَت نفسها بالظهورِ على أساسِ انتقادِ الوثنية )ضربٌ من دينِ تأليهِ الظواهر(، فالوضعيةُ أيضاً بَرَزَت كوثنيةٍ جديدةٍ باعتبارِها ضربا من الإقدامِ والجرأةِ المضادة. فانتقادُها للدينِ والميتافيزيقيا تَشَكَّلَ كوثنيةٍ جديدةٍ )نزعةُ القولِ بالحقيقةِ اعتماداً على الظواهرِ إنما هي وثنيةٌ مُحدَثةٌ بكلِّ تأكيد( وكميتافيزيقيا مُحدَثة )جديدة(. وكَونُ فريدريك نيتشه أولَ الفلاسفةِ الذين شَخَّصوا هذه الحقيقةَ أمرٌ هامٌّ لآخرِ درجة، وتُعَدُّ تقييماتُه بمثابةِ مساهمةٍ قَيِّمةٍ في بحوثِ الحقيقة. من الأهميةِ القصوى التبيانَ أنّ المصطلحَ المسمى بالظاهرةِ الموضوعية الشيئية مصطلحٌ بعيدٌ عن الحقيقة. فالظواهرُ بِحَدِّ ذاتِها، إما أنها لا تُقَدِّمُ أيةَ معلومةٍ قَيِّمةٍ بشأنِ الحقيقة، أو أنها تُسفِرُ عن نتائج جدِّ خاطئةٍ بالتناسُبِ طرداً مع ما قَدَّمَته منها.
كنا قُلنا أنهّ إذا لمَ تجَِدْ الظواهرُ معناها ضمن إطارِ الروابطِ المُعَقدَّة، فإما أنها لا تقَُدِّمُ أيةَ معلومة، أو ربما تفَتحَُ المجالَ أمامَ النتائجِ الأكثرَ خطأً. لِنَدَعْ الظواهرَ الفيزيائيةَ والكيميائيةَ والبيولوجيةَ جانباً. ولِنَتَمَعَّنْ عن كثب في النتائجِ التي تُسفِرُ عنها، بالتركيزِ فقط على مثالِ ظاهرةٍ اجتماعيةٍ ما. فحسبَ الوضعية، الدولةُ القوميةُ أيضاً ظاهرة. وجميعُ العناصرِ المُؤَلفَِّةِ لها ظواهر. أي أنّ آلافَ المؤسساتِ وملايين البشرِ ظواهر. وبإضافةِ العلاقاتِ فيما بينهم، نَكُونُ بذلك قد أَتمَمنا اللوحة. أي أننا نكَُونُ قد كَوَّناَّ المصطلحَ العلميَّ آنذاك، حسبَ الوضعية. وأننا بِتْنا وجهاً لوجهٍ أمامَ حقيقةٍ مُطلقة: حقيقةُ الدولةِ القومية. لا تَنظُرُ الوضعيةُ إلى هذا التعريفِ كمُجَرَّدِ تفسير، بل تَعتَبِرُه ظاهرةَ الحقيقةِ المطلقة. كما وتَنظُرُ إلى جميعِ ظواهرِ علومِ المجتمعِ الأخرى ضمن إطارِ هذا المفهوم. أي أنّ جميعَها ظواهر، تماماً مثل ظاهرةُ الفيزياءِ والكيمياءِ والبيولوجيا. هكذا هو تعريفُ الحقيقة. لقد بَدَأنا ننتَبِه إلى أنّ هذا التناوُلَ الباديَ ظاهراً وكأنه بريءٌ لا يشتَمِلُ على أيةِ مخاطر، إنما هو ليس كذلك بتاتاً. يَظهَرُ ذلك بكلِّ ذهولِه وهَولِه في حركاتِ التطهيرِ الأثنيِّ والإبادةِ العرقيةِ على وجهِ الخصوص. وبدءا من هتلر إلى أكثر رؤساءِ الدولةِ القوميةِ اعتدالاً حسبما يُزعَم، فجميعُهم سوف يَقولون أنّ ما يَقومون به صحيحٌ لأبعدِ الحدودِ حسبَ العلم )حسبَ العلومِ الوضعية(، وأنهم يُنَقُّون حقائقَ الأمةِ لديهم من الشوائب، وأنّ تشكيلَ أمةٍ نَمَطيةٍ متجانسةٍ ليس مجردَ حقٍّ فقط، بل وتَطَوُّرٌ مناسِبٌ لقانونِ الكونِ الطبيعيِّ أيضاً. إنهم يتَفََوَّهون بالصحِّ حسبَ العلمِ الذي تلَقَوَّه. وهذه القوةُ تزَُوِّدُهم بها الفلسفةُ والعلومُ الوضعية. علماً أنه، وبِحُكمِ هذا المفهومِ الوضعيّ، تمَّ خَوضُ حروبٍ لامحدودةٍ في سبيلِ الوطنِ والأمةِ والدولةِ والأثنيةِ والأيديولوجيا والنظامِ في عهدِ الحداثةِ بأكمله.
ذلك أنّ كلَّ هذه المصطلحاتِ كانت مقدسة، وكان ينبغي خوضَ الحربِ حتى النهاية في سبيلها. وحسبما هو معلوم، فالتاريخُ صارَ بحراً من الدمِ حصيلةَ هذا المفهوم. إنّ الوضعيةَ البريئةَ ظاهرياً كانت تَكشِفُ عن وجهِها الدمويِّ باطناً بهذا المنوال.
لِنَعملْ على شرحِ الأمرِ أكثر قليلاً. ثمة ما يُقارِبُ المائتَي دولةً قوميةً في عالمَنا الراهن. وإذ ما باتت جميعُ المؤسساتِ والعلاقاتِ وحشدِ المواطنين الذين بيَنَّاَّهم أعلاه وجها لوجهٍ أمام تلك الدولِ بأكملِها، فسيصبحُ لا مفرَّ عندئذٍ من ولادةِ نظامٍ أو وضعٍ من الشَّغَبِ والضوضاءِ المؤلَّفةِ من مائتَي إلهٍ على الأقل، ومن آلافِ المعابدِ وعددٍ لا محدودٍ من الطرائق. ذلك أنّ كلَّ الظواهرِ التي يُمَثِّلونها مقدسةٌ وجديرةٌ بالموتِ في سبيلِها.
لِنَنْتَبِهْ، لا ذِكرَ بتاتاً حتى على مستوى الاسم، للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ الذي يَعكِسُ الطبيعةَ الاجتماعيةَ الحقة. لكن، إنْ كان هناك بالفعلِ حقيقةٌ تستحقُّ الموتَ لأجلها في حالِ تَعَرُّضِها للهجومِ والاعتداء، فهي واقعُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ، لا غير. أما في الدولةِ القومية، فالكلُّ يحُارِبُ باسمِ الأوثانِ التي شَكَّلهَا كلُّ واحدٍ لذاتهِ أو التي يتم تشكيلهُا وبسَْطُها أمامَه. إننا في مواجهةِ عهدٍ من الحروبِ لأجلِ الأوثانِ المسعورةِ بما يَزيدُ ألفَ مرةٍ على الحروب في سبيلِ أوثانِ الماضي السحيق.
والمحصلةُ هي تنشيطُ قانونِ الربحِ الأعظميِّ لاحتكاراتِ رأسِ المالِ والدولةِ القومية، وتقديمُ حَيوَاتٍ لمَ ينَعَمْ بها حتى الفراعنةُ إلى حفنةٍ قليلةٍ سعيدة. وما يُسمى بالحياةِ العصريةِ ليس شيئاً سوى نتائجُ حقيقةِ الوضعيةِ تلك، أو بالأحرى، قَتلَها الحقائق.
لقد بَلَغنا اليومَ عصرَ المجتمعِ الافتراضي. وما مِن حقيقةٍ قادرةٍ على إيضاحِ الظواهريةِ بقدرِ المجتمعِ الافتراضيّ. فالمجتمعُ الظواهريُّ مجتمعٌ افتراضيّ. والمجتمعُ الافتراضيُّ هو الوجهُ الحقيقيُّ للمجتمعِ الظواهريّ، بل وأبعدَ من ذلك، إنه الحقيقةُ بحَِدِّ ذاتها. وعَدَمِيةُ معنى الظواهرِ )أو بالأصح، ينبغي إدراكَ عدميةِ المعنى من حيث إشارتها إلى حَمَّامِ الدمِ والمجتمعِ الخياليِّ والمجتمعِ الاستهلاكيّ( تُحَقِّقُ ذروتَها مع المجتمعِ الافتراضيّ. والمجتمعُ الإعلاميّ، المجتمعُ الاستعراضيّ، والمجتمعُ الجرائِديُّ إنما هم دوماً حقيقةُ المفهومِ الشيئانيِّ والظواهريِّ والوضعيةِ الظاهرةِ للعيان. وهذا بدوره إنكارُ الحقيقةِ بالأصل.
بِحُكمِ موضوعنا، بمقدوري ترتيبَ النتائجِ المشابهة، دون الشعورِ بالحاجةِ إلى مزيدٍ من البحثِ والتمحيص. مصطلحاتُ المجتمعِ الإسلامي، المسيحي، الموسوي، البوذي، الرأسمالي، الاشتراكي، الإقطاعيّ والعبوديِّ هي حقائقُ التعاطي نفسِه.
الوجهُ الميتافيزيقيُّ للوضعيةِ يَلُوحُ أمامنا هنا أيضاً. أجل، المجتمعُ الإسلاميُّ والمجتمعُ الرأسماليُّ ثمرةُ التعاطي عينِه. أي أنها اصطلاحاتٌ ظاهراتية. بمعنى آخر، هي مصطلحاتٌ استحقاقيةٌ وظاهرية. وبالإمكانِ قول الشيءِ ذاتهِ لأجلِ انتماء الأمةِ أيضاً. فمصطلحاتُ الأمةِ الألمانيةِ والفرنسيةِ والعربيةِ والتركيةِ والكرديةِ مجردُ حقائقَ ذاتِ طابعٍ وضعيّ. بينما هي مضموناً مظاهرُ ممسوخةٌ من الحقيقة. والحالُ هذه، قد يُطرَحُ سؤالُ: ما هي الحقيقةُ إذن؟ الجوابُ بسيطٌ حسبَ رأيي: هناك حقيقةُ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ الذي يُعَدُّ طبيعياً ضمن حقيقةِ المجتمع، وحقيقةُ المدنيةِ الساعيةِ دوماً إلى إفناءِ تلك الحقيقة. لا أقَولُ أنّ الصفاتِ والأسماءَ الأخرى لا تمَُثلُِّ الحقيقةَ بتاتاً. بل أقولُ أنها تُمَثِّلُ مظهَرَها وصياغتَها البسيطةَ المتغيِّرَةَ مِرارا،ً وليس جوهَرَها.
لِنَتَمَعَّنْ في حقيقةِ الأمةِ العربيةِ مَثَلاً. فالعُروبَةُ – ولو أنها باتت هزيلةً للغاية – لا تعني شيئاً في المكانِ المسمى ببِلادِ العربِ سوى حقيقةَ مجتمعٍ ذي مزايا أخلاقيةٍ وسياسية، وحقيقةَ السلطةِ التي بَسَطَت نفوذَها وسُلطانَها على ذاك المجتمعِ لآلافِ السنين، بالغةً به حافةَ التفسخِ والانهيارِ في يومنا الراهن. هذا وثمة آلافُ العربِ المختلفين والمتناقضين، بل وحتى الأعداء اللدودين لبعضهم البعض. أي، هناك آلافُ الحقائقِ المتناقضة! ويجبُ أنْ يَكُونَ كذلك، حسبَ الوضعية Pozitivizm . لكننا نَعلَم علمَ اليقينِ أنّ الحقيقةَ العربيةَ ينبغي ألا تَكُونَ كذلك مِن حيث الجوهر. مثالٌ آخَر أكثرُ بساطةً هو الأشجار؛ بالإضافةِ إلى آلافِ الغصونِ والعددِ الذي لا حصرَ له من الأوراقِ في كلِّ شجرةٍ بوصفها ظاهرة فإنْ كانت شجرةً مُثمِرةً ولها قيمتُها المعروفة، فحينها يَكُونُ لها معناها، وليس حسبَ غصونِها وأوراقها. بينما الوضعيةُ تعني عَمى إيلاءِ الشأنِ عينِه للجميع.
أجل، الغصونُ والأوراقُ أيضاً حقيقة. لكنها ليست حقيقةً قَيِّمة. لشجرةِ الكَرْمِ أو لِكيلو غرامٍ من العِنَبِ قيمةٌ ومعنى. لكنَّ ورقةً منها ليس لها سوى واقعٌ ظاهريٌّ مَظهَرِيٌّ، لا يَعكِسُ جوهَرَها، بل يَكتَسِبُ منظراً شكلياً فحسب.
يعُزى الدافعُ الأوليُّ وراءَ الأزمةِ العلميةِ إلى غَرَقِ العلومِ في الظاهرة، وولادةِ قاعدةٍ علميةٍ جديدةٍ يوميا،ً وإلى نظَرةِ جميعِها لنفسِها على أنها حقيقةٌ ذاتُ الشأنِ نفسِه. كنا حَدَّدنا علاقتَها مع النظامِ القائمِ في البداية. وانقسامُ الحقيقةِ على شكلِ قَرائن مثل: الذات – الموضوع، نحن – الآخَر، البدن – الروح، الدين – العلم، الميثولوجيا – الفلسفة، الإله – العبد، الظالمِ – المظلوم والحاكم – المحكوم وغيرها من الثنائياتِ المتضادةِ المستمرةِ والمتجذرةِ طردياً؛ إنما هو مضموناً ثمرةٌ لممارسةِ الإفناءِ والاستعمارِ التي تُمارِسها وتَخلقُها شبكاتُ المدنيةِ الاحتكاريةِ المتأسسةِ على المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. فالحداثةُ الرأسماليةُ بَلَغَت بالمجتمعِ نقطةِ التبعثرِ والانحلالِ الراهنةِ بإكثارِها اللامحدودِ لثنائياتِ المدنيةِ تلك، وبتعميقِها إياها. وللعلمِ المتواطئِ مع النظامِ القائمِ نصيبُه الوافرُ في ذلك أيضاً.
ولدى وصول التناقض بين المضمون الايدولوجي والبنيةِ الأداتية إلى حالةِ التناحرِ والتنافرِ الحادّ، تصبحُ الأزمةُ حالةً مُدرَكة. أي أنها تعني تحََوُّلهَا إلى صرخاتٍ في لحَمِ وروحِ الغالبيةِ الساحقة، من خلالِ البطالةِ والحربِ والمجاعةِ والبؤسِ والقمعِ والإبادةِ واللامساواةِ واللاحرية.
أشعرُ بالحاجةِ إلى التحذيرِ من السقوطِ في بعضِ حالاتِ سوءِ الفهمِ لدى انتقادِ الوضعية. أُولاها؛ أنا لستُ سالكاً موقفاً من قبيلِ القولِ بأنه لا قيمةَ بتاتاً للظواهر، وأنه لا علاقةَ لها إطلاقا بالواقع. إنما أقولُ إنها محدودة فقط، وأنُوَِّهُ إلى المخاطرِ الجَسيمةِ التي تؤدي إليها لدى الانتقالِ بالظواهريةِ إلى مستوى الفلسفة، وأُشَدِّدُ على أنَّ هذا الوضعَ قد بانَ بما يَزيدُ عن الحدِّ في نظامِ الفكرِ الأوروبي. خاصيةُ سوءِ الفهمِ الثانية؛ قد يُوَجَّهُ لي نقدٌ بانزلاقي نحوَ ضربٍ من ضروبِ الأفلاطونية. ويرُتقََبُ هذا النقدُ بالأخصِّ في مثالِ الشجرة، عندما قُلتُ أنّ الجوهرَ هو المُعَينِّ. لكنّ ما أردتُ تبيانهَ ليسَ فكرةَ أو مزاعمَ «الشجرة .» بل أُشيرُ إلى الواقعِ الذي تحتويه الشجرةُ بالنسبةِ للمجتمع. هذا ولا أَعرضُ تناوُلاً مَنفعياً. إنما أَقتَصِرُ على القولِ بضرورةِ تحديدِ الواقعِ من قِبَلِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ فقط. قد تَكُون الشجرةُ ناجعةً لأجلِ فردٍ أو مجموعةٍ ما. لكني أسعى للقولِ أنه لا قيمة حقيقية لهذا الوضع، ما لَم يَتمّ تفسيرُه بالمنوالِ نفسِه من قِبَلِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ.
إني أَنتَقِدُ الفلسفةَ التي تَعمَلُ الليبراليةُ على فرضِها، والتي تقَول: «يظَهَرُ الأفراد، ويعَثرُون على ما يرََونه حقيقيا،ً ويعَيشون كفلاسفةٍ أو رجالاتِ علمٍ أو جنودٍ أو ساسةٍ أو مستثمِرين أو ما شابه ». وأراها غيرَ أخلاقيةٍ وغيرَ سياسيةٍ مجتمعياً. وأسعى للقولِ إنّ هذا هو أفظعُ أشكالِ أيديولوجيةِ اللاأخلاقِ واللاسياسةِ التي أَسفَرَ عنها تاريخُ المدنية، والتي يسعى النظامُ الرأسماليُّ إلى بسطِها على المجتمعِ برمته.
أو بالأحرى، إنه سردٌ ميثولوجيٌّ عصريٌّ يتمُّ فرضُ قَبولِه بالدعاية، ويكُسى بغلافِ ورداءِ الحداثة. إذن، والحالُ هذه، فالسؤالُ أو القضيةُ التي تكَتسَبُ أهميةً أكبر ستَكُون: أينَ وكيفَ سنَجِدُ الحقيقة؟ أودُّ إعطاءَ جوابي بالتذكيرِ بقاعدةٍ بسيطةٍ للغاية: لا يُمكنكَ العثور على شيءٍ ما إلا بالبحثِ عنه في المكانِ الذي فَقَدتهَ فيه. وإلا، فلا يمُكنكَ العثور عليه في مكانٍ آخر، حتى لو بحثتَ عنه في العالَمِ أجمع؛ لأنّ الأسلوبَ حينذاك خاطئ. أي أنّ أسلوبَ البحثِ في مكانٍ آخر، لا في مكانِ ضياعِ الشيء، لا يعني سوى هدر الزمانِ والطاقة. أنا أُشَبِّهُ تَقَصِّياتِ الحقيقةِ الراهنةَ بهذا المثال. فعلى الرغمِ من مختبراتِ وودائعِ ومُعطَياتِ البحثِ الفظيعة، الا أنّ الحقائقَ المبلوغةَ مشحونةٌ بالأزمةِ والألم. جليٌّ أنه من المحالِ أنْ تَكُونَ هذه هي الحقيقةُ التي تَهرَعُ البشريةُ وراءها. سيكَُون رَدِّي تكرارَ التكرارِ مِرارا.ً لا يمُكِنُ للحقيقةِ إلا أنْ تَكُونَ اجتماعية. وستَكُونُ الحقيقةُ الاجتماعيةُ مَفقودةً وزائلة لدى إفناءِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ، وإخضاعِه للهيمنةِ المُشَدَّدةِ لاحتكارِ الاستغلالِ والسلطة ضمن سياقِ المدنية. ما تمّ فقدانه قد فُقِدَ مع القيمِ الأخلاقيةِ والسياسية. وإنْ كنت تَوَدُّ العثور عليه مجدَّداً، فعليكَ البحثِ عنه في مكانِ إضاعتِه. أي أنه عليك البحثِ عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ وواقعِه، والعثورِ عليه تجاه المدنيةِ والحداثة. وعليكَ ألا تكتفي بذلك، بل ويجب إنشاءَ كيانِه الذي باتَ في حالةٍ مجهولةٍ لا يمكن التعرف عليها. حينئذٍ فقط سترى أنكَ تَعثُرُ على جميعِ الحقائقِ النفيسةِ كالذَّهب واحدةً تِلوَ الأخرى، بعدَما كنتَ أَضَعتَها على مرِّ التاريخ. وستكَُونُ أكثرَ سعادةً بناءً على ذلك. وستدُرِكُ أنّ هذا يَمُرُّ من المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي.
لدى إعادةِ ترتيبِ الميدانِ الفكري سأجهَدُ لطرحِ بعضِ اقتراحاتي ضمن إطارِ الوظائفِ والمهام، وعرضِها كمبادئ على أساسِ تلك الانتقادات:
-1 ينبغي تطوير الجهودِ الفكريةِ ونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ ضمن إطارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ، الذي هو حالةُ الوجودِ الأساسيةُ للطبيعةِ الاجتماعية. واقعُ هذا المجتمعِ المَبتورِ طيلةَ تاريخِ المدنية، والمُفنى والمُعَرّى تدريجياً؛ قد تَمَزَّقَ تماماً مع العهدِ الحديثِ الذي تَرَكَ الرأسماليُّ بصماتِه عليه، فتُرِكَ يواجِهُ التفسخَ والانحلال، وبُلِغَ به إلى شفيرِ الفناء.
-2 إذن، والحالُ هذه، على الجهودِ الفكريةِ ونشاطاتِ المعرفةِ والعلمِ إيقافَ هذا السياقِ أولاً. ذلك أنه لا علمَ لشيءٍ مُعدَم. قد يَكُون ذِكرى له، ولكنّ الذكرى ليست علماً. فالعلمُ معنيٌّ بما هو حيٌّ وكائن. والمجتمعُ الذي يكون في هذه الحالة مُرغَمٌ بالضرورةِ على التصََدِّي للحداثةِ ذاتِ الطابعِ الرأسمالي )بكلِّ عناصرِها ومُقَوِّماتها(، إنْ كان لا يَرغَبُ بالفناء كلياً. لقد
بات التصدي والمقاومة في نفسِ مستوى الوجودِ ورَدِيفاً له. إنْ كان ثمة رغبةٌ في العيشِ والصمودِ بِعِزَّةِ وكرامةِ الباحثِ الحقيقي، لا كرأسِ مالٍ أو حَمَّالٍ فكريّ؛ فما على المُفَكِّرِ إلا أنْ يكَُون مُقاوِما في جميعِ مساعيه، وأنْ تكَُونَ عناصرُ بحوثهِ ذاتَ أبعادٍ مقاوِمةٍ كأمرٍ لا مناصّ منه. والفكرُ والعلمُ مُقاوِمان بهذا المعنى. وأيُّ شكلٍ آخَر لا يعني سوى خداعَ الذاتِ أو إخفاءَ هويةِ رأسِ المالِ والحَمَّال.
-3 العلمُ المُرادُ صياغته، مِن الضروريِّ ترتيبه على شكلِ «علم اجتماع » بالدرجةِ الأولى. ينبغي الاعترافَ بعلمِ الاجتماعِ بِصِفَتِهِ المَلِكَةَ الأمَّ لجميعِ العلوم. بينما العلومُ الأخرى المعنيةُ بالطبيعة الأولى ( الفيزياء ، علم الفلك الكيمياء بالالبيولوجيا(، والمعارفُ – العلومُ البشريةُ المعنيةُ بالطبيعةِ الثانية )الآداب، الفلسفة، الفن، الاقتصاد وغيرها( لا يمُكِنها البتةَ أنْ تحَمِلَ عبءَ الريادة؛ لأنها عاجزة عن عقدِ الأواصرِ القَيِّمَةِ مع الحقيقة. لن يَكونَ بمقدورِ كِلتا الساحتَين أخذَ نصيبِهما من الحقيقة، ما لَم تَعقدْ علاقاتِها مع علمِ الاجتماعِ بنجاحٍ موَفَّق.
-4 على علمِ الاجتماعِ البحثَ أساساً في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ كموضوعِه الأولي، لا كموضوعٍ شيئيّ، ولا كثنائياتٍ معشِّشةٍ في وعيِ الإنسان ومَفصولةٍ عن بعضِها بهُِوّاتٍ شاسعةٍ من قبيلِ الذاتِ – الموضوع، نحن – الآخَر، البدن – الروح، الإله – العبد، والميت – الحيّ؛ بل بأسلوبٍ يتعدى هذه القرائن. التباينُ والاختلافُ نمطُ حياةِ الكون، وصِفَةٌ ساريةٌ في طبيعةِ المجتمعِ أيضاً بحالةٍ أكثرَ مرونةً وحريةً وكثافة. لكنّ الانتقالَ بهذا الاختلافِ إلى مستوى التمييزِ بين الذاتِ والموضوعِ الذي باتَ الأرضيةَ الأُساسيةَ لكافةِ بنُى المدنيةِ والحداثةِ الأيديولوجية، سوف يعني فُقدانَ وتمََزُّقَ الحقيقةِ الاجتماعيةِ والكونيةِ على السواءِ دون أدنى شك.
-5 من المحالِ تطوير براديغما قَيِّمَةٍ بشأنِ علمِ الاجتماع )فلسفة العلم المضادّ جذرياً للمدنية(، دون الرميِ بالوضعيةِ في مزبلةِ التاريخِ تأسيساً على الانتقاداتِ الشاملة. حيث أنّ الوضعيةَ لا تَنفَكُّ مستمرةً بكلِّ حِدَّتِها كفلسفةٍ عامةٍ لتلك الشيئانيةِ التي بلَغََت أوَجَها في الحداثةِ الأوروبية، وتصاعَدَت على العلمِ عموماً وعلى علمِ الاجتماعِ خصوصاً. إنَّ إدراكَ وتَبَنِّيَ المكتَسَباتِ الإيجابيةِ للعلمِ الأوروبيِّ المِحور – وبالأخصِ علمِ الاجتماع – وفهمَ نصيبِه من الحقيقةِ شرطٌ أساسيّ، على الرغمِ من كونه مشَتَّتاً للغاية ويَشتَمِلُ على مهالِكِ فقدانِ الحقيقة. فبقدرِ ما يتوجبُ انتقاد الوضعيةِ وتَخَطّيها، فمن الضروريِّ أيضاً تَبَنّي وهضمَ حِصَصِ الحقيقةِ البارزةِ للعيانِ بالمِثل. والمناهَضةُ الأوروبيةُ جذريا لدى تقََصّي الحقائقِ قد تؤدي إلى نتائج سلبيةٍ بقدرِ النزعةِ الأوروبيةِ الجذريةِ بأقلِّ تقدير.
-6 على الرغمِ من أنّ بُحوثَ الحقيقةِ المسماةَ بما وراء الحداثةِ تنَتقَِدُ الوضعيةَ وتدَحَضُ علمَ الاجتماعِ الأوروبيَّ المحور، إلا أنه بالمستطاعِ لبَْرَلةََ هذه المواقف، وإكسابهَا شكلاً مِن المُناهَضةِ الأوروبيةِ التي هي أكثرُ مناهَضةً للحقيقة. من الأهميةِ بمكان الاقترابَ بشكلٍ انتقاديٍّ لآخِرِ درجة، على الرغمِ من عدمِ الرفضِ الكليِّ لهذه البحوثِ الماوراء حداثيةِ من خلالِ الاستفادةِ من الحالةِ المتأزمةِ لعلمِ الاجتماع. وبقدرِ ما يَكُون الأسلوبُ والإرشادُ القائلُ بالكونيةِ المطلقةِ والتقدمِ على مسارٍ مستقيمٍ في الوضعيةِ المُعاصرةِ أمراً تَحريفياً، فإنّ العديدَ من الأساليبِ الماوراء حداثوية القائلةِ بالنسبيةِ الدائريةِ المُفْرِطةِ أيضاً منفتحةٌ أمامَ تحريفاتٍ مشابهة. من هنا، ولِكَي لا يتمّ الانجرار وراءَ هذه الأطرافِ المتطرفة، فإنّ التبَنَيَِّ الحَسَنَ للمبادئِ الأساسيةِ )التي نسعى لترتيبها( الواجبِ الالتزامَ بها يُعَدُّ شرطاً ضروريّاً. الأوساطُ المتأزمةُ قابِلةٌ لبحثِ كلِّ واحدٍ تقريباً عن سبيلٍ للحقيقةِ حسبَ هواه. وهذا الأمرُ بِمُفردِه قد يُحَرِّفُ بحوثَ الحقيقةِ من جوانبَ عديدة، ويُفرِغها من محتواها.
-7 لدى البحثِ عن الحقيقة، لا يُمكن أنْ يَكُونَ أسلوبُنا شيئانياً وضعياً، ولا ذاتانياً نسبياً. كِلاهما وجهانِ لِلِّيبراليةِ مضموناً، ويُعَبِّرانِ عن تَضَخُّمِ الأسلوبِ الذي تَستَخدِمه الليبراليةُ في إنتاجِ رأسِ المالِ والحَمْلِ الفكريِّ بعدَ خَلطِهما ببعضهما وعَرضِهما في السوق. وهذا التضََّخُّمُ الأسلوبيُّ هو الجانبُ الأكثر تأثيراً فيها في تصييرِ الحقيقةِ مستحيلة. وهذا بدوره ما مفادُه خلطَ الأساليبِ الشيئانيةِ والذاتانيةِ لِتَتَمَخَّضَ عن كثرةٍ في الأساليبِ تَكادُ تُعادِلُ عددَ الأشخاصِ المعنيين. من المهمِّ عدمَ الانخداعِ بوفرةِ الأساليبِ تلك، كونها تشيرُ إلى ممارسةِ الحطِّ من شأنِ الحقيقةِ بحيث تصبحُ كالمالِ الفاسد. لا ريب أنّ للحقيقةِ جوانبها الموضوعية الشيئانية والذاتانية. فالوعيُ والحقيقةُ في نهايةِ المطافِ يعَُبرِّان عن تقَاطُعِ ثنائيِّ الراصِد – المَرصود )لا أرمي إلى المِثليةِ هنا. وسيكَونُ من الأفضل إدراك ذلك باعتباره تكافُؤاً(. وبقدرِ ما يَحصُلُ التعمقُ والتركيزُ في هذا المضمار، فسوف يَبرزُ المزيدُ من حِصَصِ الحقيقةِ بالمثل.
وهي في الحالةِ هذه ليست في وضعِ الذاتِ الراصدة، ولا الموضوعِ الشيءِ المَرصود. بل إنها تعني تَقارُبَ كِلَيهما من بعضهما، وبلوغَهما وضعَ التكافؤ، إنْ لم يُقَلْ التطابق. السياقُ الذي تَصِلُ فيه الحقيقةُ أقصاها هو بلوغُ إمكانيةِ هكذا تكافؤ. إني مضطرٌّ لتعريفِ موضوعِ الأسلوبِ بهذه الشاكلة، دون الشعورِ بالحاجةِ إلى إطلاقِ تسميةٍ عليه حالياً. إننا لا نتغاضى في أيِّ زمانٍ أو مكانٍ عن كونِ الوحدةِ Birim الأوليةِ للراصد والمرصود هي المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ دون أيِّ شك.
-8 لا يُمكِن أنْ تَكُونَ المؤسساتُ الرسميةُ للمدنيةِ والحداثة، وعلى رأسها الجامعات، أماكنَ بحثٍ أساسية. ذلك أنّ سلطويةَ العلمِ وإنتاجَه في مؤسساتِ الدولةِ الرسمية، يعني فُقدانهَ روابطَه مع الحقيقة، سواءً ماضيا أم حاضرا.ً وانقطاعُ أواصرِ العلمِ مع المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ يعني إخراجَه من كونه مفيداً للمجتمع، بل – وبالعكس – تصييرَه مساعِداً لتطويرِ احتكاراتِ القمعِ والاستغلالِ على المجتمع. فكما أنّ المرأةَ المحبوسةَ في البيوتِ العامةِ أو الخاصة تَفقدُ واقعَها وحقيقتَها الحرة، فإنّ المُفَكِّرين والعلمَ المحبوسَ في المؤسساتِ الرسميةِ يَفقُدُ حريتَه وهويتَه الحقيقيةَ بالمِثلِ تماماً. لا ريب أنّ المرامَ من ذلك ليس استحالةَ تنشئةِ المفكرين أو إنتاجِ العلمِ في تلك المؤسسات.
الأمرُ الواجبُ فهمه هو أنّ المُفَكِّرَ والعلمَ السلطويَّين سوف ينقطعانِ عن هدفِهما في البحثِ والاختراعِ المعنيَّينِ بالواقعِ الاجتماعي. بينما التحَوُّلُ إلى مُفَكِّرٍ أو إبرازُ مُنجَزاتٍ ذاتِ قيمةٍ علميةٍ من بابِ الاستثناء لا يُبَدِّلُ من الحقيقةِ الأوليةِ شيئاً.
-9 الثورةُ المؤسساتية، أو بمعنى آخر إعادةُ البناءِ شرطٌ ضروريٌّ لأجلِ علمِ الاجتماع. فكما أنه قد تَشَكَّلَت الفلسفةُ وأكاديمياتُ العلمِ المستقلةُ في عهدِ التنويرِ الإغريقيِّ – الإيوني، وأدَّت المدارسُ وبيوتُ الدراويشِ والأديرِةُ دورا مشابها في التقاليدِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ على السواء، وكما أنّ كونَ حركات النهضةِ والإصلاحِ والتنويرِ الأوربيةِ ثوراتٍ فكرية وعلمية في الوقتِ نفسِه كأمرٍ واقع؛ في يومنا الراهنِ أيضاً ثمة حاجةٌ ماسةٌ لثوراتٍ شبيهةٍ لأجلِ النفاذِ من الأزمةِ القائمة.
وهيمنةُ الحداثةِ الأيديولوجيةُ المُعَمِّرَةُ أربعةَ قرونٍ بِحالها غيرُ مُخَوَّلةٍ ولا قادرةٍ على تجاوُزِ أزمتِها العميقةِ والمتواصلةِ حتى بقدرِ الهيمنةِ الثقافيةِ الماديةِ على الأقل. ولا مَهرَبَ من أداءِ الأزمةِ دورا مُفَكِّكا ومُبعَثرِا أكثرَ فأكثر، دون حصولِ تَدَخُّلِ العصرانيةِ الديمقراطيةِ شكلاً ومضموناً. وانطلاقةٌ في هذا المنحى تتميزُ بإرثٍ فكريٍّ وعلميٍّ غنيٍّ للغاية، بدءاً من الاشتراكيين الطوباويين إلى الاشتراكيين العلميين، ومن الفوضويين إلى مدرسةِ فرانكفورت، ومن الانطلاقةِ الفلسفيةِ الفرنسيةِ في النصفِ الثاني من القرنِ العشرين إلى ثورةِ الشبيبةِ الثقافيةِ عامَ 1968 ، وصولاً إلى الانطلاقاتِ الماوراء حداثوية والفامينيةِ والأيكولوجيةِ البارزةِ مؤخَّرا فيما بعد أعوامِ التسعينيات. العصرانيةُ الديمقراطيةُ مُرغَمَةٌ على إنجازِ ثورتِها الفكريةِ والعلميةِ بالتأسيس على تَبَنّي واحتواءِ الإشعاعاتِ والثوراتِ الفكريةِ لعهدِ المدنيةِ من جانب، والجوانبِ الإيجابيةِ للانطلاقاتِ الفكريةِ المضادةِ للحداثةِ من الجانب الآخر.
والتمأسسُ أحََدُ شروطِ هذه الثورة. فالثورةُ الفكريةُ بحاجةٍ لمركزٍ مؤسساتيٍّ عالَميٍّ جديدٍ على ضوءِ استخلاصِ الدروسِ والعبرِ من التجارب التي يرَِدُ ذِكرُها في التاريخ، وذلك بغرضِ نجاحِها على الصعيدِ العالمي. هذا وبالمقدورِ إنشاءَ كونفدرالية الثقافاتِ والأكاديمياتِ العالمية في سبيلِ تلبيةِ هذه الحاجة. هذه الكونفدراليةُ التي سوف تُنشَأُ في جغرافيا حرة، لن تَكونَ تابعةً لأيةِ دولةٍ قوميةٍ أو قوةِ سلطة، مثلما ينبغي تَشَكُّلها على أساسِ مناهَضةِ احتكاراتِ رأسِ المالِ أيضاً. الأساس هو استقلاليتُها وشبهُ استقلاليتها. وبالمستطاعِ تحقيقَ الانخراطِ فيها من جميعِ الثقافاتِ المحليةِ والأكاديمياتِ الإقليمية – الوطنية، كلما تمّت أَقلَمةُ منهاجِها وتنظيمِها وممارستِها تأسيساً على الطواعية كما بإمكانِ الكونفدراليةِ التوجُّهَ صوبَ تمأسُساتٍ مُكَلَّفةٍ بالمهامِّ على الأصعدةِ المحليةِ والمناطِقيةِ والقوميةِ والقارية.
-10 يُمكِنُ لأكاديمياتِ السياسةِ والثقافةِ الديمقراطيةِ أنْ تَكُونَ تمََأسُساتٍ مناسبةً لهذه المَهَمَّة. حيث بمقدورِ هذه الأكاديمياتِ تقديمَ الدعمِ الفكريِّ والعلميِّ اللازمِ لتلبيةِ احتياجاتِ إعادةِ بناءِ وحداتِ ومُكَوِّناتِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. وبناؤُها كانطلاقاتٍ أصليةٍ أنسَبُ من أنْ تَتَّخِذَ المؤسساتِ الاحتكاريةِ الرسميةِ والخاصةِ قُدوةً لها. ذلك أنّ تقليدَ مؤسساتِ الحداثةِ قد يؤَولُ إلى الانتهاءِ بالفشل. ومن حيثُ البداية، بإمكانهِا أنْ تَنُصَّ على كونِها ديمقراطيةً وشبهَ مستقلة، وأنْ تُشَكِّلَ بنفسِها منهاجَها وتُنشِئَ كوادرَها، وتَعمَلَ أساساً بالتَّعَلُّمِ والتعليمِ الطوعي، وأنْ تَتَبَدَّلَ مواقِعُ الطلبةِ والمُعَلِّمين فيما بينهم مِراراً، وأنْ يَنخَرِطَ فيها الجميعُ ممن يتسمُ بالعزمِ والطموحِ بدءاً من الراعي على ذرا الجبالِ إلى المُحترَِفِ المُتمََرِّس. هذا ومن الملائم تشكيل الأكاديمياتِ التي يَغلبُ عليها الطابعُ النسائي، وتأسيسها بالمضمونِ عينِه بالإضافةِ إلى الجوانبِ الخاصةِ بها بغرضِ تصييرِهن علميات. ولكي لا تَبقى مُقتَصِرةً على الجانبِ النظريِّ فحسب فإنّ المشاركةَ العمليةَ المتعددةَ الجوانبِ تعَُدُّ إحدى الماهياتِ المأمولة. تؤَُسَّسُ وتفَُعَّلُ الأكاديمياتُ من حيث الزمانِ والمكان حسب ما تقتضيه الاحتياجاتُ العملية.
إنها مؤسساتٌ شفافةٌ وطوعيةٌ مثلما تُصادَفُ أمثلتُها بكثرةٍ في التاريخ )مواقِد زرادشت النارية على ذرا الجبال، حدائق أفلاطون وأرسطو، أروقة سقراط والرواقيين، أديرة العصورِ الوسطى ومدارسها(. يمكن اختيارَ الأماكنِ بدءا من ذرا الجبالِ إلى الضواحي النائية. هذا ولا يتمّ البحثُ عن الأبنيةِ التي تُثبِتُ عظمةَ السلطة دون شك. أما زمانُ التعليم، فيتَحَدَّدُ حسبَ وضعِ المشاركين فيه وفقَ كثافةِ تَدَفُّقِ الطلبة، مثلما الحالُ في الأديرةِ والمدارسِ المدنية. ولا داعيَ للتوقيتِ الزمانيِّ الصارمِ كما في المؤسساتِ الرسمية. إلى جانبِ أنه لا يمكن التفكير بافتقارها كلياً للشكلِ والقواعد. حيث لا بدَّ من وجودِ القواعدِ الأخلاقيةِ والجمالية بكلِّ تأكيد.
المشارَكةُ الفكريةُ والعلميةُ شرطٌ في نشاطاتِ إعادةِ إنشاءِ مُكَوِّناتِ وعناصرِ العصرانيةِ الديمقراطية. واضحٌ استحالة تحقيقِ هذا الشرطِ عبرَ رأسِ المالِ الفكريِّ الموجودِ في السوق.
ولا يُمكِن إلا للكادرِ والعلمِ النابعِ من الأكاديمياتِ الجديدةِ تلبيةَ هذه الحاجة. هذه التقييماتُ ومبادئُ الحلِّ الموجَزَةُ التي عملتُ على طرحِها ضمن إطارِ المهامِّ الفكريةِ هي بمثابةِ مُقتَرَحاتٍ تقتضي النقاشَ والمُداولةَ دون ريب. وليس بالمستطاعِ التغلبَ على ظروفِ الأزمةِ بالاتجاهِ الإيجابيِّ إلا بالانطلاقاتِ الفكريةِ والعلميةِ الجديدة. وإذ ما وُضِعَ نصبَ العينِ أنّ الأزمةَ المذكورةَ عالميةٌ وممنهجةٌ وبنيوية فمن الساطعِ أنّ النفاذَ منها يتطلب ضرورةَ أنْ تَكونَ المداخلاتُ عالميةً وممنهجةً وبنيوية. هذا وبالإمكانِ الاستفادة من التجاربِ الثوريةِ التي لا حصرَ لها في استخلاصِ الدروس المُشيرةِ إلى استحالةِ الوصولِ إلى مكانٍ ما من خلالِ تقليدِ القوالبِ والمؤسساتِ القديمة، أو تصييرِها توفيقيةً متمفصلة.
إنشاءُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ لذاتِها بالتداخُلِ مع ثورةٍ تنويريةٍ جذريةٍ يأتي في صدارةِ العِبرَِ الواجب تعََلمَُّها من الماضي. وإلى جانبِ ذلك عليَّ التنويهَ فوراً إلى أنّ الماضيَ هو الآن. وعلى الرغمِ من عدمِ تَطَرُّقِنا المستفيضِ لكاملِ ماضي المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ الذي يُعتَبَرُ شكلَ الوجودِ الأصليَّ للطبيعةِ الاجتماعية )ولكن، علينا عدم التغاضي البتةَ عن أنّ المجتمعَ النيوليتيَّ ومجتمعَ القريةِ – الزراعة والبدوَ الرُّحَّلَ والقبائلَ والعشائرَ والجماعاتِ الدينيةَ لا تَبرَحُ مستمرةً بِحَيَواتِها بعَزمٍ عنيد( إلا أنّ إنتاجَ الفكرِ والعلمِ ذي الماهيةِ الثوريةِ سوف يشَُكِّلُ الدعمَ المُرتقََبَ بالأكثر في سبيلِ إعادةِ اكتسابِ واستردادِ قِيمَِه المَهدورةِ طيلةَ الأعوامِ الخمسةِ آلافِ الأخيرةِ على يدَِ احتكاراتِ تكديسِ رأسِ المالِ والسلطة. ومساعينا في التعمقِ والتحليلِ والحلِّ بشأنِ مهامِّنا الفكريةِ بغرضِ تلبيةِ هذه الحاجةِ التي لا استغناءَ عنها إطلاقاً إنما تتسمُ بأهميةٍ حياتيةٍ ومصيريةٍ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى.




