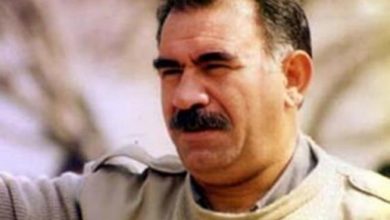الأزمة وحل الحضارة الديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط
الأزمة وحل الحضارة الديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط

 الحقيقة الاجتماعية وأشكال الاغتراب:
الحقيقة الاجتماعية وأشكال الاغتراب:
بالمستطاعِ الحديث عن تَحَقُّقٍ حرٍّ لمعنى وحقيقةِ الواقعِ الاجتماعيّ، طالما لا يَتركُ مجالاً للقمعِ والاستغلال، سواءً داخلَه أو خارجَه. المعنى والحقيقةُ حُرّان في هذه الحالة. أي أنّ كينونةَ الحريةِ غيرُ ممكنةٍ إلا بكينونةِ المعنى والحقيقة. ومَن لا حريةَ له، يستحيلُ أنْ يَكُونَ له هوية، وبالتالي معنى وحقيقة.
أشكالُ الحقيقةِ السائدةُ في الظروفِ التي تُشاهَدُ فيها المخاطرُ الناجمةُ من أسبابٍ طبيعيةٍ من قبيلِ القحط، هجماتِ الحيوانات الكاسرة، الصعوبات المَناخية، والأمراض المُعدِية؛ وأشكالُ الحقيقةِ السائدةُ في الظروفِ التي يَطغى عليها العطاءُ والوفرةُ من قبيلِ وفرة الحبوب الغذائيةِ والفواكهِ وحيواناتِ الصيد، المَناخات الملائمةِ والأجواء الآمِنة والسليمة؛ إنما تنشأُ بمنوالٍ مختلفٍ عن أشكالِ الحقيقةِ السائدةِ في المجتمعاتِ التي يتواصلُ فيها تطبيقُ القمعِ والاستغلالِ الاجتماعيَّين.
بإمكاننا ترتيب هذه الأشكالِ بخطوطِها العامةِ كما يلي:
-1 تُعَدُّ الميثولوجيا والأديانُ والفنونُ أشكالَ التعبيرِ الأساسيةَ عن الحقيقة، في الظروفِ التي لَم يتصاعدْ التحكمُ الاجتماعيُّ )الهرمية والدولة( فيها بَعد. بينما دورُ الفلسفةِ والعلمِ محدودٌ في إيضاحِ الحقيقة. أما الشكلُ الطاغي في التعبيرِ عنها، فهو الميثولوجيا. وكما هو معلوم، فالميثولوجيا هي السرودُ التي على شكلِ مَقُولاتٍ شائعةٍ وملاحِمَ وحكاياتٍ وأقاصيص. ثمة حقيقةٌ مخفيةٌ في الميثولوجياتِ أيضاً دونَ بُد. أو بالأحرى، فالميثولوجيا شكلٌ من أشكالِ نُطقِ الحقيقةِ وقَولِها. كما أنّ الدينَ غيرَ الغارقِ في المدنيةِ هو شكلٌ يَطغى عليه الجانبُ العقائديُّ ويُضفي الجزمَ والحسمَ على تَثمينِ الحقيقةِ أكثر، نسبةً للميثولوجيا. أي أنّ الدينَ هو الميثولوجياتُ التي يَسُودُ الإيمانُ بقَطعيتِها. ثمة تَسَاوٍ وتطابُقٌ مع الحقيقةِ في العقائدِ والأحكامِ الدينية. هذا وتَكُونُ الحِكمةُ )الفلسفة( والعلمُ مشحونَين بآثارِ الميثولوجيا والدين. كما أنّ الفنَّ كشكلٍ من أشكالِ إيضاحِ الحقيقة، على صِلَةٍ وثيقةٍ مع الذهنيةِ الدينيةِ والميثولوجية. إذ يَسعى للتعبيرِ عن المعنى كموسيقا ورسم.
من هنا، فالتّحَرّي عن المعنى المُناط بالموسيقا والرسم والتِّمثالِ يُعَدُّ أحدَ أنشطةِ الحقيقةِ الهامة. أي أنّ المهمَّ هنا ليس الموسيقا والرسوم والتماثيل بِحَدِّ ذاتِها، بل قيمَتُها من حيث المعنى والحقيقةِ اللذَين تُعَبِّرُ عنهما.
شاعريةُ لغةِ الميثولوجيا والدينِ أساسية. فاللغةُ بِحَدِّ ذاتِها مفعمةٌ بالسرودِ الشعريةِ منذ مدةٍ طويلة، أي منذ ولادتِها.
بالتالي، ثمة علاقةٌ رصينةٌ بين الشعرِ والحقيقة. فالشعرُ هو لغةُ وحقيقةُ المجتمعِ الحرِّ القديمِ الذي لَم يتعرَّفْ على التحكم. والشعراءُ الأوائلُ هم أولئك الذين عَمِلوا على إظهارِ الحقيقةِ قبلَ ظهورِ الحكماءِ والأنبياء. وشاعريةُ لغةِ مجتمعٍ ما وقدرتُها على السردِ الفنيّ، مؤشِّرٌ على مدى تَمَتُّعِه بواقعٍ اجتماعيٍّ حرٍّ وذي معنى ثمين.
2-مجتمعُ المدنيةِ، بصفتِه نظامَ المجتمعِ الطبقيِّ والدولتيّ، مُمَزَّقٌ من حيثُ المعنى والحقيقة، نظراً لتَصَدُّعِه وتَعَرُّضِه للتحكمِ داخلَياً وخارجياً على السواء. تَغتَرِبُ الحقيقةُ بسببِ اختلاطِ التحكُّمِ بالسردِ الميثولوجيِّ والدينيّ.
ويتعلقُ الاغتراب بصُلبِ ووجودِ مجتمعِ المدنية، ولا يعتمدُ على القولِ فحسب. فلدى تقديمِ التنظيماتِ التحكميةِ للمعاني التي تحتويها على أنها الحقيقة، فإنّ تَغَيُّراتٍ جذريةً تَعتَري براديغمائياتِ الحياةِ الاجتماعية. وتتكونُ الحياةُ المتناقضةُ والأشكالُ البراديغمائيةُ التي تُوَجِّهُها ضمن المجتمع. يُعاشُ الاغترابُ بِنَخرِ الحقيقةِ وقَرضِها ونَحتِها وصَهرها. هذا وتتدنى باستمرار قيمةُ الذين يَحيَون الاغترابَ كحقيقة، حصيلةَ الجهودِ المبذولةِ في سبيلِ تَقَبُّلِ الشذوذِ والقمعِ والتعتيم. ولدى عدمِ بقاءِ حقيقةٍ يُصارَعُ ويُحارَبُ لأجلها، يصيرُ المجتمعُ الذي يَحيا الاغترابَ كومةً من البنى العديمةِ المعنى والجدوى. حينها تغدو البنى المذكورةُ عبئاً على كاهلِ المجتمعِ وضرباً من المرضِ الاجتماعيّ، لا غير. فالتزمُّتُ والتعصُّبُ يستَذكَران بالأسماءِ المَرَضِيّةِ من قبيلِ الفاشية. هكذا يصبح الاغترابُ بلا معنى من حيث هو واقعٌ اجتماعيٌّ في حالةِ مَرَض. وفقدانُ المعنى يَعكِسُ حالةَ المجتمعِ الأكثر خطورةً على الإطلاق.
بالإمكان اقتفاءَ التصدُّعِ والصراعاتِ، التي عانتها الحقيقةُ في طبيعتِها الاجتماعية، داخلَ جميعِ أشكالِ المدنية. فكلما قَلَّت قيمةُ حقيقةِ الميثولوجيا والدين، كلما تَنَحّت الإلهاتُ والآلهةُ المَعبودةُ في أجواءٍ من المآدبِ والشعائر القَيِّمةِ والحيويةِ عن أماكنِها للأوثانِ التي لا قيمةَ لها. هكذا يتمُّ العبورُ من عصرِ الإلهةِ الأنثى البهيةِ والمقدسةِ التي تُغدِقُ المكافآت، إلى عصرِ الآلهةِ المُعاقِبةِ والمستَعبِدة. وفي حقيقةِ الأمر، فالتحوُّلُ الاجتماعيُّ )التحول من المجتمعِ الكوموناليِّ صوب المجتمعِ الطبقيّ( يُعَبِّرُ عن نفسِه ضمن الحقيقةِ بهذا المنوال. هذا وبالمقدورِ رصد هذا التحولِ بنحوٍ حيويٍّ للغاية في المجتمعِ السومريّ.
علاوةً على أنّ الحربَ تنشبُ بين الآلهةِ أيضاً. فبينما تَعكِسُ التقاليدُ الديونيسوسيةُ ذاتَها على أنها حقيقةُ المجتمعِ الكوموناليِّ الزراعيّ، فإنّ التقاليدَ الزيوسيةَ تُعكَسُ على أنها حقيقةُ الشرائحِ التحكميةِ التي طرأَ عليها أولُ تَصَدُّعٍ وتَحَوُّلٍ في هذا المجتمع. وحتى صراعُ هذَين التقليدَين يَجِدُ معناه الأصليَّ في المجتمعِ السومريّ، إذ ينعكسان على فنونِ ذاك العصرِ بنحوٍ ملفتٍ للأنظار. بينما عصرُ الإلهةِ الأنثى يُواظِبُ عكسَ نفسِه حتى عهدِ مريم أمِّ عيسى. وأثناء تَحَوُّلِ الرأسماليةِ إلى نظامٍ سائد، فإنشاؤُها حداثتَها بِحَرقِ «الساحرات » وهنّ لا يَزَلن على قيدِ الحياة، واللواتي هنّ آخرُ مُمَثِّلاتٍ عن عصرِ الإلهةِ الأنثى؛ هو أمرٌ تعليميٌّ وباعثٌ على التفكيرِ لآخرِ درجة.
تكتسبُ الفلسفةُ والعلمُ أهميةً ملحوظةً في عصرِ المدنيةِ كشكلَين للتعبيرِ عن الحقيقة. ويؤدي البحثُ عن الحقيقةِ والكفاحُ لأجلِها دوراً أساسياً في ذلك. وتَحلُّ الأنظمةُ الساعيةُ للتسترِ بالميتافيزيقيا مَحَلَّ الملوكِ – الآلهةِ المُقَنَّعين وغيرِ القادرين على إخفاءِ ذاتهم بالسردِ الميثولوجيِّ والدينيِّ بقدرِ ما كانوا عليه سابقاً. أي أنّ الميتافيزيقيا بوصفِها مثاليةً موضوعانية، تُطَوَّرُ كذاتٍ جوهريةٍ لأنظمةِ المدنيةِ المسيطرة، كنتيجةٍ لسقوطِ الأديانِ التوحيديةِ في النواقص. وتَقومُ «المُثُل » مقامَ الإله كحقيقة. وتُعرَضُ المثاليةُ على أنها أكثرُ حقيقةً باعتبارِها إلهاً متدوِّلاً. ولهذا السبب، ثمة أواصرٌ وثيقةٌ بين المثاليةِ والاغتراب. إذ تَدورُ المساعي للتعبيرِ عن الحقائقِ الاجتماعيةِ بالمُثُل، لا بالآلهة. أما تَعَرُّضُ الحقيقةِ الاجتماعيةِ للتآكلِ والتفسُّخِ والصهرِ والتحريف، فيَتَجَذَّرُ أكثرَ مع المثالية.
إنّ عدداً لا حصرَ له من الدولِ التي تتظاهرُ بالمدنية، كونَها نظامَ السلطةِ والاستغلالِ المهيمن، تَضَعُ ثِقَلَها أيضاً على الأشكالِ الفنيةِ المُبالَغِ فيها والمُزَخرَفةِ والمُهيبة، وذلك بغرضِ إخفاءِ معناها الاجتماعيِّ المتزايدِ ضيقاً بالتدريج. وعلى سبيلِ المثال، فالمدنيةُ الرومانيةُ والإغريقيةُ أَبدَت أهميةً فائقةً جداً لهكذا عروضٍ في ميادينِ العَمارِ ونحتِ التماثيلِ والموسيقا والموزاييك، وتقديمِها على أنها الحقيقة. أي، وبقدرِ ما يُغالي النظامُ في عرضِ نفسِه، فهو يسعى بالمِثلِ إلى إخفاءِ وتحريفِ معناه الاجتماعيّ )حقيقة المستَغَلّين والمسحوقين(. فيُرفَقُ العلمُ والفلسفةُ والفنُّ بالسلطة، وتُبذَلُ الجهودُ لتدويلِهم، مثلما كان الأمرُ في العصرِ الميثولوجيِّ والدينيّ. بالتالي، تُعاشُ مرحلةٌ من الكفاحِ العلميِّ والفلسفيِّ في مواجهةِ التصدُّعِ الاجتماعيّ.
وبقدرِ ما يتصدى العلمُ والفلسفةُ تجاه زوالِ المعنى وضياعِه، بقدرِ ما تتضاعفُ قوتُهما في التعبيرِ عن الحقيقة. في حين أنه كلما ائتَمَرا بإمرةِ أصحابِ السلطةِ والدولة، فإنهما يصبحان دوغمائيَّين، ويَفقدان عُراهُما مع الحقيقة، ويؤديان دورَهما كوسيلةٍ ناطقةٍ باسم الاغتراب. أي أنّ العلمَ والفلسفةَ تَصاعَدا كتعبيرٍ عن الحقيقةِ في وجهِ التعابيرِ الميثولوجيةِ والدينيةِ التي فقدَت أواصرَها مع الحقيقة. ولكن، عندما يُبَدّلان دورَهما فيَخرجان من كَونِهما يَتَّخِذان المجتمعَ أساساً، لِيَقوما بخدمةِ مصالحِ احتكاراتِ القمعِ والاستغلال؛ فإنهما يَغدوان دوغمائيَّين، ويَدخلان مرحلةَ فقدانِ أواصرِهما مع الحقيقة، تماماً مثلما الاغتراباتُالميثولوجيةُ والدينيةُ القديمة. هذا وتُعاشُ سياقاتٌ مشابهةٌ في الفنونِ أيضاً. فالفنونُ التي تفقدُ صِلاتِها مع الحقيقة، تسقطُ في حالةِ المغالاةِ بالذات، وتتصاغَرُ مبتعدةً عن التعبيرِ عن الواقعِ الاجتماعيّ.
القضايا الاجتماعيةُ الناجمةُ عن التحكمِ في عصرِ المدنية، تَفرضُ مساءلةَ الذاتِ وبلوغَ الحلِّ في كافةِ أنماطِ التعبيرِ عن الحقيقة. وبقدرِ ما يَكُونُ مصدرُ قضايا الحقيقةِ اجتماعياً، فحلولُها أيضاً مندرجةٌ في إطارِ علمِ الاجتماع. أما العلمُ المفتقرُ لأواصرِه مع المجتمعية، فلا مفرَّ مِن اغترابِه، وبالتالي فقدانِه عُراه مع الحقيقة. في حين أنّ المجتمعاتِ البارعةَ في كلِّ أساليبِ الحقيقة، هي مجتمعاتٌ تَخَلَّصَت من الاغترابِ ومن كونِها مُعضلةً إشكالية، وتَسُودُها المساواةُ والحريةُ والديمقراطية )أخلاقية وسياسية(.
a( الحقيقة والاغتراب في الحداثة الرأسمالية:
بقدرِ ما تُراكِمُ الحداثةُ الرأسماليةُ من السلطةِ والربحِ – رأسِ المالِ بالحدِّ الأقصى، فهي ارتباطاً بذلك تُعَبِّرُ أيضاً عن النظامِ الذي تَغتَرِبُ فيه الحقيقة. وكيفما اقتَضَت ولادتُها كنظامٍ حروبَ الحقيقةِ الدمويةَ جداً، فاستمرارُها أيضاً جَلَبَ معه أعتى وأعظمَ الحروبِ التي شَهِدَها التاريخ. أي أنّ حروبَ النظامِ ليستَ مجردَ حروبٍ لأجلِ السلطةِ والاستغلالِ فقط، بل هي حروبُ الحقيقةِ الضاريةُ أيضاً في الوقتِ عينِه. فالحداثةُ الرأسمالية، التي تُعتَبَرُ الامتدادَ الكونيَّ الأرقى لِنُظُمِ المدنية، تتحققُ تناسُباً مع مدى سحقِها وتحريفِها وتعتيمِها للمعنى الاجتماعيِّ وحقيقتِه.
وبقدرِ ما يتعاظمُ الربحُ والسلطةُ داخلَ النظام، يتصاغَرُ حَيِّزُ حقيقةِ الحياةِ الاجتماعيةِ بالمِثل، ويتضاعفُ فقدانُ المعنى إلى حدٍّ كبير. فالحياةُ الاجتماعيةُ لا تَغدو ضحيةَ جشعِ السلطةِ والربحِ فحسب، بل وتَحيا اغتراباً ثقيلَ الوطأةِ في كافةِ أشكالِ التعبيرِ عن الحقيقة. المجتمعُ هنا وجهاً لوجهٍ أمام سياقِ تصفيةٍ بكلِّ معنى الكلمة، سواءً كمعنى أم كحقيقة. إذ تُوضَعُ حقائقُ السلطةِ ورأسِ المالِ محلَّ كافةِ حقائقِ المجتمع.
عندما قامت الرأسمالية، التي هي الدعامةُ الأولى للحداثة، بانتهازِ الفرصةِ في التحوُّلِ بِحَدِّ ذاتِها إلى نظام؛ كانت قد بَدَأَت عَمَلَها بتصفيةِ المجتمعياتِ الأوليةَ لِما قبلَ التاريخِ وما بعدَه.
فقبل كلِّ شيء، وتحت شعار «صيد النساء المشعوذات ،» كانت قد حَرَقَت بلا هوادةٍ أو رحمة قوةَ مجتمعيةِ المرأةِ الساعيةِ للبقاءِ متماسكةً. يستحيلُ التفكير بصيدِ النساءِ المشعوذاتِ مستقلاً عن رأسِ المال. فمشاهدُ الحرقِ هذه قد فادَت إلى آخرِ درجةٍ في إنشاءِ الرأسماليةِ لهيمنتِها على المرأةِ التي تَحيا أعمقِ درجاتِ العبودية. وكونُ المرأةُ في خدمةِ النظامِ الراهنِ بأشدِّ حالاتِها بغاءً وفحوشاً، إنما يتأتى من أواصرِها الوثيقةِ مع عملياتِ الحرقِ تلك، التي مورِسَت في مرحلةِ انطلاقةِ الهيمنةِ الرأسمالية. ذلك أنّ صدماتِ الحرقِ المُرَوِّعةَ أَقحَمَت المرأةَ في أوروبا في خدمةِ الرجلِ بلا حدود.
وبَعدَ المرأةِ قام النظامُ بهدمِ مجتمعيةِ الزراعةِ – القريةِ أيضاً دون رحمة. إذ كان لا مَهربَ من استهدافِ مجتمعيةِ الزراعةِ – القرية، نظراً لاستحالةِ تحقيقِ السلطةِ والربحِ الأعظميَّين، ما دام الجانبُ الكوموناليُّ الديمقراطيُّ صامداً متماسكاً.
وستتزايدُ فرصةُ النظامِ في تحقيقِ الانطلاقة، تناسُباً مع مدى تحقيقِ تصفيةِ هذه المجتمعيات، التي هي أرضيةُ معنى وحقيقةِ مقاومةِ الإنسانِ وأفراحِه وأتراحه على مدارِ عشراتِ الآلافِ من السنين. وجميعُ الممارساتِ العمليةِ المتصاعدةِ في أوروبا والعالَمِ خلال القرنِ السادسِ عشر وما بَعده، تؤكدُ صحةَ هذه الحقيقة. هذا وبالمقدورِ النظر ضمن هذا الإطارِ إلى الحربِ التي شَنَّها النظامُ تجاه الكنيسةِ التي تُعَبِّرُ – ولو بحدود – عن حقيقةِ مجتمعِ ما قبل الحداثة. فبالرغمِ من أنّ الكونيةَ المسيحيةَ بصفتِها تعبيراً عن المجتمعيةِ ولو بمنوالٍ تضليليٍّ في داخلِها، لها نصيبُها الملحوظُ في احتكارِ السلطةِ والاستغلالِ القديمِ دون أدنى شك؛ إلا أنها إحدى أهمِّ خنادقِ حمايةِ المجتمعِ واللَّوذِ عنه. لذا، كان محالٌ على الرأسماليةِ أنْ تُنجِزَ انطلاقتَها، دون شلِّ تأثيرِ هذا الخندقِ أيضاً. وما الحروبُ الدينيةُ الكبرى سوى إشادةٌ بهذه الحقيقة. أَلحَقَت الرأسماليةُ ضربةً مُميتةً أخرى بالحقيقةِ الاجتماعية، بشَرعَنَتِها للعبوديةِ الأكثر ترويضاً، والمسماةِ بالتحولِ البروليتاريّ. وأحدُ أفدحِ الأخطاءِ التي ارتَكَبَها كارل ماركس، هو سقوطُه في غفلةِ تقديمِ البروليتاريِّ كذاتٍ رئيسية، مع أنه في الواقعِ عضوٌ مفقودٌ في الحقيقة. ذلك أنّ البروليتاريَّ عبدٌ مُطَوَّر، ولا يُمكِنُ تَحَوُّلُه إلى ذاتٍ متمتعةٍ بالحقيقةِ بتاتاً، طالما يستمرُّ بوضعِه هذا. فالرأسماليةُ لا تَحُثُّ البروليتاريَّ على الاندفاعِ وراءَ إنجازِ أعمالِها، قبلَ أنْ تَقتلَ فيه كافةَ مزاياه الاجتماعيةِ الإنسانية. بل إنّ الجوهرَ الاجتماعيَّ الإنسانيَّ لدى عبدِ العصورِ القديمة، أكثرُ مما لدى البروليتاريِّ الذي هو عبدٌ معاصر. مع ذلك، ولأنه عبد، فهو لا يتمكنُ من انتزاعِ نصيبِه من الحقيقةِ إلا بنَيلِ حريتِه.
من هنا، فتعريفُ البروليتاريِّ بأنه ذاك الواقعُ الذي بقيَ عبداً والذي يتمتعُ بدرجةٍ من الحقيقةِ في آنٍ معاً، إنما هو تحريفٌ فظيعٌ في الماركسية. وتَكمُنُ هذه الحقيقةُ في أساسِ فشلِ الاشتراكيةِ المشيدة.
أما البورجوازيةُ التي صَعَّدَتها الرأسماليةُ كطبقةٍ اجتماعية، فهي بالذات الآفةُ الاجتماعيةُ التي تَمَزَّقَت الحقيقةُ على يَدِها. فمَلِكٌ – إلهٌ واحدٌ أدنى بكثير إلى الحقيقةِ من ألفِ بورجوازيّ. ذلك أنّ البورجوازيةَ تُشَكِّلُ الجزءَ المَريضَ والمَعلولَ من الطبيعةِ الاجتماعيةِ التي تَمَزَّقَت فيها الحقيقةُ والمعنى الاجتماعيُّ الذي تستندُ إليه وتُعَبِّرُ عنه إلى شِقَّين.
وكيفما تَقومُ الحداثةُ بِشَلِّ الحقيقةِ الاجتماعيةِ برمتِها متجسدةً في هذه الطبقة، فهي تُصَيِّرُ السلطةَ ورأسَ المالِ وحشاً كاسراً )لوياثاناً(، كَونَهما يَفرضان الاغتراب.
أما الدولةُ القومية، التي هي ثاني دعامةٍ للحداثة، فبالمستطاعِ تعريفها أيضاً بأنها القوةُ الناخرةُ للحقيقةِ بما لا نظيرَ له في التاريخ. إذ ما مِن مَرَضٍ اجتماعيٍّ تَمَيَّزَ بالقدرةِ على تَنميطِ المجتمعيةِ وبَترِها من حياتِيتِها، بقدرِ ما هي عليه الدولةُ القوميةُ تحت اسمِ الهندسةِ الاجتماعية )ديميورغ = إله العمار(. في حين أنّ نَحْتَ ونَخْرَ الحداثةِ لفوارقِ الحياةِ الاجتماعيةِ الأكثر قداسةً، وتصغيرُها إياها إلى أدنى حد )رغمَ كون الحياة = التباين( تحت رداءِ التقدمية )الشكل العصريّ لعقيدةِ القيامةِ الإلهية(، وإنتاجُها البنى الواحدية؛ إنما هو الفاشيةُ بِحَدِّ ذاتِها. فالفاشيةُ مَرَضٌ اجتماعيٌّ يَظهرُ للوسطِ في المكانِ الذي تزولُ فيه الحقيقةُ الاجتماعية. وهي لا تتوالدُ البتةَ دون وجودِ احتكاريةِ سلطةِ ورأسِ مالِ الدولةِ القومية. كما أنّ المصطلحاتِ التي تسعى الدولةُ القوميةُ إلى تقديسِها، من قبيلِ: الحدود، الوطن، الأمة، العَلَم، النشيد الوطنيّ والمواطِن؛ مرتبطةٌ بخيانةِ القدسيةِ الاجتماعيةِ الحقيقية. ذلك أنّ الإنشاءاتِ الواحديةِ للوطنِ والأمةِ والمواطن، غيرُ ممكنةٍ إلا بتمزيقِ الإنسانيةِ المُعاشةِ طيلةَ كافةِ العصور، وتقطيعِها كما القَصّاب. وفي هذه الحالة، لن يَكُونَ الابتعادُ والاغترابُ عن الحقيقةِ الاجتماعيةِ فحسب موضوعَ الحديث، بل ونَفاذُ المجتمعِ بِذاتِه أيضاً. تتعرضُ كلُّ ذَرَّةٍ في الحقائقِ الاجتماعيةِ للاغتصابِ والاحتلالِ والإنكارِ في وجهِ ما تحتويه الدولةُ القوميةُ من إكثارٍ للسلطةِ الدينَوِيّةِوالقومويةِوالجنسويةِو »العل موية ». وشروعُ بعضِ الفلاسفة، وعلى رأسِهم نيتشه وفوكو وأدورنو، بإقامةِ القيامةِ باسمِ الحقيقة، وتصريحاتُهم بشأنِ كونِ الفردِ في الحداثةِ إنساناً مَخصيّاً ومُجَرَّداً من المجتمعية؛ إنما يشرحُ هذا الواقع.
الحقيقةُ الظاهرةُ للعَيانِ بنحوٍ تامٍّ هي أنّ الصناعويةَ، التي هي ثالثُ دعامةٍ للحداثة، تعني إبادةَ الحياةِ الأيكولوجية. إنها لا تعني إبادةَ البيئةِ الأيكولوجيةِ فقط، بل وإبادةَ الحقيقةِ التي لا يُمكِنُ للمجتمعيةِ أنْ تتواجدَ إلا بها أيضاً. والمجتمعُ الذي تُدَمَّرُ بيئتَه يومياً هو مجتمعٌ يُضَيِّعُ حياتَه جزءاً فجزءاً، ويُطعِمُها للوحش. الصناعويةُ شريكةٌ في جُرمِ الرأسماليةِ والدولةِ القوميةِ بشأنِ تصفيتِها لمجتمعيةِ الإنسانِ المُنشَأةِ بمقاومةٍ طالت ملايين السنين، والقضاءِ عليها في غضونِ فترةٍ بينيةٍ وجيزةٍ بحيث يمكن اعتبارَها مجردَ لحظةٍ فقط إزاء تلك المدةِ الطويلةِ فعلاً. كما أنّ وقاحةَ بسطِ وَرَمٍ سرطانيٍّ على أنه المجتمعُ الأكثر تَقَدُّميةً تحت اسمِ المجتمعِ الصناعيّ، تُوَضِّحُ بجلاءٍ ساطعٍ ماهيةَ الحَدَثِ المَرَضِيِّ الذي تُعَبِّرُ عنه الصناعوية. ما مِن حربٍ مارست الجناياتِ والمجازرَ وصَدَّعَت المجتمعيةَ وحَكَمَت عليها بالمَرَض، بقدرِ ما هي الجناياتُ الاجتماعيةُ المُطَبَّقةُ باسمِ المجتمعِ الصناعيّ )بدعمٍ من الرأسماليةِ والدولةِ القومية(.
يَلُوحُ فيما يَلوحُ أنّ الأنبياءَ، الذين أَضفَوا معانيَ عظيمةً على مصطلحَي القيامةِ والمحشر، ربما رَمَوا بهذَين المصطلحَين إلى شرحِ يومِ الآخِرةِ الذي يقضي فيه ذاك الوحشُ الثلاثيُّ الأرجلِ، والمسمى بالحداثة، على معنى وحقيقةِ مجتمعيةِ الإنسان!
السببُ الأصلُ في عملي الرامي إلى عَرضي بالخطوطِ العامةِ للإطارِ الاصطلاحيِّ والنظريِّ اللازمِ لإعادةِ تعريفِ الحياةِ الاجتماعيةِ في الشرقِ الأوسط، إنما هو بغرضِ صياغةِ جوابٍ على سؤالِ «ما هي الحياةُ الاجتماعية؟ .» ثمة سلوكٌ غريبٌ يُبديه الإنسانُ إزاءَ حياتِه الذاتية، إذ يَعتَقِدُ بالعيشِ على مسارٍ أو في دوامةٍ تتجه من الأزلِ نحو الأبد. إنه زيغٌ وضلالٌ جذريّ. فكَونُ الإنسانُ النوعَ الأكثر انخداعاً، رغمَ امتلاكِه فرصةَ الحياةِ الأكثر معنىً وقيمةً، هو ليس مجردَ لعبةٍ من ألاعيبِ الطبيعة، بل وأعتقدُ أنها لعبةٌ تُبرِزُ نفسَها في المجتمعِ التحكُّميِّ على الأغلب. إذ ما مِن كائنٍ حيٍّ ضالٍّ وخَطّاءٍ بقدرِ ما هو الإنسان. بقدرِ ما وجدتُ ذلك غريباً للغاية، فهو أيضاً لعبةٌ مثيرةٌ بالنسبةِ لي.
تعريفُ الحياةِ الاجتماعيةِ بمنوالٍ سليم، والعيشُ بهذا الوعيِ يُعادِلُ أهميةَ الحياةِ نفسِها. وربما أنّ مَرامَ الحياةِ هو التعريفُ السليمُ لها. عليَّ التنويهَ فوراً إلى أنّ الحياةَ عموماً وحياةَ الإنسانِ خصوصاً هي ثمرةُ عمارٍ وإنشاءٍ خاصَّين بها.
وتحديدُ ما دَخَلَ طوايا هذا الإنشاءِ هو مَهَمَّةُ علمِ الاجتماعِ الأساسية. بوسعي الإشارة إلى الفراشةِ التي تحيا ثلاثةَ شهورٍ فقط، كمثالٍ يهدفُ إلى فهمٍ أفضل للنقطةِ التي أسعى إلى تبيانِها. فبُنيتُها الداخليةُ وأيكولوجيةُ البيئةِ المحيطةِ قد حَدَّدَتا حياةَ الفراشةِ لثلاثةِ أشهر. وستَكُونُ تلك الشهورُ الثلاثةُ فترةَ حياةِ الفراشة، في حالِ عدمِ ذهابِها ضحيةَ حادثٍ ما. وقضيةُ الأزلِ الذي لا قبلَ له والأبدِ الذي لا بَعدَ له محدودةٌ بهذه الأشهرِ الثلاثةِ بالنسبةِ إليها. ولا يَخطرُ ببالِها قطعياً جعلَ ذلك مُشكِلة.
كما ويستحيلُ أنْ يَكُونَ لها مطلبٌ كهذا. وحتى لو كان، فهي لا تُصَيِّرُه معضلةً جادة. وكمثالٍ داخلَ مثال: كلكامش. إني أُقَدِّمُ كلكامش كمثالٍ سلبيّ، وسأُوَضِّحُ ذلك. فكلُّ كائنٍ في الطبيعةِ والكونِ يعيش في جوهره مُلتَزِماً ب »قاعدة الفراشة ». ولا تُخالِفُ تلك القاعدةَ إلا حياةُ الإنسان، وتَتَّخِذُ حالةً إشكاليةً قصوى.
يُطَوِّرُ النوعُ البشريُّ الكثيرَ من المساعي الجنونيةِ من أجلِ عُمرِه، بدءاً بالشروعِ في البحثِ عن الأبديِّ – الأزليّ، وصولاً إلى التفكيرِ بالجنةِ في السماواتِ وبجهنم فيما تحت الأرض. ويُبدي طيشاً جنونياً، بدءاً من تقديمِ نفسِه في هيئةِ إلهةٍ – ملوكٍ وحتى الإبقاءِ عليها في أَحَطِّ أشكالِ العبودية. كما أنّ السلوكياتِ التي لا تَعرفُ ضوابطاً أو قواعدَ هي خاصةٌ بالإنسانِ فحسب، ابتداءاً بالعيشِ يومياً في شذوذٍ جنسيٍّ وحتى الإبقاءِ على نفسِه في حالةِ جنسٍ مُخَنَّث. والموقفُ المبتدئُ بممارسةِ الإباداتِ العرقيةِ الممنهجةِ حتى يَصِلَ حدَّ الهَرَعِ وراءَ إكسيرِ الحياةِ الخالدة؛ إنما يَسري ويَستَشري في هيئةِ أمراضٍ لا يُعثَرُ عليها في أنواعِ الكائناتِ الحيةِ الأخرى بتاتاً. من هنا، ثمة حاجةٌ لتعريفِ الحياة بالنسبةِ للإنسان، في سبيلِ فهمِ وإعاقةِ هذا الطيشِ الذي لا يَعرِفُ حدوداً. فتعريفٌ صحيحٌ قد يَكُونُ أولَ خطوةٍ على دربِ الحياةِ السليمة.
كنتُ قد عَمِلتُ على رسمِ إطارٍ اصطلاحيٍّ ونظريٍّ في المَدخَلِ المُطَوَّلِ لهذا المُجَلَّدِ بُغيةَ تنويرِ هذا الموضوعِ نوعاً ما. وعلمُ اجتماعٍ طَموحٌ وعازِم، إنما هو مُكَلَّفٌ دون أدنى شك بمَهَمَّةِ رسمِ هذا الإطارِ وإحيائِه.
وانطلاقاً من هذه الدوافع، تأتي إعادةُ تعريفِ وإنشاءِ )تنظيم( علمِ الاجتماعِ في صدارةِ أولوياتِ المهامّ، إذ يُعَدُّ ضرورةً لا استغناءَ عنها أثناءَ الانعكافِ على تحليلِ أزمةِ الحداثةِ الرأسماليةِ البنيويةِ واحتمالاتِ النفاذِ منها.
الشرطُ الذي لا بُدَّ منه في حياةِ الإنسانِ هو مجتمعيتُه. السببُ الأولُ الكامنُ وراءَ تَوَقُّفي بإلحاحٍ وعزمٍ لا يَلين عند هذا الموضوع، هو عدمُ شروعِ علمِ الاجتماعِ بَعدُ في صياغةِ تعريفٍ سليمٍ لها. وكذلك عجزُه عن تحقيقِ صياغةٍ علميةٍ قَيِّمَةٍ من حيثُ المعنى والحقيقة، حتى لو وُجِدَت تجاربُ الشروعِ بذلك، وعجزُه أيضاً عن النجاحِ في إنشائِها التنظيميِّ وجِعلِه مجتمعياً. السببُ الثاني والأهمُّ هو قيامُ ليبراليةِ الحداثةِ الرأسماليةِ بإنشاءِ الفردِ والفرديةِ وتصييرِهما وحشاً مُغالى فيه بحيث لا تَسَعُهما السمواتُ ولا الأرض، وذلك بالتأسيسِ على أرضيةٍ لااجتماعية. فالفرديةُ بحالتِها الراهنةِ ليست مستحيلةَ الاستمرارِ فحسب، بل ولا يُطاقُ عيشُها أيضاً. إذ لَم يَعُد المجتمعُ ولا كوكبُنا قادرَين على تَحَمُّلِ الحياةِ الفرديةِ المنفتحةِ أمامَ شتى أشكالِ الشذوذِ بما لا يُشاهَدُ في أيِّ نوعٍ آخَر من الكائناتِ الحية. لقد بُلِغَ بهذا النمطِ الفرديِّ حالةَ شذوذٍ لدرجةٍ لا يَكلُّ فيها ولا يَملُّ من قتلِ الإنسانِ وممارسةِ الجنسِ والرياضةِ والفنّ، ومن تأمينِ الربحِ وممارسةِ التعذيبِ على مدارِ الساعة. واضحٌ بما لا تَشُوبُه شائبةٌ أنّ نهايةَ هذه الفرديةِ هي أمراضٌ من نوعِ السرطانِ والأيدز. علماً بأنها تُوَّلِدُّها بسرعةٍ بارزة. لذا، فالأيامُ المسماةُ بالمحشر، والتي نَبَّأَ بها الأنبياءُ في غابرِ الأزمان، إنما تُعَبِّرُ عن مرحلةِ الفرديةِ هذه.
إذن، والحالُ هذه، فإنشاءُ علمِ الاجتماعِ المتمحورِ حولَ تعريفِ الحياةِ الاجتماعيةِ كمَهَمَّةٍ أولى، وتوحيدُها مع سدِّ الطريقِ أمامَ الحياةِ الفرديةِ والنظامِ الكامنِ وراءَها كمَهَمَّةٍ ثانية؛ إنما هو شرطٌ لا ملاذَ منه للخلاص، وضرورةٌ من ضروراتِ احترامِ وتقديرِ الحياة.
لا ريب في أنّ المجتمعيةَ ترتكزُ إلى تنظيمِ وإنشاءِ الحياةِ الشخصية. إذ ما مِن مجتمعٍ منقطعٍ عن الفرد. بإمكاننا تشبيه مقارنةِ الفردِ مع المجتمعِ بمقارنةِ عُنصُرَي الهيدروجين واليورانيوم. فذَرَّةُ الهيدروجين بُنيةٌ بسيطةٌ عندما تَكُونُ بمفردِها.
ورغمَ وجودِ انتشارِ الطاقةِ والجُسَيماتِ في بعضِ أنواعِها، إلا أنّ ذلك محدودٌ للغاية. أما في اليورانيوم، فالمُكَوِّناتُ الضخمةُ التعدادِ والمُؤَلَّفةُ من الذّرّاتِ عينِها ضمن تركيبةٍ جديدة، تَضخُّ الطاقةَ وتَنشرُ الجُسَيماتِ باستمرار. علماً أنّ القنبلةَ الذّرّيّةَ تنبعُ من خاصيةِ اليورانيوم تلك. لقد اندمجَ عددٌ جمٌّ من الأفرادِ ضمن تركيبةٍ جديدةٍ في المجتمعِ أيضاً. لكنّ الطاقةَ والجُسَيماتِ التي يَنشرونَها )المجموعات القديمة والجديدة( تَكُونُ بمعايير لا تَقبَلُ المقارنةَ نِسبةً إلى الإنسانِ الفرديّ )الذّرّة التي لا وظيفةَ لها سوى إحياء ذاتِها(.
عندما يَخسرُ الفردُ مجتمعيتَه، فحتى لو عاشَ فيزيائياً، فهو إما خائنٌ وسافل، أو أذعرٌ شَرود. وهو فانٍ وميتٌ في كِلا المعنَيَين.
من الأهميةِ بمكان تعريف مجتمعيةِ الشرقِ الأوسطِ كبنيةٍ كونية. لدى تحقيقِ مجموعاتِ القنصِ والقطفِ الجوّالةِ العبورَ نحو مجتمعيةِ الزراعةِ – القريةِ حصيلةَ خبرةٍ استنبَطَتها من العيشِ مدى طويلاً على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس، إنما كانت تُنشِئُ بنيةً لحياةٍ كونية، ولو عن غيرِ إدراكٍ أو وعي. كنتُ جَهِدتُ في الفصولِ المعنيةِ لتحليلِ هذه البنيةِ وعصرِ المدنيةِ المركزيةِ المُشَيَّدِ عليها. وبالإضافةِ إلى ذلك، فالتركيزُ هنا على معنى هذه البنية، وإظهارُ قيمتِها في الحقيقةِ سيُقَدِّمُ مساهمةً ملحوظة.
هذه المجتمعيةُ الجديدةُ الساعيةُ لتنظيمِ ذاتِها على حوافِّ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس منذ بدءِ انقضاءِ العصرِ الجليديِّ الأخيرِ قبلَ عشرين ألفِ سنة، كانت في حالةِ عبورٍ صوبَ الزراعةِ بالاستفادةِ من أنواعِ النباتاتِ الوفيرة، وصوبَ تربيةِ الحيوانِ بالاستفادةِ من الحيواناتِ الصالحةِ للتدجين. وقد انتَهَت هذه المرحلةُ الانتقاليةُ إلى الحياةِ القروية المستقرةِ قبل عشرةِ آلافِ سنة. ونشاطاتُ الزرعِ وتربيةِ الحيوانِ أَبرَزَت مجتمعيةَ المُزارِعِ والراعي إلى المقدمة.
هكذا تَبَدَّت حياةٌ أَشبَهُ بالحلمِ والخيالِ بالنسبةِ للبشرية. وأساسُ جميعِ الأعيادِ والمراسيمِ، التي لا تَبرَحُ آثارُها مستمرةً حتى الآن، ينبثقُ من الغِبطةِ والسرورِ بهذه الحياةِ الجديدةِ التي كالأحلام. حيث كان حَصَلَ العبورُ من مجتمعِ القحطِ والشحِّ نحو مجتمعِ الوفرةِ والغنى. وقد تمَّ عيشُ هذا الشكلِ طيلةَ عشرةِ آلافِ سنة على وجهِ التقريب، دون مشاهدةِ أيِّ نمطٍ آخر من المجتمعات. فانتشرَ شكلُ الحياةِ هذا إلى كافةِ أرجاءِ المعمورة. وبالرغمِ من الآراءِ القائلةِ بتعددِ المراكز، إلا أنّ كونَ هذا التمركزِ الأولِ للحياةِ الجديدةِ البارزةِ يتميزُ بأهميةٍ مُعَيِّنةٍ قد أُثبِتَ ودُعِمَ ببراهين قاطعةٍ أكثر.
هذا المجتمعُ الذي تصاعَدَ متمحوراً حول المرأةِ – الأمّ هامٌّ من حيثُ إنشائِه مجتمعَ الأقاربِ الأولِ أيضاً. تُحَدَّدُ القَرابَةُ وفقَ القُربِ من المرأةِ – الأم.
ويتمُّ الانتقالُ من الكلانِ البدائيةِ وبلوغُ أولِ مجتمعٍ قَبَلِيٍّعبر هذه القَرابة. ولا ينفكُّ أَثَرُه قائماً كشكلِ مجتمعٍ ذي هويةٍ أصليةٍ أساسُها القَبَلِيُّ وطيد. كما أنّ مؤسساتِ اللغةِ والدينِ والميثولوجيا والفنِّ والحِكمةِ والعلمِ الأصليةَ، التي تَبلغُ آثارُها يومَنا الحاليّ، قد نَثَرَت أولى أشعتِها في ثنايا هذا المجتمع. إلى جانبِ أنّ أدواتِ النسيج، الصحون الفخارية، زراعة الأرض، الرحى اليدوية، وبناءِ البيوتِ أيضاً مَدينةٌ بانطلاقاتِها الأصليةِ لمجتمعِ تلك الحقبة. هذا والارتباطُ المقدسُ بالطبيعةِ وتكوينُ أوطانٍ صغرى فيها من ثمارِ هذا المجتمعِ أيضاً. من هنا، بالمقدورِ القول أنّ 90 % من «أولى » اكتشافاتِ الحياةِ الاجتماعيةِ تنحدرُ من مجتمعِ تلك الحقبة.
إنّ المجتمعيةَ المستمرةَ مدى عشراتِ الألوفِ من السنين بمفردِها، قد شَكَّلَت القوالبَ العقليةَ والروحيةَ الأوليةَ للبشرية، وقِيَمَها الثقافيةَ الماديةَ والمعنوية. هذا المجتمعُ المتكونُ من القريةِ والزراعةِ والفِلاحةِ والرَّعيِ والقبيلةِ والقوالبِ الذهنيةِ والروحيةِ المستندةِ إلى المرأةِ الأمِّ ومن بعضِ تقنياتِ الإنتاج، قد يَكُونُ مجتمعاً بسيطاً، لكنّه رَصَفَ أرضيةَ حياةٍ جذريةٍ بالنسبةِ للبشريةِ بنجاحٍ مظفر. وكلُّ ما أُنجِزَ فيما بعد، إنما تَطَوَّر اعتماداً على هذا المجتمع. وما مِن تطوُّرٍ معنيٍّ بالإنسانِ يَمتَلِكُ مهارةَ التحققِ والحصولِ رغماً عن أنفِ هذا المجتمع. لا أقولُ باستحالةِ حصولِ أيِّ تطوُّرٍ آخَر. لكن، وحتى لو حَصَل، فهو يتطورُ ارتباطاً بهذا المجتمعِ وكفرعٍ منه. فالمجتمعاتُ موجوداتٌ تاريخية، ويستحيلُ أنْ تتواجدَ خارجَ إطارِ تاريخانيتِها. من هنا، فأسلوبُ العلمِ التابعِ للحداثةِ الرأسمالية، والذي يَضَعُ التاريخَ جانباً، ويعتمدُ على التحليلِ فقط؛ إنما هو مسؤولٌ عن التقدمِ المنحرفِ وذي القيمةِ البخسةِ للحقيقةِ بشأنِ كافةِ العلوم، وبالأخصِّ علمِ الاجتماع. أي أنّ التحليلَ والموضوعانيةَالشيئانيةَ عيبان أساسيان في العلمِ الأوروبيِّ المحور، كونَهما الميتافيزيقيا الأسوأَ على الإطلاق. ما دامت المجتمعاتُ موجوداتٍ تاريخية، فمعانيها حينئذٍ تاريخيةٌ أيضاً. أما المعنى، فهو جوهرُ الحياةِ الاجتماعية. كما يُمكِنُ تعريفه على أنه هدفُ الحياةِ الاجتماعيةِ وروحِها وذهنِها. بينما الحقيقةُ هي البلوغُ بالمعنى الذي شَكَّلَه وجودُ هذا المجتمعِ التاريخيِّ إلى اللغةِ والتعبيرِ والشكلِ ميثولوجياً ودينياً وفنياً وحِكمَةً وعلمياً.
لا ينفكُّ المجتمعُ البشريُّ يحيا الآنَ أيضاً هذا المعنى تأسيساً على أساليبِ الحقيقةِ عينِها، رغمَ مرورِه بتخريباتٍ ثقيلةِ الوطأة. وشكلُ الحياةِ هذا برهانٌ آخَر على تاريخانيةِ المجتمع. ما من شكٍّ في أنّ شكلَ الحياةِ الاجتماعيةِ هذا لَم يَبقَ على حالِه، بل لَطالَما حَمَلَ تطوُّراً محدوداً بين أحشائِه على الصعيدِ الدياليكتيكيّ.
ولكنه أَحيا ذاتَه حتى يومنا الراهنِ كشكلٍ أساسيّ، رغمَ معاناتِه الإرهاقَ ومرورِه بالتصفيةِ والتخريبات.
أولُ تَصَدُّعٍ كبيرٍ في شكلِ حياةِ هذا المجتمعِ التاريخيِّ قد تَحَقَّقَ مع الهرمية. حيث استقرت الهرميةُ في أحضانِ المجتمعِ كعنصرٍ ذاعَ صِيتُ وجودِه ابتداءاً من أعوامِ 5000 ق.م على وجهِ التقريب، مثلما عُرِّفَت سابقاً. فالهرميةُ بالذات تُعَبِّرُ عن أولِ مجموعةٍ نُخبوية. ذلك أنّ الهرميةَ بوصفِها ثالوثَ الراهبِ + الحاكمِ + العسكريّ، تَعملُ على التأسُّسِ مكانَ اقتدارِ المرأةِ – الأم. أولُ اغترابٍ جادٍّ في ثنايا الحياةِ الاجتماعيةِ يَبدأُ مع سلطةِ هذه النخبة. هذا وتَعُودُ بُنى العائلةِ والسلالةِ النخبويةِ بمصادرِها إلى الهرميةِ أيضاً.
فبينما تتشكلُ السلالاتيةُ كدولةٍ من جانب، فهي من الجانبِ الآخَرِ تنتقلُ بالحياةِ الاجتماعيةِ إلى معنى وشكلٍ مختلفٍ بصفتِها أُسْرَويّة. موضوعُ الحديثِ هنا هو تَحَوُّلٌ جذريّ.
يتجذرُ هذا التصدُّعُ والتحوُّلُ على صعيدِ المعنى والشكلِ أكثرَ فأكثر، مع بدءِ ظهورِ المدينةِ والتفاوُت الطبقيِّ والتدوُّلِ اعتباراً من أعوامِ 3500 ق.م. يؤدي مجتمعُ المدنيةِ دوراً رئيسياً في ذلك. فاحتكاراتُ المدنيةِ )الدولة، مزارع العبيد، التجارة واحتكارات الربا( المتأسسةُ على الفوائضِ الاجتماعية، قد جَرَحَت الحياةَ من الصميم. فلدى تَرَبُّعِ عناصرِ فرضِ الاغترابِ التي لَم تَشهَدها قَبلاً على صدرِ المجتمع، ظَهَرَت للعيانِ حَيَواتٌ خاصةٌ بالشرائحِ الفوقيةِ والسفلية، سادَها الفسادُ والتفسُّخُ معنىً وشكلاً، وتمزَّقَت كُلِّيّاتِيَّتُها تدريجياً. والوجودُ المسمى بنمطِ الحياةِ المدنيةِ يُعبِّرُ عن هذا النمط. كما أنّ المدنيةَ التي أَخَذَت أبعادَها في الساحةِ المركزيةِ نفسِها )الهلال الخصيب( ضمن المجتمعِ الشرقِ الأوسطيّ، تتميزُ بمعنى مركزيٍّ أيضاً. إنها كونية. وهي شرقُ أوسطيةٍ تاريخاً ومكاناً، مهما كانت عَمَّقَت الاغترابَ في طوايا الحياةِ الاجتماعية.
أي أنّ حياةَ المدنيةِ المستقرةَ كطبقةٍ عُليا في الحياةِ الاجتماعيةِ ضمن الشرقِ الأوسط، تُعَبِّرُ عن سياقِ هيمنةٍ دامَت حوالي خمسةَ آلافِ سنة.
الهيمنةُ ليست عنصراً بسيطاً، حيث تسلَّلَت في جميعِ مساماتِ الحياةِ الاجتماعيةِ وأنسجتِها وأجهزتِها. وقد تمت موضعةُ المرأةِ كهويةٍ في الحضيضِ ضمن نمطِ الحياةِ هذا، ورُسِّخَت عبوديةُ الرجلِ عليها. ودارت المساعي لترتيبِ القبائلِ والعشائرِ الرَّحَّالةِ والمقاومةِ إلى جانبِ القرويين والحِرَفِيّين الكادحين، وبنائهم كطبقةٍ ثالثة. لكنّ هذه الشرائحَ أَثَّرَت في الطبقتَين الأولى والثانية، مُبقِيَةً على حياةِ المقاومةِ منتعشةً وحيويةً دوماً طيلةَ التاريخ. علاوةً على أنّ احتكاراتِ المدنيةَ لَم تَلجَأْ فقط إلى وسائلِ العنفِ المحض، بل واستخدَمَت أساليبَ التعبيرِ عن الحقيقةِ أساساً )الميثولوجيا، الدين، الحكمة، الفن، والعلوم(، راميةً بذلك إلى بسطِ شرعيتِها على أنها طبيعيةٌ في الحياةِ الاجتماعية، وإلى جعلِها خالدةً بلا نهاية. هكذا باتت تُخضِعُ كافةَ قوالبِ الحياةِ الاجتماعيةِ القديمةِ وأعيادِها ومراسيمِها وعباداتِها وترفيهاتِها المُسَلِّيَةِ للتفسيرِ تحت ظلِّ احتكاراتِها، فتَتَبَنَّاها تاركةً بصماتِها عليها.
لكنّ أقدمَ قوالبِ الحياةِ الاجتماعيةِ تستمرُّ بوجودِها ومعناها أساساً، وتُعَبِّرُ عن حقيقتِها، ولو بنحوٍ متجزِّئ. ورغمَ تحقيقِ مدنياتِ الهندِ والصينِ وأمريكا الجنوبيةِ تطوُّراً ملحوظاً في أماكنِها في عصرِ المدنية، إلا أنّ الدورَ الرئيسيَّ ظلَّ قائماً في نظامِ المدنيةِ المركزيةِ ذاتِ الأصولِ الشرقِ أوسطيةِ حتى عهدِ الحداثةِ الأوروبية.
أما نظامُ المدنيةِ المركزية، الذي حَقَّقَ انطلاقتَه الأخيرةَ تحت اسمِ الإسلام، فكما ذُكِرَ آنفاً، قد خسرَ هيمنتَه لصالحِ الحداثةِ الرأسماليةِ الأوروبيةِ في نهايةِ مطافٍ دامَ خمسةَ قرونٍ من محاولاتِ الأخيرةِ في أنْ تَحلَّ محلَّه. ما عاشَه مجتمعُ الشرقِ الأوسطِ مضموناً تحت اسمِ الإسلامِ هو تاريخُه القديم. فبينما استمرّت الهرميةُ والسلالاتيةُ والإمبراطوريةُ بوجودِها في عهدِ الإسلامِ باسمِ الخِلافةِ والإمارةِ والسَّلطَنة، فقد جَهِدَت العناصرُ الديمقراطيةُ المقاوِمةُ للاستمرارِ بوجودِها ومعانيها وحقائقِها كجماعاتٍ ومذاهب مختلفةٍ جداً )العَلَوِيّة، الشيعة، الخوارج، الإيزيدية، والشعوب والثقافات الموسوية والمسيحية(. ورغمَ كلِّ هذا التمايُزِ الشرائحيِّ والتجزُّؤ، إلا أنّ الواقعَ الساطعَ بجلاءٍ هو كينونةُ الجانبِ الكونيِّ والكُلِّيّاتِيِّ للحياةِ الاجتماعيةِ في الشرقِ الأوسط، ولكنْ بمنوالٍ واهِنٍ ومتجَزِّئٍ من حيث المعنى والحقيقة.
السؤالُ الأساسيُّ الواجبُ طرحه في هذه الحالة هو: لِماذا عَجِزَت الحداثةُ الرأسماليةُ عن إيجادِ فرصةِ التطورِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسط؟ جوابُ السؤالِ لن يَكُونَ على شاكلةِ عرقلةِ الدينِ لها، ولا تَخَلُّفِ وسائلِ الإنتاج، ولا نُقصانِ رأسِ المال. إذ من المعلومِ أنه كان متقدماً كثيراً على أوروبا في هذه الميادين. المرحلةُ المذكورةُ هي مرحلةُ ما بين القرنَين الثاني عشر والخامسِ عشر. إذ تتعرفُ أوروبا خلال هذَين القرنَين على ولادةِ المدائن. والتجارةُ والمالُ يُبديان التطورَ في الأسواقِ المفتوحةِ حديثاً. بينما كانت منطقةُ الشرقِ الأوسطِ تعيشُ مثل هذه التطوراتِ وبشكلٍ مستمرٍّ منذ ما يزيد على أربعةِ آلافِ عام. كما كانت الصناعةُ متقدمةً على أوروبا بِفراسخَ شاسعة. هذا وكانت تمتلكُ هيمنةَ المدنيةِ المركزيةِ أيضاً.
كل ذلك يُوَضِّحُ في حقيقةِ الأمرِ دوافعَ العجزِ عن الانتقالِ نحو النظامِ الرأسماليِّ أيضاً في المنطقة. فالشرقُ الأوسطُ يَثِقُ بنظامِه. وإنتاجُ فائضِ القيمةِ يكفي للقوى المهيمنة على المنطقة. كما وليس هناك قوى استراتيجيةٌ معاديةٌ جادةٌ ومُميتةٌ خارجياً أم داخلياً. والقوى الوافدةُ من الخارجِ كالمغولِ مثلاً، كانت تصهرُها في بوتقتِها بكلِّ سهولة.
لا يَبرَحُ الرأيُ الذي عَمِلتُ على تحليلِه في مستهلِّ المُجَلَّدِ محافظاً على سريانه، ألا وهو أنّ أسباباً استراتيجيةً أدت دوراً أساسياً في انطلاقةِ أوروبا. والرأسماليةُ نظامُ دفاعٍ وهجومٍ استراتيجيّ. إلا أنها وسيلةٌ ستَلجَأُ إليها احتكاراتُ السلطةِ ورأسِ المال، كونَها تَمُرُّ بأوضاعٍ جدِّ حرجة، وتَشهَدُ قضيةَ الوجودِ – العدم. فقضيةُ البقاءِ أو الفناءِ الاستراتيجيةُ التي عانَتها هولندا وإنكلترا، قد أَرغَمَتهما على خَيارِ الرأسمالية.
فإنكلترا المتصاعدةُ كقوةِ هيمنة، شَرَعَت بِحِراكِ استكشافِ الشرقِ الأوسطِ منذ القرنِ السادسِ عشر. وبالأصل، فنابليون والمدنُ الإيطاليةُ وعلى رأسِها البندقية، كانوا قد فَتَحوا الطريقَ جيداً من قبل. فضلاً عن أنّ رأسَ المالِ اليهوديّ، الذي يَعرِفُ الشرقَ الأوسطَ كَكَفِّ يدِه، كان يَهتمُّ استراتيجياً بالمنطقةِ منذ البداية، ويَدُلُّ أوروبا على الطريق. أي أنّ رأسَ المالِ اليهوديَّ كان متَخَصِّصاً ومُحتَرِفاً في معرفةِ الشرقِ الأوسط، ومُدرِكاً لاهتماماتِ كلٍّ من هولندا وإنكلترا والبلدانِ الأوروبيةِ الأخرى التي في المقدمة وكذلك أمريكا بالمنطقة. كما أنّ رأسَ المالِ عينَه كان الدليلَ والخبيرَ بنقلِ المعلوماتِ في الاستقامةِ المعاكسة، أي إلى أوروبا. إذ يتحركُ اليهودُ في هذا المضمارِ كمجتمعِ تُجّارٍ قَبَلِيٍّ خبيرٍ منذ أولِ خروجٍ لهم من أورفا ومصر ) 1600 – 1300 ق.م(.
السببُ الثاني في عجزِ الرأسماليةِ عن لعبِ دورٍ استراتيجيٍّ في الشرقِ الأوسط، هو فرضُ الهجرةِ على الوجودِ اليهوديِّ وعلى الشعوبِ المعتنقةِ للديانةِ المسيحيّةِ من أرمنٍ وآشوريّين وهيلينيّين، والذين تمّت عرقلةُ تَطَوُّرِهم تزامُناً مع صعودِ الإسلام. هذه الشعوب، التي فُرِضَت الجِزيةُ على أموالِها، بل وتَعرّضَت للنهبِ أحياناً، فإنّ عجزَها عن الدخولِ في مرحلةِ التَبَرجُزِ المدينيِّ كما حصلَ في أوروبا، قد تَمَخَّضَ عن نتائجَ جادةٍ ضارةٍ بالمنطقة. فعدمُ المرورِ بنهضةٍ باكرة، وإلحاقُ الضرباتِ بالثقافاتِ التي طَوَّروها قد تسبَّبا بالمِثلِ في تَقَحُّطِ المنطقةِ وتَصَحُّرِها. ذلك أنّ الإسلامَ كان بعيداً جداً عن المكانةِ التي تُخَوِّلُه لتمثيلِ ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بمفردِه. بينما المسيحيون والموسويون بوصفِهم الشعوبَ الأرقى ثقافةً، كانوا يمتلكون مخزوناً مادياً أيضاً إلى جانبِ كونِهم ذاكرةَ المنطقة.
وقد تأَسَّسَ الإسلامُ على هذه القيمِ إلى حدٍّ ما، حيث استولى على تلك القِيَم، ولكنه عجزَ عن تطويرها. أما في أوروبا، فالثقافتان المسيحيةُ واليهوديةُ المكتَسِبتان للقوة، كانتا تتصدران لائحةَ العناصرِ الراصِفةِ لِلَّبَناتِ الأساسيةِ في تَقَدُّمِ المدنيةِ الأوروبية.
ولو أنهما كانتا رئيسيَّتَين في الشرقِ الأوسط، لَكانت فرصةُ ولادةِ المدنيةِ الأوروبيةِ كقوةِ هيمنةٍ قليلةً جداً لدرجةِ العدم. واقتفاءُ أَثَرِ هذا الواقعِ في الإمبراطوريةِ العثمانيةِ أمرٌ مفيدٌ إلى أبعدِ حد.
على ضوءِ هذا الشرحِ تُدرَكُ بنحوٍ أفضل أسبابُ عجزِ أوروبا عن نيلِ النتيجةِ المرجوةِ من الحروبِ الصليبيةِ التي شَنَّتها فيما بين القرنَين الحادي عشر والرابعِ عشر. وانطلاقاً من الأسبابِ ذاتِها، تُدرَك دوافعُ نجاحِها لدى تَوَجُّهِها صوبَ الشرقِ الأوسطِ اعتماداً على الدروسِ التي استَنبَطَتها والقِيَمِ التي حَمَلَتها معها من تلك الحروب، وعلى انطلاقاتِها الاستراتيجيةِ ذاتِ الخلفيةِ الرأسماليةِ فيما بين القرنَين السادسِ عشر والتاسعِ عشر. لقد حُلِّلَ الموضوعُ كفايةً في الفصولِ المعنية. فالمهمُّ بالنسبةِ للشرقِ الأوسطِ هو المستجداتُ والأحداثُ التي أَفضَت إليها الحداثةُ الرأسماليةُ المُبادِرةُ إلى الهجومِ الاستراتيجيِّ ابتداءاً من القرنِ التاسعِ عشر. بل والأهمُّ هو الأزماتُ والانهداماتُ المتجذرةُ في بُنيتِه الاجتماعية.
لقد شَدَّدتُ مِراراً على أنّ المدنيةَ كوجودٍ تُعَدُّ مصدرَ القضايا. أما تحديدُ كيفيةِ سقوطِ المدنيةِ من القضيةِ نحو الأزمةِ على صعيدِ البنية، فيتسمُ بالأهميةِ من حيث تحليلِ تطوراتِها. فالمدنياتُ بوصفِها بُنى طويلةَ المدى، تُبَدِّلُ الأماكنَ والهيمناتِ مع سقوطِها في الأزمات. من هنا، بالمقدور الحديث عن ولوجِ مدنيةِ الشرقِ الأوسطِ أزمةً بنيويةً اعتباراً من القرنِ الثالثِ عشر، نظراً لعجزِها عن تحقيقِ قفزةٍ صوبَ الحداثةِ الرأسماليةِ لدى دخولِها دوامتَها الأخيرةَ مع الحضارةِ الإسلامية )لأسبابٍ داخليةٍ وخارجيةٍ متعددةِ الجوانب(. والإمبراطوريةُ العثمانيةُ لا معنى لها سوى تجذير الأزمةِ البنيوية. أما التوسعُ الذي حقَّقَته الاستراتيجيةُ الرأسماليةُ في قرونِ نشوئِها، فما كان له أنْ يُحرزَ النجاحَ بسببِ بُنيتِها المتأزمة. علماً أنّ تحامُلَ الرأسماليةِ وتَوَجُّهَها صوبَ المنطقةِ مع حلولِ القرنِ التاسعِ عشر، قد كشفَ عن معناها هذا بما يَزيدُ عن الحد. يُعَدُّ القرنان التاسع عشر والعشرون قرنَي غزوِ مجتمعِ الشرقِ الأوسطِ على يدِ الاستراتيجيا الرأسمالية. هذه المرحلةُ التي اتَّجَهَت فيها الحداثةُ الرأسماليةُ نحو المنطقةِ بفُرسانِ المحشرِ الثلاث )الرأسمالية، الدولة القومية، والصناعوية(، إنما هي مرحلةُ تَعَمُّقِ الأزمةِ والانهيار. فالحياةُ التاريخيةُ والاجتماعيةُ المُعَمِّرةُ مدى آلافِ السنين، تُحاصَرُ تماماً مع تَقَوُّضِ بُنيةِ مدنيةِ الخمسةِ آلافِ سنة المنبثقةِ من أحشائِها. ذلك أنّ تحالُفَ بقايا مدنيتِها مع الحداثةِ الرأسمالية، قد وَطَّدَ أزمةَ الحياةِ الاجتماعيةِ في الشرقِ الأوسطِ باستمرار. ما أضفى هذه الماهيةَ على الأزمةِ هو ماضيه الغائرُ الذي عاشَه، والهجومُ الطويلُ الأمَدِ الذي شَنَّته استراتيجيةُ الحداثةِ الرأسماليةِ عليه. فبينما مُزِّقَ الجوهرُ الاجتماعيُّ إرباً إرباً على الصعيدِ الوجوديّ، فقد مَرَّ بوضعِ فوضى عارمةٍ من جهةِ المعنى والحقيقةِ أيضاً.