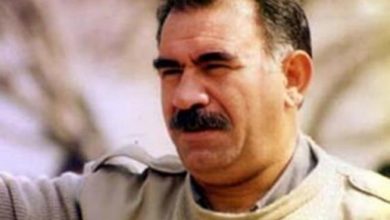أسباب الأزمة في الشرق الأوسط
أسباب الأزمة في الشرق الأوسط

 رستم جودي
رستم جودي
2-السلطة والدولة
سنتطرق في هذه الحلقة إلى دور السلطة والدولة في إعاقة تحقيق النهضة والتقدم ودورها في ولادة الأزمة وتعمقها في منطقة الشرق الأوسط. فكل نظرية اجتماعية لها شكل تقرب خاص من المجتمع والسلطة والتناقضات. لأن النظرية تعني رؤية وشرح الاختلاف والتناقض الموجود، أي أن كل نظرية اجتماعية تقوم بإبراز محور الاختلاف والتناقض حسب رؤيتها ببراهين وإثباتات تجدها هي منطقية. فعند التطرق إلى النظرية الاجتماعية للماركسية نرى بأن محورها الأساسي هو الطبقات الاجتماعية. فهي على وجه الخصوص تقوم بإبراز أسباب وإثباتات وبراهين منطقية لإثبات دور الطبقة في النظرية الاجتماعية التي تطرحها أي نظرية الاختلاف الاجتماعي. لماذا نقول عنها منطقية؟! لأن هناك فرقاً بين المنطق والحقيقة كما يذكر القائد آبو في مرافعاته. فلا يمكن للمنطق أن يمثل الحقيقة أو يعبر عنها على الدوام، لكنه نظام يقوم بربط الأسباب مع النتائج، وبهذا الشكل يمثل التوافق والتناسب، إلا أنه لا يمثل الحقيقة في كل الأوقات. لهذا السبب نقول حاولت الماركسية توضيح التناقضات الاجتماعية ضمن إطار الاختلاف الطبقي، وعلى هذا الأساس قامت بإيجاد كل الأسباب والمبررات والبراهين أي كل الأشياء التي تسند إليها نظريتها الاجتماعية. وأقنعت قسماً كبيراً من المجتمع، نعم كانت تستند إلى المنطق ولكنها كانت بعيدة عن الحقيقة، لأنها كانت تقوم بإنكار العديد من الأمور الأخرى أي أنه اكانت تغض النظر وتنكر العديد من العناصر الأخرى التي كانت تساهم في تعمق التناقضات الاجتماعية. حيث أنه وبعد فترة اتضح بأن النظرية الاجتماعية للماركسية أي النظرية الاشتراكية للماركسية لا تكفي لوصف وتوضيح المجتمع بها.
وفي يومنا الراهن إسناد المنطق إلى الحقائق والتقرب منها أكثر يعتبر من أهم محاور نظريتنا الاجتماعية. لذا يلعب الشرق الأوسط دوراً هاماً في تحديد مصدر الكثير من المعاني والمصطلحات والمؤسسات. أي أن منطقة الشرق الأوسط مصدر العديد من المصطلحات التي نعرفها في يومنا الراهن كالسلطة والدولة والطبقية والانكسار الجنسي لذا نقوم بشرحها على هذا الأساس. وحتى الآن لم يستطع علم الاجتماع والآثار والتاريخ على الرغم من التطور والتقدم الذي أحرزه أن يقدم أو يطرح نظرية ضد هذه النظرية، أو يقوم بإثبات عكس هذه النظرية. لم تظهر أية نظرية تنتقد أو تثبت عكس نظريتنا الاجتماعية وعلى وجه الخصوص القسم الذي يسند مصدر العديد من القضايا التي نعانيها في يومنا الراهن إلى تاريخ منطقة الشرق الأوسط. فالنظريات التي تقوم بانتقاد نظريتنا أو تغض الطرف عنها هي نظريات موجهة على أساس خدمة مصالح الامبريالية والرأسمالية. لهذا السبب لا نتطرق إليها على أنها نظريات مضادة. فهي لا تستطيع أن تنفي صحة نظريتنا أو تتقدم بانتقادات جادة. لأنها في الأساس لا تستند إلى الحقيقة إنما تتخذ من «أنا المركز » أساساً لها وتعتبر أوروبا مركزاً لكل شيء. ويعتبر هذا الموقف السبب في عدم قدرتها على لعب دور جدي ضد نظريتا الاجتماعية التي نتخذها في يومنا الراهن أساساً لنا. فظهور واكتشاف أي شيء جديد يساهم في إثبات صحة الأشياء التي نقولها وتطرحها حركتنا وقائدنا أكثر. سنتطرق إلى قضية أو مسألة السلطة والدولة ضمن هذا الإطار أيضاً. فالسلطة والدولة شيئان مختلفان. فالسلطة تكونت قبل الدولة، وتبرز السلطة ذاتها عندما يفقد المجتمع تناغمه الطبيعي بين عناصره التي يتشكل منها ويحل مكانها عدم الاستقرار والظلم والتهميش والإنكار، وهذا يفتح المجال أمام الهيمنة والسلطة. فالسلطة هي مرحلة حكم ظهرت قبل الدولة وبدأت من منطقة الشرق الأوسط. فمنطقة الشرق الأوسط «كزمان ومكان » مثّلت مصدراً ومنبعاً للسلطة. ففي التاريخ القديم أي منذ 4000 سنة قبل الميلاد بدأت السلطة بالبروز في منطقة موزوبوتاميا العليا والسفلى وتدريجياً في حوض النيل عندما بدأ المجتمع يفقد توازنه على أساس الغصب وامتلاك الإنتاج الفائض للمجتمع.
بالطبع أولى أنواع السلطات التي برزت هي سلطة الرجل على المرأة، وسلطة الرجل داخل العائلة، وسلطة الأفندي على العبيد ومن ثم سلطة الراهب على الشعب، أي أن مفهوم السلطة تطور بهذا الشكل ضمن المجتمع. استناداً إلى هذا لم يكن هناك وجود للدولة آنذاك لكن كان هناك انتشار لمفهوم السلطة ضمن المجتمع. بكل تأكيد لم يتم تقبل هذا المفهوم «السلطة » بشكل إيجابي. أي لم يتقبله الشعب دون إبداء ردة فعل، بل على العكس تماماً أبدى المجتمع رد فعل ضدها. قد يتساءل أحدهم؛ كيف ندرك أنه كان هناك ردود أفعال على الرغم من عدم وجود أدلة مكتوبة تثبت هذه الردود أو المواقف؟! يتضح من خلال القصص المحفوظة والمكتوبة التي وصلت إلى يومنا الراهن على شكل أساطير بأن تلك السلطة التي ولدت ضمن المجتمع، وتحطم التوازن الاجتماعي لم يتم بهذه السهولة؛ إنما يتم الإحساس بالمواقف وردود الأفعال التي أبدتها المرأة والشخصيات الاجتماعية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التمعن في تلك الأساطير. فإن تم شرح وتحليل تلك الأساطير بشكل معرفي، وإن تم التطرق إليها بشكل مغاير للقصص الأخرى يمكننا استخلاص هذه النتيجة منها. أي يتضح لنا أن ظهور السلطة وفرض الهيمنة لم يتم من دون رد فعل أو مقاومة. إلا أن الشيء السيئ في هذا الموضوع هو أن مجموعة السلطة هذه والتي تتكون من «الرجل، رب الأسرة، الراهب، الغني الذي سطا بشكل من الأشكال على الإنتاج الفائض » هي مجموعة أو شبكة قائمة على أساس المصلحة، وفي الأساس تشارك وتعاون شبكة المصلحة هذه مع بعضها والتي بدورها توحد المجموعات السلطوية المختلفة مع بعضها ساهم في ولادة الدولة. فالدولة في الأساس هي مشاركة شبكة المصلحة مع بعضها البعض ضمن المجتمع الذي ابتعد عن حقيقته الاجتماعية وتوازنه الطبيعي وتم هذا في منطقة الشرق الأوسط. لهذا السبب تحوز التحليلات المتعلقة بالدولة على أهمية بالغة. بالطبع كل نظرية اجتماعية تركز على الدوام على الدلائل والمصادر التي تعتبرها مصدراً للمشكلة، وهذا شيء طبيعي. فعند قراءة الماركسية، والبحث عمّا قاله كل من ماركس ولينين وانجلز وما قاله كل من أتى بعدهم؛ نرى بأن جميع أقوالهم تتمحور حول محور الطبقة. فهم يشيرون إلى روما وآشور وبابل إلا أنهم يرونها مجرد حكايات لا غير.
أي أنهم يغضون النظر عن النظامالمتبع لديهم «جمهوري، ملكي، برلماني » إنما يتطرقون إليها على أنها تمثل النظام العبودي بغض النظر عن الحضارة التي تمثلها. أي أنهم يتطرقون إليها ضمن إطار الطبقة. لأن تلك النظرية الاجتماعية تأخذ الإطار الطبقي أي الاختلاف الطبقي أساساً لها، ولهذا السبب لا تعير أية أهمية للمسميات وشكل النظام المتبع. فهي لا تعير أية أهمية إلى شكل النظام سواء أكان جمهورياً أم نظاماً يستند إلى المجالس أو ما شابه.
كل النظريات الاجتماعية، وخاصة تلك التي تأخذ السلطة أساساً لها، ترى بأن الدولة تعبر عن تطور في تاريخ الإنسانية على الرغم من كل السلبيات والتناقضات التي جلبتها معها، أي تعتبرها تطوراً ضمن التطور البشري ولا يمكن الاستغناء عنها. فلو لم تكن الدولة موجودة ومن هنا لو لم يكن هناك الاختلاف الطبقي أي لو لم يكن هناك وجود للحاكم والمحكوم، لكانت حياة الإنسان ستعيد وتكرر نفسها ولكانت ثقيلة جافة وتفتقد إلى الإنتاج ولما كان بالإمكان تحقيق التقدم والتطور. هذا هو ادعاؤهم ويصرون عليه.
بالاستناد إلى هذه الحقيقة أو النظرية توجه البعض الآخر نحو نظريات أخرى، وقالوا إن الدولة أمر إلهي أي قانون إلهي، فوق إرادة الإنسان، لأن الإنسان عدائي في داخله والإنسان ذئب ضد أخيه الإنسان، ولهذا السبب هناك حاجة وضرورة لمؤسسة تمنع اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان؛ وهذه المؤسسة هي الدولة. لهذا السبب يرون بأن الدولة نعمة من نعم الله. ويتعدى البعض الآخر هذا كتوماس هوبز ويقول: » إن الدولة المطلقة هي الدواء لمشاكل البشر؛ لأنه بدون وجود سلطة مطلقة ذات قوة واتجاه مطلق لا يمكن تنظيم المجتمع الإنساني ». كل هذه الادعاءات استخدمها المجتمع الحاكم كذرائع لشرعنة سلطته وإقناع الناس بها وصون صيرورتها. ودفع بالإنسان في يومنا الراهن؛ ذاك الإنسان الذي ليس له أية علاقة بالدولة ولم يلقَ منها سوى المضرة ولا يتشارك معها في أي شيء سوى إبداء الطاعة والعبودية ودفع الضرائب، إلى أن يتمسك بالدولة ويدافع عنها ويتطرق لها كنوع من الحرية أكثر من الجميع. وبات يتطرق إلى كل من الدولة والحرية كمصطلحين متشابهين ومترابطين ببعضهما. وتبرز هذه الرؤية بشكل واضح ضمن تلك المجتمعات التي لا دولة لها كالمجتمع الكردي. لهذا السبب من الأهمية التركيز والتوقف على مفهوم الدولة بشكل جدي. أي هل سنتطرق إلى الدولة كنوع من التطور ضمن التطور الإنساني أو كنوع من الانحراف؟! هل الادعاء القائل بأنه لولا الدولة لما حدث التطور ضمن التاريخ الإنساني صحيح أم خاطئ؟! هل كان بمقدور الإنسان أي يدير أموره بدون الدولة؟! هل كان بإمكانه تطوير نفسه؟! بالطبع هذه نقاط هامة وأساسية ينبغي التركيز والتوقف عليها للوصول إلى قناعات صحيحة. استناداً إلى هذا يمكننا استخلاص واستنباط العديد من الدروس والتجارب من تاريخ منطقة الشرق الأوسط. قبل كل شيء كل الادعاءات والنظريات التي تدعي بأنه لولا الدولة لما حصل التقدم والتطور ادعاءات خاطئة وغير صحيحة. لأن الإنسانية لم تتقدم وتتطور بالدولة بل على العكس تماماً فالدولة سدّت الطريق أمام تقدم الإنسانية وتطورها. فلو عدنا إلى التاريخ الإنساني قبل ظهور الدولة نرى بأن تاريخ ظهور أول أشكال الدولة لا يتعدى الخمسة آلاف سنة، أما بالنسبة إلى التاريخ الإنساني فهو يمتد إلى آلاف الآلاف من السنين. فذاك الإنسان البدائي الذي استطاع أن يصل إلى مرحلة يكون قادراً فيها على إنشاء القرى والقيام بالزراعة وتربية المواشي ووصل لمرحلة استطاع فيها التعبير عن حياته بالعديد من الرموز كالتي يتم رؤيتها في ثقافة العديد من المناطق التي لم تحتك بالدولة كما ظهر في ثقافة تل حلف وكوبكلي تبى، تثبت بأن الإنسان صاحب وعي، ووصل إلى مرحلة بات فيها يطور أشياء قريبة من الكتابة أي يعبر عمّا يعيشه عن طريق الرموز، فكل هذه الأمور تحققت قبل ولادة وظهور الدولة. إذاً فالتطور لم يتحقق مع الدولة إنما وجد مع إدراك الإنسان لذاته. فالتطور خاصية طبيعية للإنسان. فالعقل المتطور للإنسان هو السبب والدافع لتتشكل له حافظة تاريخية، ويستخرج الدروس من تلك الحافظة التاريخة التي امتلكها، وعلى أساسها إعادة النظر في مستوى أسلوب حياته والانتقال بشكل مستمر من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً وتطوراً.
الدولة كقوة تأسست من خلال الاستناد إلى النتاج الاجتماعي الذي جمعه الإنسان، لذا فالدولة ليست مؤسسة طبيعية ولا تعتبر حاجة مطلقة ولا تساهم في تحقيق التطور؛ بل على العكس تماماً. لهذا السبب لا يمكن تحقيق الديمقراطية والثورة من دون مناقشة وتحليل الدولة بشكل صحيح. من الواجب على أية ثورة قبل كل شيء مناقشة الدولة بشكل صحيح، فثورات الشعوب التي ولدت في القرن السابع عشر والثامن عشر وحتى التاسع عشر كالتي ولدت في كل من هولندا وانكلترا، أمريكا وفرنسا، وحتى ألمانيا أيضاً ناقشت الدولة، الدولة المونارشية، والحكم المطلق عندما بدؤوا بثورتهم، وعلى هذا الأساس أنشؤوا الدولة الديمقراطية حسب اعتقادهم «دولة الشعب » إلا أن تلك الدولة التي أنشؤوها لم تكن لها أية علاقة بالشعب. والسبب هو أن هذه الدول، على الرغم من اتباعها نظام الانتخابات وعدم استناد السلطة فيها إلى المفهوم العرقي، لم ترفض جوهر الاستعمار والاستبداد ولم ترفع نظام الملكية الخاصة. كما أن تلك الدولة المتشكلة «الدولة البرجوازية » وعلى الرغم من إبراز نفسها على أنها دولة الشعب كانت في الأساس تستند إلى الاستغلال وكانت الملكية الخاصة قانون تلك الدولة، ووجود تلك الدولة مرتبط بحماية تلك الملكية «الملكية الخاصة ». ولهذا السبب فإنها مهما ادعت بأنها دولة الشعب وليست دولة طبقة وفئة معينة من المجتمع ولا تمثل السلطة على المجتمع، إلا أن تلك الادعاءات مجرد أقاويل لا يمكن من خلالها خداع الإنسان. خاصة أن هذه الدولة التي كانت تظهر نفسها على أنها دولة الشعب قامت بالعديد من المجازر ضد العمال والكادحين والفلاحين بكل ما تملك من قوة عسكرية عند مطالبتهم لحقوقهم. وتاريخ القرن الماضي خير شاهد على هذا الموضوع .
كذلك الأمر في الثورة الاشتراكية فهي أيضاً ناقشت موضوع الدولة، وتوصلت إلى بعض التثبيتات الصحيحة بخصوص
الدولة، واقتنعت بأن الدولة لم تكن موجودة في كل المراحل التي مر بها الإنسان، إلا أنها وبالتوازي مع هذا تطرقت للدولة على أنها مرحلة متطورة ضمن مرحلة التطور الإنساني، فنحن نختلف معهم في هذه النقطة. والنقطة الثانية هم كانوا يرون بأن الدولة محكومة بالزوال أي كانوا يرون ضرورة القضاء عليها ولكن ليس بالطريقة التي كانت تسعى إليها المجموعات الأنارشية إنما بتحجيم وتقليص دورها تدريجياً حتى الزوال، ولكن من أجل تحقيق هذا هناك حاجة مطلقة لوجود دولة بروليتارية، أي هناك حاجة لدولة طبقة وليس دولة الشعب. لهذا السبب مهما كان شكل الدولة؛ فإن كانت تمثل طبقة معينة تعتبر دولة مناهضة للديمقراطية. فإن كانت الدولة مؤسسة لحكم طبقة معينة على أخرى حينها الدولة البروليتارية تعبرعن الشيء نفسه. وعندما نأخذ التثبيتات الخاطئة مع النظريات الاجتماعية للماركسية، أي كيف قسمت المجتمع فيما بين الرأسمالية والبروليتارية، وغضت النظر عن الطبقات والشخصيات الأخرى ضمن المجتمع وأنكرتها وحتى أبدت مقاربات سيئة تجاهها، حينها تكون هذه الدولة أكثر خطورة. إذاً فالدولة البروليتارية لا تناهض وتعادي البرجوازية إنما تعادي كل أشكال المجتمعات الأخرى، لهذا السبب هذه الدولة بمنطقها هذا وعلى الرغم من أنها كانت تعتبر تبشيراً للشعوب في بداية الأمر إلا أنها توجهت خطوة بخطوة نحو صيغة مركزية. وكان هذا سبباً لفشل محاولة المجتمع التحتي حل المشكلات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. استناداً إلى هذا تعتبر مناقشة الدولة أمراً مهماً ولا سيما في ظل الثورة التي نحياها. لأنه إن لم نقم في ظل هذه الثورة بمناقشة الدولة لا يمكننا إنجاح وإيصال الثورة إلى النصر. والثورة التي سنقوم بها من دون مناقشة الدولة ستخون حقيقتها كما حصل في جميع ثورات التحرر الوطني السابقة كالثورة الفيتنامية والصينية والجزائرية وغيرها من الثورات. فهذه الثورات التي كنا نتخذها أساساً ونستنبط الدروس منها خانت حقيقتها لأنها لم تناقش مفهوم الدولة والتقرب السلطوي بشكل صحيح. صحيح أن هذه الثورات كانت باسم الشعوب ولكن في يومنا الراهن نرى بأنها أكثر من تفرض الضغط على الشعوب، لهذا السبب نقوم بمناقشة الدولة ومفهوم السلطة. قد يقول البعض: لمَ نقوم بمناقشة شيء لا نملكه؟ أي لمَ نقوم بمناقشة الدولة ونحن لم نصل إليها؟! صحيح، ولكن ألا نرى بأن وجود الدولة أمر طبيعي؟! بالطبع هناك ميل بهذا الاتجاه ويفرض ذاته بشدة علينا ويوجه ممارستنا العميلة أيضاً، لهذا السبب فإن القيام بهذه المناقشات أمر ضروري. بالطبع نقوم بمناقشة الدولة في الشرق الأوسط، فالدولة الشرق أوسطية دولة صلبة ودوغمائية مسلحة بمفهوم السلطة إلى أبعد الحدود، وتعطي لنفسها المشروعية المطلقة وترى لنفسها الحق في عمل أي شيء، وقضت على كل خلايا المجتمع من خلال فرض السلطة والحاكمية الدولتية. فالدولة الشرق أوسطية كانت تدعي أنها تمثل الشعب أكثر من كل الدول الأخرى. فالدول الغربية لا يمكنها أن تدعي هذا بهذا الشكل، فهي تسعى لإبراز ذاتها بهذا الشكل إلا أن الشعب لا يؤمن بها. أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط فأبناء المجتمع يؤمنون بأن الدولة تمثلهم، ويتم اعتبار جميع الانتقادات والمساعي والمواقف التي تُبدى ضد الدولة من أكبر الذنوب، وهذا الذنب لا يحدد فقط عن طريق المحاكم والقوى الأمنية والأيديولوجية للدولة؛ إنما تحول إلى حالة نفسية لدى كل المواطنين. فالشخص بات يشعر بهذا الذنب من تلقاء نفسه عندما يبدي أي رد فعل ولو كان بسيطاً تجاه الدولة. ومع الأسف فإن بعض أعضاء حركة العمال الكردستاني التي تعتبر من أوسع الحركات الثورية على المستوى العالمي في القرن الحادي والعشرين لم يحرروا أنفسهم بعد من تأثير هذه الحالة النفسية. فعلى سبيل المثال الحالة النفسية التي تفرض ذاتها على بعض رفاقنا الذين قضوا حكمهم في السجون والتأثر بقضية طلب العفو والتراجع عن نضالهم شبيهة بتلك الحالة النفسية التي ذكرناها آنفاً، أي أنهم باتوا مقتنعين بأنهم كانوا بنضالهم هذا يقترفون ذنباً ضد الدولة ومن حق الدولة معاقبتهم وفرض الجزاء بحقهم، ولهذا السبب تخلوا عن نضالهم كي لا يقترفوا ذنباً جديداً ضد الدولة المقدسة بنظرهم. فهذه الحالة النفسية تدفعهم لكي يتخلوا عن الأهداف التي ناضلوا من أجلها. فهي مسألة جدية وتستوجب التركيز عليها. فهذه القضية تخص الإنسان الخانع المحكوم من كل النواحي، لأن الإنسان المتسلط والإنسان الحاكم لا يعاني من أية قضية تجاه الدولة، لأن الدولة تمثل نفسها عن طريق هؤلاء الناس «الحاكمين والمتسلطين على المجتمع ». ولكن قيام الإنسان المحكوم بالتحدث عن الدولة ووصفها بدولته وأنها تمثل حقوقه، هنا تكمن المشكلة. ففي يومنا الراهن نصادف هذا الشيء ضمن المجتمع الكردي أيضاً، فعند التحدث أو انتقاد الدولة عند بعض المواطنين الكرد البائسين في باشور نرى بأنهم يبدون رد فعل تجاه هذا الحديث دفاعاً عن تلك الدولة التي تبقيه بائساً. يدافع عن تلك الدولة التي يظن بأنها تمثله على الرغم من كل ما تقوم به الفئة التي تدير تلك الدولة. فهذه الوحدة بين الشعب والدولة أي هذا الانحراف خطير. قد لا تكون هذه الحالة النفسية أو هذا المفهوم ذا تأثير كبير على الكوادر والفئة الإدارية ضمن الحركة، لأنه من خلال التدريب والمناقشة والممارسة العملية واستخدام آلية النقد والنقد الذاتي ضمن الحركة قلَّ تأثير مفهوم الدولة والسلطة تدريجياً ، إلا أنه عند التطرق إلى نظامنا العام
نرى بأن هذه القضية مازال لها تأثير وتشكل قضية هامة في النضال، أي أننا نرى بأن هذه المشكلة لا تزال تفرض ذاتها علينا عندما نقيم نضال الحركة ككل. أي التقرب من قضية الحرية والدولة على أنهما قضيتان مرتبطتان ببعضهما ولا يمكن تحقيق إحداهما من دون الأخرى يؤثر على النضال. علماً بأن الدولة تناهض الحرية وتناهض الاستقلال ويمكن
رؤية هذه الحقيقة بشكل واضح ضمن الدول العربية والدولة التركية والكثير من الدول الأخرى. إلا أنه ومع الأسف هناك رأي ضمن المجتمع الكردي يربط كلاً من الحرية والاستقلال بالدولة ويصر على ذلك.
كما ذكرنا آنفاً الدولة الشرق أوسطية دولة صلبة دوغمائية ومن هنا نريد تعريف نقاط الاختلاف بين الدولة الشرق أوسطية والدولة الغربية. فالدولة الغربية ذات طابع لين بعض الشيء وذلك بحكم الظروف التي نشأت فيها، أما بالنسبة إلى الدولة الشرق أوسطية فهي دولة صلبة وهي كذلك بحكم الظروف التي نشأت فيها. فالدول الأولى التي تشكلت والتي كانت تمثل دول المدن دول لا تستند إلى حكم مطلق وتستند إلى أرضية فيها بعض الشيء من الحرية وتضم مجالس وأسلوباً للإدارة يمكن مصادفتها ورؤيتها في اليونان وحول البحر الأبيض المتوسط وبحر ايجة (أزمير الآن)، لذا نجد تطوراً للحركة الفكرية في تلك المناطق قام بها شخصيات كتالس وفيثاغورث وأرخميدس وغيرهم. فهناك لا نرى أي نوع من الضغوط والقوانين المطلقة والاستبداد بالسوية التي تضيق الخناق على حرية الإنسان، لهذا السبب تم تسميتها بالديمقراطية عند انتقالها إلى أثينا لأول مرة والتي تعني حكم الشعب نفسه بنفسه. إلا أنها في الحقيقة لم تكن تعبر عن الديمقراطية لأن تعريفها للشعب كان خاطئاً ناقصاً ولم تكن تشمل جميع فئات المجتمع. كما أن تلك الديمقراطية لم تكن تشمل العبيد لأنها لم تعتبر العبيد أناساً، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة أيضاً لأنها هي الأخرى لم يكن يتم الاعتراف بها كإنسانة. إذاً فهذه الديمقراطية كانت تعني حكم مواطني أثينا الأحرار منهم فقط. ولكن على الرغم من ذلك كانت تلك الديمقراطية ملفتة للنظر، حيث كان الانتخاب والتصويت حقاً للجميع ويقومون بانتخاب مجلس أثينا المكون من 500 شخص، ويختار ذاك المجلس المشكل المجلس الرئاسي من ضمن المجلس. أي أنه لم تكن مصادر السلطة والدولة في الغرب ذات طابع استبدادي. فالاستبدادية تعني الإدارة أو الحكم المطلق أي الحكم من دون مراقبة ومتابعة من جهات أخرى. إلا أن الوضع في أثينا كان مختلفاً لوجود المجلس الذي كانت مهمته مراقبة ومتابعة السلطة. أي أن الحاكم لم يكن باستطاعته القيام بكل ما يريده لأنه كانت تتم متابعته ومراقبته من قبل هذا المجلس. فوجود رقيب أو جهة تقوم بمتابعة وفرض الرقابة على السلطة السياسية في منطقة ما تدفع لأن يكون طابع الدولة ليناً بعض الشيء. أي كانت هناك محاسبة لتصرفاتها وممارستها العملية ويتم إعادة النظر في طرازها في الحكم والإدارة وتقوم بتصحيح مسارها في بعض الأحيان ومحاسبتها في أحيان أخرى. وكان هذا سبب تطورهم ونجاحهم وتوسع جغرافية سلطتهم لتصل إلى الهند ومصر وبقية دول العالم. صحيح أنهم حققوا تطوراً من الناحية التكنولوجية في مجال المعادن والمعدات والمجموعات العسكرية وكان لها تأثير في انتصاراتهم العسكرية إلا أن نظامهم الجديد وإحساس الإنسان بوجوده ضمن هذا النظام الجديد وقدرته على فتح العالم أجمع ضد الاستبدادية والرجعية التي كانت منطقة الشرق الأوسط تعيشها كان بكل تأكيد خطوة متطورة. وهناك العديد من الأمثلة الملفتة في هذا الموضوع، ففي عام 500 قبل الميلاد قام الفرس بالسيطرة على المناطق المحيطة بأثينا، حققوا فتوحات نحو الغرب وفتحوا الأناضول وحكموا العديد من المناطق وصولاً إلى أثينا وحاصروا أثينا ولم يكن بمقدور اليونان الصمود أمام هذا. حينها قام أحد القادة الشباب من المجلس بطرح خطة لتجاوز هذا الوضع، واستندت هذه الخطة إلى ثلاث مراحل لتطبيق هذا المخطط أمام هجمات الفرس والنجاح فيها. ففي تلك الفترة كان مجلس أثينا في حالة ميؤوس منها كما أن تلك الخطة المقترحة كانت منطقية لهذا السبب تمت الموافقة على ذاك المخطط. أولى مراحل الخطة كانت تستند إلى إنهاك الطرف الآخر أي الفرس ومن ثم الدخول ضمن حالة مقاومة تتصدى لهجمات الفرس تدريجياً ومن ثم توسيع دائرة المعركة والمواجهة وكسر الحصار وبالفعل نجحت تلك الخطة في فك الحصار المفروض على أثينا. إلا أن أول عمل قام به هذا المجلس بعد فك الحصار وإنقاذ أثينا هو إقالة هذا القائد من منصبه. لأنه إن لم تتم إقالته من منصبه سوف يتمكن من خلال القوة التي اكتسبها من الانتصار الذي حققه ضد الفرس من توجيه النظام إلى مجرى آخر، كما أن بإمكانه حينها إبراز وفرض نفسه كاستبدادي وحاكم. فمن أجل عدم إفساح المجال أمام تطور وضع كهذا قاموا بإقالته من منصبه. كان هذا شكلاً من أشكال الدفاع عن الذات. أي أنه في الأساس شكل من أشكال حماية الديمقراطية، تلك الديمقراطية التي حققوها وفق مفهومهم. إلا أن تلك الديمقراطية لم تبقَ على تلك الحالة على الدوام فالبعض استطاعوا من خلال الاستناد إلى قوتهم العسكرية والمادية أن يفرضوا حكماً مطلقاً. أي أن أسلوب الدولة لم يكن استبدادياً على الدوام على عكس ما كان عليه في منطقة الشرق الأوسط. كذلك الأمر في روما فقد كانت هناك الديمقراطية الجمهورية أيضاً. كالجمهورية الأرستقراطية وجمهورية الشعب.. ففي فترة روما كانت تتشكل جمهوريات فمنها جمهوريات أرستقراطية والتي كانت تتكون من الأرستقراطيين حيث كانوا يقومون بانتخاب ممثلين عنهم وهؤلاء الممثلون المنتخبون يتحولون إلى سيناتو وهم بدورهم كانوا يقومون بانتخاب إدارة روما العامة. وفي بعض الأحيان كانت تتقدم أكثر من هذا؛ حيث كان الشعب -ما عدا العبيد والمرأة- يقومون بانتخاب ممثلين عنهم وهؤلاء الممثلون كانوا يمثلون المجلس وكانوا يتابعون السلطة ويراقبونها. ومن ثم كان الأمر في أوروبا بهذا الشكل فمثلاً كان هناك نظام منغا كارتا الذي بدأ من 1250 في انكلترا واستمر إلى يومنا الراهن فقد كان آلية لمتابعة السلطة ومراقبتها أي أن السلطة لم تكن منفردة في الحكم لوحدها إنما كان هناك بعض القوى والمؤسسات تقوم بالإشراف عليها. إلا أنه في الشرق الأوسط عندما تشكلت الدولة تشكلت إلى جانبها وبشكل استثنائي بعض المؤسسات التي تقوم بالإشراف ومتابعة إدارة الدولة. فالسلطة كانت تتم من دون إشراف أو مراقبة مؤسسات أخرى كونها كانت مطلقة. لأن الحضارة الطبقية في الشرق الأوسط والدولة التي تمثل جوهرها تشكلت بشكل دوغمائي وتستند إلى قوالب معينة محددة، وعبرت عن تقسيم المجتمع أو الاختلاف الطبقي ضمن المجتمع كإرادة إلهية وعلى أساساها أُنشئت الميثولوجيات. فمثلاً ادعت بأن الله خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان من أجل الخدمة والطاعة وفلان هو ممثل الله على الأرض. لهذا السبب ظهر ملوك آلهة، ملوك شبيهة بالآلهة. أي ظهر ملوك تكتسب سلطتهم شرعيتها من الآلهة بشكل مباشر. ولم يطرأ أي تغير على هذه الحالة حتى في يومنا الراهن. حيث نلاحظ بأن شكل السلطة لم يتغير إلى يومنا الراهن في الشرق الأوسط. فالملوك الآلهة لا تقبل إشراف ومراقبة أية مؤسسة عليها وتسير أعمالها بشكل مطلق. إلا أنهم في حال شعورهم بالضعف كانوا يقبلون بعض المؤسسات ويفرضون سيطرتهم عليها ويقومون بتصفيتها تدريجياً وإن كانوا بحاجة إلى إنشاء بعض المؤسسات يقومون بتشكيلها فقط للموافقة على القرارات التي يصدرونها. فمثلاً أكثر الدول ديمقراطية في الشرق الأوسط هي تركيا، إلا أنه عند التطرق إلى مجلسها نرى بأن مهمته هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي. كما أن الأمر على الشاكلة نفسها في كل من مصر وسوريا والعراق وإيران. أي أنها تقوم بإدارة المجتمع على أساس جمع كل الصلاحيات بيد واحدة. مقابل هذا لم يقم المجتمع بإنشاء تنظيمه الخاص. ولم تكن هناك قوة قادرة على مواجهة الدولة على مستوى حماية حقوق المجتمع أمام الدولة. أي مُنع المجتمع من أن يخلق أو يعمل أي شيء من أجل نفسه. فالدولة هي التي كانت تفكر عوضاً عن الشعب. استناداً إلى هذا تم تداول هذه الجملة «لو كانت الاشتراكية شيئاً مفيداً للمجتمع لأتت بها الدولة «. أي أن الدولة هي الموكلة عن المجتمع. أما بالنسبة إلى الدول العربية فلا يتم تداول هذه الجملة ولكنهم يقولون « إن الدولة تقوم بإنشاء كل ما يحتاجه المجتمع على سبيل المثال: إن كان المجتمع بحاجة إلى حركة نسائية حينها تقوم الدولة بإنشاء حركة نسائية وهكذا ». أي أن كلاً من الحركات والنقابات وغيرها من الأمور الأخرى التي تقوم الدولة بإنشائها تكون مرتبطة بالدولة وعلى الرغم من هذا يتم وصف هذا الوضع بالديمقراطية. أي لا يتم إفساح المجال أمام الشعب في الدول العربية للتعبير عن ذاته .
بالطبع تولدت مساعٍ ضد هذا الوضع، لأن الدولة أبرزت نفسها على الدوام بضرورات إلاهية. ولكي يتم فهم هذا بشكل أوضح سنتطرق إلى مثال أوضح وملموس؛ سوف نقوم باسترجاع أسطورة ولادة بابل. فبابل ولدت وتشكلت على أنقاض االدولة الأكادية نتيجة العمل المشترك فيما بين من تبقى من الدولة السومرية والبابلية «العرق السامي » قبل الميلاد بألفي عام. بالطبع بابل كانت دولة كبيرة حيث كانت أكبر من الدولة الأكادية وأكبر من الدولة السومرية. كانت تضم العديد من المجموعات الاثنية وتفرض سيطرتها على مساحة جغرافية كبيرة. وكان أسلوب الإدارة فيها يستند إلى نظام مركزي. هذا النظام المركزي لم يكن نظاماً اعتيادياً إنما كان يستند إلى نظام خاص. فلو تم التطرق إلى حمورابي سيكون الموضوع أكثر وضوحاً. حمورابي وضع قوانيناً وحدد طبيعة العلاقة فيما بين الإنسان والإنسان، وحدد الطبقات الموجودة ضمن المجتمع البابلي وحدد صلاحياتها. حدد مكانة المرأة والعبيد وقانون الأحوال المدنية. فتلك القوانين كانت تحتوي على كل شيء بدءاً من الزواج والقتل والطلاق والعديد من الأمور الأخرى، كتبها بشكل مفصل مادة بمادة. وأنهى قوانينه تلك ب » إني راضٍ بتطبيق القانون الوطني، وأحللت الاستقرار والأمن والحماية؛ فالآن ستتم إدارة هذا الوطن بصولجاني .» لهذا السبب تتم إعادة النظر في الميثولوجيا. أي أن تلك الأمور التي قامت بها امبراطورية روما القسطنطين عبر الاستفادة من الديانة المسيحية قام بها حمورابي من خلال الاستفادة من الميثولوجيا السومرية والأكادية. فالآلهة الموجودة في الميثولوجيا السومرية كانت كل واحدة منها تمثل شيئاً معيناً. أي تمثل فئة من المجتمع. فالتناقض فيما بينهم وحكم أحدهم على الآخر يمثل وضع ذاك المجتمع. فذاك المجتمع كان غنياً بالتنوع، ولم يقم على صهر هذا التنوع. فعلى الرغم من وجود السلطة والدولة والنظام والعبودية وتجاوزات لحقوق المرأة إلا أنها لم تكن بهذه القسوة والصلابة. إلا أن أسطورة ولادة بابل كانت مختلفة بعض الشيء. فهذه الأسطورة تظهر إلاهاً جديداً.
الرجل والحاكم يمثل كل شيء، وكل الآلهة الأخرى تسير في نظام حول الحاكم أو الرجل. أي أنه من خلال هذا أوضح بأن سلطته جلبت الاستقرار بعد الحالة غير المستقرة التي كانت تعانيها الآلهة فيما بينها. فطبق تلك الأسطورة على أرض الواقع أي أبرز نفسه كممثل للرب على الأرض وكل طبقة اجتماعية عليها أن تسير ضمن نطاق المهمة الموكلة إليها دون اعتراض. فكل من حكم في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من آشور ومروراً بالبرس والمسيحين والمسلمين ووصولاً إلى يومنا الراهن حكموا البلاد كممثلين للرب على الأرض، أي حكموا كآلهة على الأرض وتحول هذا إلى ميراث للسلطة. حتى أنه عندما دخل الاسكندر المنطقة اندهش من قيام الشعب بالسجود له لأنه الملك. فعلى الرغم من مجيئه من مكان آخر لاستعمار منطقتهم قام الشعب بالسجود له لأنه الملك ويمثل الدولة، ولا يمكنهم التصدي له وذلك بسبب ميراث السلطة. أي أن النقطة الأساسية هي الاستبداد والسلطة المفرطة السلطة الإلهية، ومع الأسف يستمر هذا إلى يومنا الراهن. بالطبع ظهرت العديد من الحركات الديمقراطية والكومينالية الاجتماعية مقابل هذا النوع من السلطة ومازالت هذه الحركات مستمرة إلى يومنا الراهن، ولكن ومع الأسف لم تكلل تلك الحركات بالنجاح. إلا أنه في يومنا الراهن وبتطور العلم والتكنولوجيا وبظهور وولادة القوة الديناميكية الجديدة للمجتمع بات احتمال نجاح تلك الحركات وتحقيق النصر أكبر من أي وقت مضى.