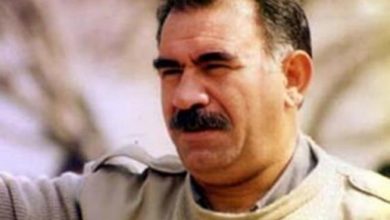إما الحياة الحرة أو الإبادة العرقية
إما الحياة الحرة أو الإبادة العرقية
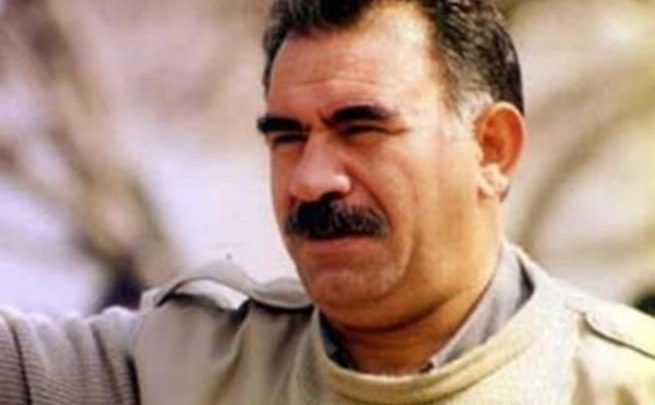
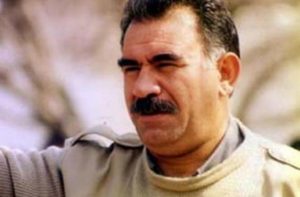 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
لقد قامت الحضارة العبودية السومرية على أكتاف القيم الاجتماعية للعصر النيوليتي والتي طورتها الشعوب في منطقة الهلال الخصيب خلال عشرة آلاف عام، وامتلكت التكنولوجيا والعلم الخاص بالعصر النيوليتي عن طريق إقناع نظامها المنتج على الأغلب وعن طريق التجارة أحياناً والعنف في أحيان أخرى، وقامت بتمأسسها على أساس فروع مهنية ومسلكية وحولتها إلى غنى غير عادي ضمن كيانها، لقد جمدت الشعوب والاقليات العرقية للعصر النيوليتي مقابل تصاعد حضارة الرق السومرية، كما هو موقف الإمبريالية الأمريكية حيال الشعوب في عصرنا هذا. لقد قلبت الإمبريالية السومرية الشعوب رأسا على عقب ولا سيما في المرحلة الآشورية، إلى درجة أنه مازال يعاش تأثيرها في الشرق الأوسط وكل العالم، وتحول ذلك إلى إرهاب وإبادة جماعية من جهة، وتثبت بالأرض والخازوق من جهة أخرى، لتترك أثرا لا يمحى من الذاكرة الإنسانية.
ولقد تواصلت ممارسات الاستغلال والهيمنة في المجتمع الطبقي على الإنسان حتى يومنا هذا. وأن كان تمارس إبادة الإنسان في حاضرنا بشكل منظم ويتصاعد ذلك بشكل يوازي التطور التقني، فأن هذا الوضع ناتج عن التزام المجتمع الحاضر بالواقع العملي للحضارة الأولى، التي ترسخت في ذاكرة المجتمع وراثياً. قد يوجد للذاكرة الاجتماعية مورثات تتكون باستمرار مثل مورثات الإنسان التي تمهد السبيل أمام نفس الصفة، وتسكن هذه المورثات في ذاكرة المجتمعات اللاحقة وتحدث نفس التأثير. تعيش الطبقة المستغلة حالة ضعف وتراجع في الوقت الذي تتضخم فيه الطبقة الحاكمة. لقد
خلق ديالكتيك الظلم والاستغلال بحيث لازال تشتيت هذه العجلة غير ممكناً. إن الإنسانية جزأت الذرة، ولكنها لا زالت بعيدة عن تشتيت عجلة هذا النظام.
الموضوعانية: المصطلح المفتاح لنظام الإبادة العرقية لا بد من إعادةِ تعريفِ وشرحِ مصطلحِ «الموضوعانية » بعمقٍ غائر في الأسلوب العلمي.
فتعريفُ كلِّ الطبيعة )بأحيائها وجمادها( على أنها «شيء موضوع » – بما في ذلك جسدُ الإنسان، وفيما عدا الفكر التحليلي – قد لَعِبَ دورَ المفتاحِ في استعمارِ الرأسمالية للطبيعة والمجتمع، والتحكم بهما. ذلك أنه من غير الممكن تحقيق التحول الذهني اللازمِ للعصر الحديث، بدون تجذيرِ وشرعنةِ التمييز بين الذات والموضوع.
بينما تكون الذاتُ العاملَ الشرعي الأكثر تداولاً وقبولاً في الفكر التحليلي، يُعتبَر الموضوعُ Nesne العنصرَ «المادي » الملموسَ الذي يمكن القيامُ بكلِّ أنواعِ المفارقات والإشاعات عبره.
وبمعنى آخر، فهو يمثل «الموضوعيةَ Objektivite » . وقد نشَبتَ صراعاتٌ مريرة بسبب هذا التمييز. إذ يجب عدمَ تقييم الصراع بين الكنسية والعِلم كمجردِ نزاعٍ على «الحقيقة » المطلقة، وتشديدُنا على كَونِ الواقعِ الاجتماعيِّ يعني مستوىً مختلفاً من الإدراكِ، هو بدافعِ استيعابِ الفوارق فيما بينه وبين العلومِ الأخرى بشكل أفضل. ذلك أنه، وبدون الإمساكِ بهذه الفوارقِ ووضْعِ اليد عليها، سوف نقع في نفسِ الخطأ الفادحِ الذي سَقَطَ فيه الوضعيون، ولن ننجوَ بالتالي من مَرَضِ «العلموية ». أما حصيلةُ ذلك، فهي الإبادةُ العِرقية التي آلت إليها الحداثةُ الرأسمالية. أما الإبادةُ العِرقية – أكُرِّرُها ثانيةً – فهي الجُرمُ الشنيعُ والإثمُ الفادحُ الذي أذَهَلَ أدورنو لدرجةِ قولِهِ بأنَّ كلَّ السلوكياتِ الإلهيةِ والبشريةِ تعَجَزُ عن إيضاحِ بواعثه، وفَكَّرَ بضرورةِ رميِ كافةِ الكتب في النارِ لتلتهمها، وآلَ إلى نتيجةٍ مفادُها أنَّ الحياةَ تأسست على منوالٍ خاطئ. هذا ومن المهم تثبيت استحالةِ استذكارِ مغدوري الإبادةِ والتطهيرِ العرقي خارجَ نطاقِ هذه المعاني. لكنَّ الحياةَ العصرية، والمدرسةَ الوضعية تعاندان في رفضِ هذه الحقيقة، بل وتعتقدان بإمكانيةِ العيش في هذه الحياة الاجتماعية، رغمَ كلِّ هذه الإباداتِ العِرقية. أو أنهما تَجرؤان على القول بإمكانيةِ العيش مع هذه التحريفات والتشويهاتِ الذهنية وقيمِ المدنية الماديةِ المؤدية إلى هذه الجريمة، دون القضاءِ على الجريمة بكافةِ ركائزها الأولية. وبسببِ هذه الجرأة، التي يجب ألا تتواجدَ في أيِّ كتاب، وبالتالي في أيِّ ذهنيةٍ أو عقل، يرَتعَد أدورنو، وينعكفُ على الانزواء، ويموت.
ما أسعى لعمله هنا، هو تحويلُ منابعِ هذه «الجرأة » وأشكالِ تجاوزها المحتمَلةَ إلى قضيةٍ إشكالية، وإبداءُ كفاءاتنا ومهاراتنا في الرد عليها وإيصالِها إلى المعاني والممارسةِ. ذلك أنه لا مجالَ أمامنا لغِضِّ النظر عن الحداثة المستمرة في وجودها، والمؤديةِ إلى بروزِ بؤرِ الإبادة والتطهير العرقي المتمأسسةِ طردياً مع الزمن.
فحقيقةُ عراقِ اليوم الباديةُ للعيان، وماهيةُ كافةِ أنظمةِ الشرق الأوسط في الإبادة العرقية – سواءً علنا أو استتارا – ومشاركتهُا جميعا في الجرائم والآثام؛ واضحةٌ جليا ورهيبة بِهَولِها، بحيث أنَّ راصديها يشعرون بها، فما بالك بالمحترقين بألسنةِ لهيبها والمنصهرين في بوتقتها.
ورغم ذلك، ثمة بالمقابل نزوعٌ وميولٌ عظمى متطلعةٌ للحياة الحرة. ولكن، مِن المحالِ البتةَ العيشُ بشكلٍ مشترك ومتداخلٍ في نطاقِ ثنائيةِ: إما الحياةُ الحرة أو الإبادةُ الجماعية. إذ لا يمكننا العيشُ هكذا والمشاركةُ في جريمةٍ كهذه. فكيف حصلَ ووصلتَ هذه الأراضي بتاريخها إلى هذه الحالة، بعدما كانت منبعَ أسمى معاني الحياة؟ ففي الطرفِ الأولِ تنشبُ حروبُ الأثنيات التي كانت مَهَّدَت الطريقَ لبروزِ اُولى معاني الحياة، وفي الطرفِ المقابل ثمةَ الحروب التي يقودها الإله الأخِير للحداثةُ! ما دام كذلك، فلا خيارَ لنا من التحامل على الموضوع تكرارا ومِرارا،ً والرَّدِّ على قضاياه، وإنجازِ العمليات اللازمة.
فمثلما قال أدورنو «لن تبقى لجميعِ الآلهة السماوية – لرجالِ العلم الناطقين باسمها – أيةُ كلمةٍ تُقالُ بعدَ تشييدِ معسكراتِ الإبادة الجماعية .» لا تَنحَصِرُ المدنيةُ في كونها مراسيمُ «المذابح الدموية » )حسبَ هيغل( فحسب، بل هي أنكى، حيث تُعَرِّضُ معانيَ الحرية للإباداتِ العِرقية المتواصلة – رغم كونها الدافعُ الوحيدُ لحياةِ الإنسان – فلا يتبقى منها سوى حُثالةُ الحياةِ وخُثارتها.
المدنيةُ هي البقايا المتبقيةُ من إفراغِ معاني الحياة الحرةِ من فحواها.
عندما ننظر إلى نمطِ حياةِ أبسطِ الكائنات الحية، فما نراه ليس إلا المعنى الذي يضُفِيهِ على الحياة. إنه نمطٌ من المعاني التي تمَدُّها بقدرةِ التكاثر إلى ملايينِ الأنواع، وتوَّغلِ الجذور حتى في أعتى الصخور، ومواصلةِ الوجود حتى في ثنايا القطب المتجمدِ عندما تتطلبُ الحاجة، والطيرانِ إنْ لزَمَ الأمر، والقدرةِ على تطويرِ تقنياتٍ لا متناهيةٍ لا تطالها اكتشافاتُ الإنسان ولا تَخطُرَ ببالِ بشر. أما المجتمعُ المديني، فأيُّ المعاني – أو عدميةِ المعاني – التي يمتلكها، فيما خلا قُدرته على إفراغِ وجودِ الحياة الأكثرِ رقياً من معانيها عبرَ الكذبِ والرياء والزيف وعبر العنفِ المنظَّم والممنهَجِ منذ بداياته، وإيصالِها إلى شفيرِ هاويةِ الانتحار في مراحلهِِ الأخيرة؟ لقد غَدَت السوسيولوجيا الكلامَ المؤديَ إلى إعادةِ تعريفِ هذه القوة مجددا للمدنية الأوروبية المِحوَر.
وحسبَ التعبير المسيحي، أصبحَت الكلمةُ الفصل للرب. لذا، فالتخلي عن هذا الكلام ضرورة من ضروراتِ احترامِ معاني الحياة التي تمتلكها أبسطُ الكائنات الحية. فالوجودُ الأرقى والأسمى للأخلاق لن يقَدِرَ على تفسير هذا الكَمِّ من انعدامِ الأخلاق بأِيِّ شكلٍ وبأِيِّ شيءٍ كان. ولنستذكر
ثانيةً أنه: ما مِن كلامٍ تقوله الآلهة. وإزاء الفقدان الكبير للمعنى، فنحن مُطَوَّقون ضمن حصارِ المدنية المادية في أرقى مراحلها. فكيف لنا حيث تستتر نضالاتٌ وكفاحاتٌ اجتماعية عظمى تحته. إنه ضربٌ من ضروبِ النزاع والصراع بين المجتمع القديم المشحون بالأخلاق، والمجتمعِ الرأسمالي العاري الساعي لنزع الستار الأخلاقي عن ذاته. أي أنَّ المسألةَ ليست مجردَ نزاعٍ بين الكنيسة والعِلم فحسب. وبشكلٍ أعم، أنه صراعٌ بين النظام الذي حافظ عليه وجدانُ المجتمع طيلةَ مسيرته التاريخية، وحَظَر استغلالهَ، ولعَنَ ذلك، واعتبرَه جرماً لا يُغتفَر؛ وبين المشروعِ الاجتماعي الرأسمالي الجديدِ الساعي لفتحِ الأبواب على مصاريعها أمام استعمارِ المجتمعِ واستغلاله والتسلطِ عليه، دون الاعترافِ بأيِّ حظرٍ أو جُرمٍ أو لعنة. و »الاتجاه الموضوعي » هو المصطلح المفتاح لهذا المشروع. حالةٌ حربِ الكل ضد الكل تتخفى تحت مفهوم «الموضوعانية Nesnellik » ل »الفكر التحليلي » فكرةٌ مفادها: ما من «قيمةٍ » لا يمكن إخضاعها للعملية. إذ يمكن استغلال كلِّ ما في الطبيعة من حيٍّ وجماد، والتحكم بها وتملُّكها، بحيث لا يقتصرُ الأمرُ على كدحِ الإنسان فحسب، بل ويمكن البحث والتنقيب فيها، والتمتع بحقِّ استغلالها بكافةِ الأشكال. وفيما عدا الذواتِ المنتقاة، يحق النظر لكلِّ شيءٍ على أنه ميكانيكيٌّ آلي، وبالتالي، التحكم به واستغلاله بلا رحمةٍ أو شفقة. أما الفرد، والمواطِن، ومجتمعُ الدولة القومية، المنظَّمون ك ذواتٍ أساسية في مواجهة الطبيعة والمجتمع، فيُعتبَرون «اكتشافاتٍ جديدةً » ذاتَ طاقةٍ جنونيةٍ قادرةٍ على الإبادات الجماعية، وإيصالِ البيئة لحالةٍ لا تُطاق، باعتبارِ أنهم الآلهةُ الجديدةُ غيرُ المقَنَّعة. وكأنّ «اللوياثانَ » القديمَ بات مسعورا.ً وكأنه ما من شيءٍ Nesne لا يستطيع التحكمَ به أو تمزيقه إربا إربا.ً من المهم الاستيعاب جيدا أنّ النظرَ إلى المواقف الموضوعية الشيئية على أنها المصطلحُ الأكثرُ نزاهةً وشفافية في الأسلوب العلمي قد تَسَبَّبَ في كوارثَ مُهلكِة، وانحرافاتٍ كبرى، بل ومجازرَ مرَوِّعةٍ بما يضاهي محاكمَ التفتيش المتبقيةِ من العصور الوسطى. يجب التشديد، وبعناية، على أنّ الموقفَ الموضوعي ليس مصطلحاً علمياً نزيهاً على الإطلاق. تحولَت السلطةُ في الحداثة إلى ساحةِ حربٍ دائمة، سواءً داخلَ المجتمع، أو فيما بين المجتمعات، كأمرٍ واقع )إذ لم يَعُدْ ثمةَ معنى للتفريق بين الدولة والمجتمع(. وعبارةُ هوبز «إنها حالةٌ من حربِ الكل ضد الكل »، والتي قالها في مجتمعِ ما قبلِ الرأسمالية، تصبح أكثر تأثيراً وشيوعاً في ظلِّ الحداثة الرأسمالية. وما الإبادات العرقية سوى ذروةُ هذه الحروب.
لن نتجاوز حدودنا بالزعم بأننا نحن الذين نبتدئ بالأسلوب وبالنظام العلمي مجدداً. ولكني عملتُ في كلِّ المواضيع التي حاولتُ تناولها، على الإشارة إلى وجودِ بعض الأمور التي تجري في مسارٍ خاطئ، والتنويهِ بالتالي إلى أنَّ السببَ في ذلك ذو منبعٍ براديغمائي. وأُشَدِّدُ بأهميةٍ بالغة على عدمِ النظر إلى محاولاتي في التفسير والتطبيق وكأنها تأسيسٌ لنظامٍ جديد بديلٍ من الجذور، ولا رؤيتِها على أنها تفنيدٌ كاملٌ )النهليستية – العدمية( لما انتقدتُه. وفي نهايةِ المآل، من المُهِمِّ بمكان انتقادَ الحداثة الرأسمالية المتسبِّبة بالملايين من المآسي والحوادث المشابهة لوضعي أنا )المجازر والإبادات العرقية والحروب التي لا تحصى(. وأخص بالذكر ضرورةَ شرحِ جميعِ المؤثرِّات والعوامل الواجبِ اعتبارَها المسؤولةَ الأولى عن المرحلة الأكثرِ ظلماً ومأساويةً في التاريخ، والتي يمر بها الشعب والمنطقة اللذَين أنتمي إليهما )الكرد والشرق الأوسط(. فشرحُها بجدارةٍ وبما يليق بالشعب والمنطقة، إنما يُعدُّ من أبسط الشروط وأدناها لأنْ يكونَ المرءُ متنورا.ً كَم هو مؤسفٌ أنَّ الحداثةَ ليست سوى صورةُ حياةٍ مُنشأةٍ على أساسِ الظواهرية. أَستَخدِمُ لفظَ «صورة » عن وعي. ذلك أنَّ الحداثةَ متعلقةٌ بأكثرِ أشكالِ الحياة سطحيةً، لا بجوهرِها. وما مقولةُ أدورنو «الحياةُ الخاطئةُ لا تعُاش بصواب »، والتي ذكرَها وعَجِزَ عن تحليلها؛ سوى محصلةٌ لخيبةِ الأمل والقنوطِ الذي ألمَّ به تجاه الإبادةِ العِرقية لليهود. في هذه العبارة يكمنُ مِربَضُ الفرس، إلا أنها تفتقرُ للإيضاح. أين هو الخطأ الأوليُّ في الحياة؟ مَنِ المسؤولُ عن الحياةِ الخاطئة؟ كيف أُنشِئت؟ وما صلاتُها بنظامِ المجتمعِ المهيمن؟ ما مِن ردودٍ على مِثلِ هذه التساؤلات، بل اكتفَوا فقط بإرجاعِ جذورِها إلى مرحلةِ التنوير والعقلانية، في حينِ أبقَوا على الموضوع – أي، شكلِ الحياةِ الخاطئة – يكتنفه الغموضُ ويَلُفُّهُ الظلام.
محال البتةَ العيشُ بشكلٍ مشترك ومتداخلٍ في نطاقِ ثنائيةِ: إما الحياةُ الحرة أو الإبادةُ الجماعية وثمةَ ما تَعَلَّمناه من العلومِ بحالتها المشتتَّةَ والمُجَزَّأة، رغمَ انتقاداتنا لها.
النفاذُ والانعتاق من طوق وحصارِ قُوى رأس المال – العِلم – السياسة؟ إنّ هذا السؤالَ، الذي طالما بَحَثَ فلاسفةُ الحرية عن جوابٍ له، بدءاً من نيتشه إلى ميشيل فوكو ، ليس من النوع الممكنِ الإجابة عليه بهذه السهولة. علينا تفهُّم هؤلاء الفلاسفة الذين لَم يحتملوا الحداثة ) «المجتمع المخصيّ » و »موت الإنسان »(، فقضت عليهم. فمعسكراتُ الموت، القنبلةُ الذرّية، حروبُ التطهير الأثني، دمارُ البيئة، البطالةُ الجماعية، تضييقُ الخناق على الحياة بشكل متطرف، تفشي السرطان وغيره من الأمراض كالأيدز؛ إنما تدل على صحةِ تلك الأحكام، بل وتجعل من البحوث عن الحقيقة المضادة مَهَمَّةً ضرورية ومُلحِّةً.
الإله الدولتي القومي لم تُطَوِّر الرأسماليةُ العلمَ، بل استثمرَته. ولا يقتصر ذلك على تمَخُّضِها عن أشنع الأوضاعِ أخلاقيا،ً بل يعُمِّمُ ظواهرَ هيروشيما ، ويَقضي على الحياةِ القَيِّمة. فهل الحياةُ الإعلاميةُ والتشابهُ والتقليدُ انتصارٌ للعلم؟ أم أنها انتهاءُ المعاني في الحياة؟ لا أتحدثُ هنا عن التكنولوجيا والاكتشافاتِ والاختراعات العلمية، بل أسعى لتبيانِ عدمِ كونِ المدرسةِ الوضعية علماً، باعتبارها دينٌ علموي. من هنا، وبدون الخلاصِ من هيمنةِ وسيادةِ العلمية الوضعية، لا يمكن النجاةَ من نفوذِ وتسلطِ أيةِ سلطة، وفي مقدمتها الدولة القومية. فالمدرسةُ الوضعية هي الدينُ الوثني الحقيقي لعصرنا.
يُمكِنُ تعريف ذهنيةِ الرأسمالية من عدةِ نواحي. وأولُ ما علينا عملُه هو تعريفُها بِكَونِها تعني الليبراليةَ والوضعية، من جهةِ كونها توفيقيةٌ متمفصلة، تَأخُذُ شكلَ كلِّ القوالب، محفوفةٌ بخطرِ الخداع، فهي دوغمائيةٌ وثوقيةٌ أكثرَ من العقائدِ والقوالبِ الدينية الأكثرَ صرامةً، وأكثرُ هذياناً من الفلسفاتِ الأكثرِ تَجَرُّداً، مضارِبةٌ، ووثنيةٌ ضحلةٌ سقيمةٌ لدرجةٍ لم تَقَع فيها حتى الوثنيةُ بذاتها. وبينما تُخصي العِلمَ وتغتصبه عبر المدرسةِ الوضعية، فتُبرِزُه مقابلَ عالَمِ العقائد والأخلاق، فهي، ومن خلالِ الليبرالية، تصُيرِّ الدولةَ القوميةَ إلهاً ينخر المجتمع، ويُصَعِّدُ من الفرديةِ لدرجةِ ارتكاب الإبادة. لم توُلدِّ أيةُ ذهنيةٍ دينيةٍ الحروبَ والقمعَ والتعذيبَ المبرح، بقدرِ ما فَعَلَت ذهنيةُ الرأسمالية. ولم يُوَلِّد أيُّ مجتمعٍ فرداً يماثلُ ما عليه ذهنيةُ الفردِ في المجتمعِ الذي انتصرَت فيه الرأسماليةُ، والمتسمةُ بهذا القدرِ من اللامبالاةِ، الانجرارِ الجَشِعِ وراءَ المصالحِ، الظلمِ، الإبادةِ العرقية، الصهرِ، والديكتاتورية.
والرأسماليةُ، باعتبارها النظامُ الاحتكاري المؤسَّسُ على دعائمِ دنيا المالِ والسلع، تُنشِئُ الذهنيةَ الماليةَ المعاصرة، لِتُقَيِّدَ المجتمعَ البشريَّ بقوالبَ ذهنيةٍ لا يمكنُ أنْ تَخطُرَ على بالِ أيِّ نمرودٍ أو فرعون؛ وبينما تَزُجُّ الإنسانيةَ العالميةَ للسجود أمام أوطأِ الأوثانِ سفالةً، فلا يمكننا حينذاك سوى الحديثُ عن الإفلاسِ الذهني وفسادِه وتفسخِه.
إنّ اصطلاحَ الربحِ – الأجرةِ على الصعيدِ الاقتصادي، واصطلاحَ البرجوازيِّ – البروليتاري على الصعيدِ الاجتماعي، يعُتبَرَان أولَ خطوةٍ لإضفاءِ الطابعِ العلميِّ على الطرازِ الوضعيِّ لنظامٍ يَصهَرُ في بوتقتِه كلَّ المدخراتِ والتراكماتِ التاريخيةِ للبشريةِ الممزَّقةِ إرباً إرباً على يدِ الرأسمالية، لِيَعُمَّ في نهايةِ المطافِ أرجاءَ المعمورةِ برمتهِا عبر وحشيتهِ المروعةِ في الإباداتِ الجماعيةِ والنووية. أنّ الصناعوية – وعلى عكسِ ما يُعتَقَد – هي الوسيلةُ الأكثر أساسيةً في الهجومِ على الاقتصادِ والمجتمع. كما وهي قوةُ تدميرِ الصناعةِ الحقةِ أيضاً. فنزعةُ النماءِ الصناعيِّ المُسَيِّرةُ وفق جشعِ الرأسماليةِ في الربحِ الأعظميّ، تؤَولُ بالبلدانِ إلى الدمارِ والفقر، لا إلى الرفاه والثراء. وهي تصُيرِّها أطلالاً، أكثر مما تتَركُها تتخبطُ في الأزمة. فوضعُ الدمارِ المُفجِعِ الذي أُسقِطَت فيه أفغانستانُ مع الاستمرارِ بصناعةِ الحشيشِ فيها، والذي أُقحِمَت فيه العراقُ مع تَطويرِ صناعةِ النفط؛ إنما يَكشفُ الحقيقةَ بعلانيةٍ صارخة. ما يُدَمَّرُ ويُصَيَّرُ أطلالاً هنا ليست البلدان فحسب، بل وهو المجتمعُ التاريخيُّ والثقافةُ أيضاً. يعاني النظامُ الرأسماليُّ العالميُّ في ظلِّ هيمنةِ الاحتكارات المالية العالمية من الأزماتِ المشتَرَكةِ الخاصةِ بالتمويل، بقدرِ معاناته من أزمةِ نظامِه العامة. أي أنّ أزماتِ النظامِ العامةَ )تنبع من تضادِّها مع الاقتصاد( والأزماتِ الخاصةَ بالتمويلِ والمالِ )المال الذي يتم تمثيله بمختلفِ الأدواتِ الوَرَقِيَّةِ الافتراضيةِ المنقطعةِ عن الإنتاجِ والذهب، بل وحتى عن الدولار( تسيران بشكلٍ متداخلٍ وفي مرحلةِ الحضيضِ من تاريخها. كان النظامُ قد تخَطَّى أزماته أساسا بطريقَين حتى الآن. أوَّلهُما؛ عبر أجهزةِ العنفِ الماديِّ للسلطة والدولة القومية المتكاثرةِ باستمرار. وهي تشَمَلُ شتى أنواعِ الحروب والسجونِ ومشافي المجانين والمستشفيات والتعذيب والغيتوهات وأخطر أشكالِ الإبادات العرقيةِ والإباداتِ المجتمعية.
ثانيهما؛ عبر التمفصلِ والإرفاقِ المتواصل مع أجهزةِ الهيمنةِ الأيديولوجيةِ الليبراليةِ المُتطَوِّرة. فعلى الصعيدِ الأيديولوجي، هي في المركز مع مُلحَقاتهِا القومويةِ والدينَويةِ والعلمويةِ والجنسوية. أما على الصعيدِ الأداتي، فهناك المدارس، الثكنات، أماكن العبادة، أجهزة الإعلام، الجامعات، ومؤخّرا شبكاتُ الإنترنيت. هذا وينبغي إضافةَ تصيير الفنِّ صناعةً ثقافيةً إلى ذلك أيضاً.
هذا وينُشَأ الاحتكارُ الصناعويُّ واحتكارُ رأسِ المالِ الماليِّ على أرضيةِ الاقتصادِ بالتداخلِ والدعمِ المتبادَل مع احتكارِ الدولةِ القومية. وبتأسيسِ الاحتكارِ القومويِّ في الحقلِ الأيديولوجيّ، يكَُونُ قد اكتمَلَ السياق، وتحَققَّ المجتمعُ المتجانسُ المأمول. وهذا ما مفادُه بالتالي انتصارَ الفاشية. أما اختزالُ الفاشيةِ إلى ممارساتِ هتلر وموسوليني، واعتبارُها وكأنها ظواهرٌ فريدةٌ للفاشية؛ فهو أحدُ أهمِّ تحريفاتِ الأيديولوجيا الليبرالية.
المجتمعُ النمطيُّ مجتمعٌ مارٌّ من الإبادةِ الجماعية.
لقد تمَّ القيام بالعديد من تحليلاتِ الفاشية، لكنّ جميعَها تضليليةٌ بمنتهى السوء، بما فيها تلك التي قام بها الماركسيون، الليبراليون، المحافِظون، والفوضويون.
فجميعُها لا نيةَ أو لا قدرةَ لديها على إيضاحِ ما حَدَثَ بصدقٍ وكمالٍ مُشبعِ. علاوةً على أنّ مُفَكِّري اليهود المذهلين أيضاً – ضحايا الإبادات العرقية – يحتلون الصدارةَ في هذا التضليل. ذلك أنّ هتلر هو قذارةُ تنَوَّرِهم المشترَك جميعاً، و »القيءُ » المشترَك لممارساتهم السياسية. ألا يقُال أنّ «فرخ الغُراب في عينِ أمه كَطَيرِ العنقاءِ الزمردية »؟ أهناك أيديولوجيا أو ممارسة عملية تقول «لقد تقيأَّتُ القذارة ؟» كما أرى حُكمَ الفيلسوفِ الألماني أدورنو وإنْ لم يكَُن حرفيا قَيمِّا وذا معنى، والذي قال ما مفاده مقارِبٌ لذلك باختصار.
الحملةُ الكبرى الثالثة للعولمة )عولمة عصر التمويل(، هي عمليةُ مراقبةِ الأزمةِ والسيطرةُ عليها بعد تعميمها على الزمان والمكان حتى الأعماق. ومع انهيارِ النظام السوفييتي رسمياً في 1989 ، يكَون قد تمَّ الاعتراف بماهيته كدولةٍ قومية، وبدوره في الأزمة الدائمة.
والولاياتُ المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوةَ المهيمنةَ الجديدة بعد 1945 ، والمنتصرةَ في الحرب الباردة، قد أعلَنَت منطقةَ الشرق الأوسط ساحةَ حربٍ استراتيجيةٍ، نظراً لكونها منطقةَ الأزماتِ الأساسيةِ الطويلة المدى للنظام القائم. وإلا، فإلامَ يرَمز إعدامُ صدام، رئيس الدولة العراقية، باعتباره لويس السادس عشر للدولة القومية في الشرق الأوسط؟ إنّ هذا يقتضي نقاشا شاملاً.
إذا ما صِغنا تعريفا أشمل، فسيكَون بالمقدور القول أنّ الدولةَ القومية في عصرِ الحداثة الرأسمالية هي مجموعُ أجهزةِ السلطة المستفحلة ضمن الوجودِ الكلي للمجتمع برِمَّتهِ، واتحاد الأفراد المُسَمّين بالمواطنين ضمن الإطار الحقوقي. المصطلحُ المحدِّد هنا هو ظاهرةُ السلطة المستشرية في المجتمع بأكمله. فشرعيةُ جميعِ الدول التي قبلها كانت مؤطَّرةً بمؤسساتها وكوادرها. لكنّ هذا الإطار يتم خرقه في الدولة القومية. يتجسد صُلبُ الدولة القومية في تدويلِ الأفراد الذين تسعى الدولةُ لتكوينهم بما يتواءم ومصالحَها الأيديولوجيةَ والمؤسساتية والاقتصادية، والذين يسمون بالمواطنين، وكأنّ كلَّ واحدٍ منهم عضوٌ يتمتع بحقوقِ الدولة وواجباتها، له ما لها، وعليه ما عليها.
يحتلُّ تكوين المواطِن مرتبةَ الصدارة بين المواضيع التي تهتم بها الدولةُ القومية بعناية. ولهذا الغرض، فهي تسعى للاستفادة من الكثير من العناصر كالأيديولوجية، السياسية، الاقتصادية، الحقوقية، الثقافية، الجنسية، العسكرية، الدينية، التعليمية، والإعلامية.
الإبادة العرقية المجتمعُ النمطيُّ مجتمعٌ مارٌّ من الإبادةِ الجماعية. فبالتنميطِ يُبتَرُ المجتمعُ من تاريخِه الحقيقيّ، ويُقضى على جميعِ الثقافاتِ المختلفةِ فيه عبر تصوراتٍ أيديولوجيةٍ وهميةٍ جوفاء )دين تصوريٌّ أجوف(. هكذا، وفي الحينِ الذي يُطَبَّقُ فيه قانونُ الربحِ الأعظميِّ على ميدانِ الاقتصاد، يَكُونُ احتكارُ الدولةِ القوميةِ قد طُبِّقَ على السلطةِ أيضاً. ما تحقَّقَ مع الحربِ العالميةِ الثانية، هو بسطُ هيمنةِ إنكلترا وأمريكا وروسيا تجاه هيمنةِ ألمانيا واليابان وإيطاليا. أي إنه تَغلُّبُ أحدِ القطبَين المهيمنَين الاحتكاريَّين على الآخر، وليس انتصاراً للديمقراطيةِ ضد الفاشيةِ مثلما ادَّعَت الليبرالية. حيث هُزِمَ المعسكرُ الألمانيّ، لكنّ الفاشيةَ باعتبارِها شكلَ سلطة، قد وَلَجَت عصرَ توسُّعِ سيادتِها عالمياً. يَكتملُ عصرُ ازدهارِ الحداثةِ الرأسماليةِ وهيمنتِها مع عصرِ رأسِ المالِ الماليِّ المتأخر )السيادة المُحكَمة على الاقتصادِ بعد سبعينياتِ القرن العشرين(، والذي يكتملُ بدورِه مع عصرِ تسليطِ الدولةِ القوميةِ على المجتمعِ المُنمَّط )المارّ من الإبادةِ الجماعية(.
بمقدورِنا النجاحُ في ذلك بتحليلِنا لمصطلحِ الإبادةِ الجماعيةِ بالوصولِ إلى جوهرٍ أكثرَ انتظاماً وأعمَّ نطاقاً. توُلى العنايةُ الفائقةُ للِفَظِ «الفريد » إشارةً إلى الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ اليهود. بينما الحقيقةُ عكسُ ذلك. أي، ما من إبادٍ جماعيةٍ «فريدة ». بل ثمة إباداتٌ جماعيةٌ بين صفوفِ كلِّ مجتمعٍ أو شعبٍ أو دولةٍ قومية، قليلةً كانت أم كثيرة. حيث تُنَفَّذُ في بعضِها جسدياً، بينما تتحققُ بالأغلبِ ثقافياً وبنحوٍ مستور. أما فرضُ التجرُّدِ من التاريخِ والاقتصادِ والإدارةِ والذهنية، فهو مؤثرٌ وتعسفيٌّ جائرٌ بقدرِ الإباداتِ الجسديةِ والثقافيةِ بأقلِّ تقدير.
يعُبرِّ الصَّهرُ عن العلاقةِ أو الممارسةِ الأحاديةِ الجانب، والتي تلجأُ إليها احتكاراتُ السلطةِ ورأسِ المالِ في مجتمعاتِ المدنية، وتُطَبِّقُها على المجموعاتِ الاجتماعيةِ التي أَخضَعَتها لنيرِ العبوديةِ بغرضِ إسقاطِها إلى مستوى امتدادٍ أو مُلحَقٍ بها. إنّ الأمرَ الأساسيَّ في الصهرِ هو تكوينُ عبيدٍ بأقلِّ التكاليفِ من أجلِ آليةِ السلطةِ والاستغلال. حيث يُعمَلُ على تجزيءِ الهويةِ الذاتيةِ وكسرِ شوكةِ المقاومةِ لدى المجموعةِ المَصهورة، بُغيةَ الحطِّ منها إلى مستوى حشدٍ من العبيدِ الأنسب لخدمةِ النخبةِ الحاكمة.
الوظيفةُ الأساسيةُ التي تَقعُ على كاهلِ العبدِ المصهور، هي التشبُّهُ المطلقُ بسيدِه ومُحاكاتُه، وإثباتُ الذاتِ ببذلِ شتى أنواعِ الجهودِ في سبيلِ التحولِ إلى مُلحَقٍ وامتدادٍ له، وتأمينُ مكانٍ لذاته داخل النظامِ القائمِ بناءً على ذلك. ولا خَيار آخر أمامه إطلاقا.ً الخَيارُ الوحيدُ المعروضُ أمامه للتمكنِ من العيش، هو التخلي لحظةً قبلَ أخرى عن هويتِه الاجتماعيةِ القديمة، وتكييفُ ذاتِه بأفضلِ الأشكالِ مع ثقافةِ أسيادِه. لذا، فالمجتمعُ المارُّ من الصهر، يتألفُ من مسوداتِ أناسٍ عديمي الضميرِ والأخلاقِ والذهنية، ويتبارَون ليكونوا الأكثر طاعةً وخنوعاً وعملاً وخدمة. وما مِن قرارٍ يتخذه أو ممارسةٍ يفعلُها بحرية. بل فُرِضَت عليه خيانةُ كافةِ قِيَمِ هويتِه الاجتماعية، واختُزِلَ إلى حيوانٍ بهيئةِ إنسانٍ لا يهرعُ سوى وراء إشباعِ بطنه. هذا وتستخدمُ النخبةُ الحاكمةُ سلاحَين أساسيَّين لفرضِ اللاهويةِ هذه على المجتمعِ المصهور: أولهُما؛ العنفُ الجسديُّ المحض. أي، التلويحُ بسيفِ الإبادةِ والهَلاكِ لدى أبسطِ تمردٍ أو انتفاض. ثانيهما؛ تركُه وجها لوجهٍ أمام المجاعةِ والبطالة. حيث يُعمَلُ على تنفيذِ هذا القانونِ الفولاذيّ:
إذا أصَرَّيتَ على هويتكِ الثقافية، وإذا لمَ تصبحْ خادما كما يشاؤُه سيدُك؛ فإما أنْ يذَهبَ رأسُك، أو تبقى جائعاً!
الآليةُ الأوليةُ التي تُطَوِّرُها النخبةُ الحاكمةُ في سبيلِ ذلك، هي سدُّ جميعِ طرقِ التطورِ البنيويِّ والعقليِّ والثقافيّ، بغرضِ عجزِ مَن يَهتمون أو ينشغلون بكلِّ ما هو معنيٌّ بالثقافةِ المصهورةِ – أياً كانوا – عن إيجادِ أيةِ فرصةٍ للعيشِ في المجتمعِ الرسميّ. ومهما كانت درجةُ الكفاءةِ والمهارةِ لدى الشخصيةِ أو المجموعةِ أو المؤسسةِ التي تَعقِدُ العلاقةَ مع الثقافةِ المصهورةِ وتَرمي إلى إحيائِها، فإنّ جميعَ أبوابِ الدولةِ تُوصَدُ في وجهِها، مثلما تُتَّخَذُ مختلفُ أنواعِ التدابيرِ اللازمةِ لأجلِ طردِها من ميادينِ المجتمعِ الخارجِ عن إطارِ الدولة، سواءً بالأساليبِ السريةِ أم العلنية، المرنةِ أم القاسية. أما الشخصياتُ والمؤسساتُ المهتمةُ بالثقافةِ المصهورةِ بمنوالٍ هاوٍ وغِرٍّ في البداية، ولدى إدراكِها مع مُضِيِّ الوقتِ أنّ الأمرَ لا يقتصرُ فقط على إغلاقِ كافةِ الأبوابِ في وجهِها، بل وقد يتعرضُ وجودُهم الجسديُّ للخطرِ أيضاً في حالِ إصرارِهم على خُطاهم؛ فإما أنْ تنخرطَ بين صفوفِ مجتمعِ الدولةِ القوميةِ المهيمنةِ والصاهرة، أو أنْ تُغَيِّرَ أساليبَها بحثاً عن الخلاصِ في الشخصيةِ المتصديةِ والتنظيمِ المقاوِمِ بفعالية. وثمة عددٌ لا يُحصى في هذا المضمارِ ضمن جميعِ كياناتِ الدولةِ القوميةِ للحداثةِ الرأسمالية. لا تطُبقَّ هذه الآليةُ على الجماعاتِ الأثنيةِ والشعوبِ المسحوقةِ فحسب، بل إنّ المجموعاتِ الأثنيةَ المختلفةَ والطبقاتِ المسحوقةَ من الأمةِ التي تنتمي إليها النخبةُ الحاكمةُ أيضاً تنالُ نصيبَها من الصهر، وتبقى وجهاً لوجهٍ أمام فُقدانِ لهجاتِها الأثنيةِ وقِيَمِها الثقافيةِ الصامدةِ حرةً.