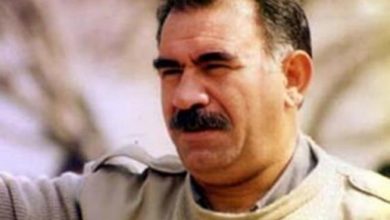في ثالوث الأمة الديمقراطية
في ثالوث الأمة الديمقراطية

 سيهانوك ديبو
سيهانوك ديبو
ملخص
الافتراض الأساسي الذي يقوم عليه الفكر السياسي الغربي بشأن «مركزية البشرية » أو التمركز حول الإنسان، أي أن البشر هم مركز الوجود، وأن من بين البشر يجب أن تكون فئة منهم هي سيدة النوع «البشري » نفسها وهي الحاكمة بأمورهم، فليس من الغريب- وفق نظرية المركز- أن نسمع كلمة شرطي العالم، القطبين، الشمال والجنوب، الشرق والغرب، النواة والأطراف…. وهو ما دمر وشوّه العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية، وبدلا من المحافظة على كوكب الأرض واحترامه واحترام الفصائل المختلفة التي تعيش على سطحه سعى الإنسان – كما وصفه جون لوك- ليصبح «سيدا للطبيعة ومالكها »، ومتملكاً وسلطوياً كما دعا أيضاً، وساعدت الفردية الليبرالية على انطلاق مشروع التراكم الرأسمالي التحديثي بمقاييسه الاقتصادية النقدية بعيدًا عن التكلفة الإنسانية والطبيعية، معطيًا الإنسان الضوء الأخضر للسيطرة على الطبيعة والزعم بالقدرة على معرفة كل أسرارها بالعلم بعد التحرر من الغيب والدين، فتم استنزاف الطبيعة لراحة الإنسان ومصلحته.
إن منطق الذكاء التحليلي في المجتمعات الرأسمالية والذي يُساق وفقه الفرد، هو منطق تسويقي لا أخلاقي، فاعتبار الفرد الأحادي هو مركز المجتمع، وأن كان سعيداً سوف يستطيع اسعاد البشرية وأن كان حزيناً لا يستطيع، وفق هذه التعويذة، تم تشظي المجتمع وتحويله إلى نويّات متخاصمة ومتباعدة، من السهولة أن تنقاد إلى مادة أو عرف يصدر من مؤسسة أو حتى من جمعية، مهما كانت هذه المادة غير أنسية، وخاصة فيما يتعلق بالتوسيمات التي صدرت في حق أمم و أحزاب وأشخاص، وفق هذه الرؤية توجه من توجه إلى الشرق، وفي بدايات القرن العشرين بدأ برسم الخرائط، وتشكيل واقعات اجتماعية، أدخلت هذه التقسيمات في حروب لم تكن حروبها، وبالتالي خلقت نماذج التلويحات المجتمعية، بعد خلق ظاهرة مُصدرة هي ظاهرة الوطنية المفروضة، علما أن الوطنية تشبه التعاقد من الروابط الأولية التي يُتخم منها الروابط فوق الأولية، فيعقد الإنسان فيما بينهم وينحون إلى تشكيل ظاهرة الوطنية، ففي سوريا مثلاً، الجغرافيا، والدولة، والهيكلة، وحتى العدو، تم تصديرها إلى الشعب السوري بالحدود الحالية، فدخل حروبا لم تكن حروبه؛ زُجَّ إليها، وانقاد بلا أدرية، إلى اكمال الجزء الثاني وتأسيس الدولة المفترضة وفق رؤية ورغبة المستعمر الرسام، الدولة المتسلطة بالنزعة القومية والتي أدت إلى تشكيل وعي سليل الوعي الذي يليه فكان زائفاً غير حقيقي، استبدت الدولة المرسومة بعناصر تكونها فخلقت حالة متطورة من التحاجز الاجتماعي، تشتيت مبدأ الهوية السورية، وهذا الأخير مرده التسلط العامودي، وهذا كله ما أثلج صدر الرسام «المستعمر » متيقناً أنه يستطيع في أية لحظة، أن يكون موجودا،ً فكان موجودا في لبنان وفي العراق وفي مصر وفي تونس، وكان موجودا مسبقاً «لم يبرح أمكنته » في دول مثل الخليج.
وتعتبر من أبرز معالم التحاجز الاجتماعي وعدم ظهور ظاهرة الوطنية النوعية، تغييب العنصر الكردي، بعد ابتلاع جغرافيته من قبل مهندسي الخرائط والاتفاقيات الدولية ومن قبل الشخصيات الاقليمية، وبغياب نوعي للشخصية الكردية الوطنية عند وضع الخرائط وتنفيذها على أرض الواقع.
الربيع الساكن تجارب الدولة المفروضة والمطبقة بقوة السلاح ومن ثم بقوة القانون اللامنتمي إلى الشرق كله، جعلت المجتمعات الشرقية المسجونة ضمن الحدود المخطوطة تفقد ما هو متراكم عليها تحت سمة «الوطنية » فتحولت دولها إلى مستبِدة ومستبَدة في الوقت نفسه، مرهونة أمورها بأوامر «الخارجي »، وصوت سياطها على الشعب تطرب لها آذان )السيد العالمي(، وتميزت هذه المجتمعات رغم اختلاف المستعمرين؛ بالآتي:
أولاً، القوة في الرسوم المفروضة استوجبت قوة في الاختيار للعنصر الحامي للحدود، ولكن بعد الزوال الظاهري للقوة الغريبة طفت مباشرة النويات المجتمعية، وكانت بغلبها عابرة للحدود الموجودة، فما جمع العربي والكردي والسرياني، وما جمعت الطوائف في سوريا كان المستعمر، لكن الأداء السيروري إلى ما قبل الوطنية ظهر بقوة، بعد قوة التسلط التي فرضتها الدولة القوموية الناشئة.
ثانياً، ظهور الدولتية القوموية والتي حمت باسم العلمانية، ولم تكن يوماً علمانية، أدى و من خلال ممارساتها إلى ظاهرة التشيؤ الوطني، وكان في حالة املاء مستديمة بقوة وببطش، فحزب البعث؛ فرض أنموذجاً قاهراً للدولتية القوموية في سوريا، فعاش على سورية- وبجرة قلم- فقط من هو عربي، المواطن السوري هو فقط العربي، والجمهورية المستحدثة هي الجمهورية العربية السورية، مما أدى إلى ممارسة وتعويم ظاهرة «اقتلاع العناصر الوطنية »، من خلال متمركزات زُمَرِ الاستبداد إبان مرحلة ما بعد الاستقلال الظاهري غير الملموس وغير المحسوس، مؤدياً وفق المقدمات إلى فشل المجتمعات المحكومة كمن قبل الدولتية إلى نشوء الفعل الوطني المؤدي لظاهرة الوطنية المجتمعية.
ثالثاً، الفشل الوطني يؤدي بالضرورة إلى تشكيل الانقسامات النويّة والمتمثلة في الحالة السورية بالانقسامات الطائفية والعناصر القومية المغيبة بفعل السلطوية، الرغبة في التحول إلى ظاهرة الخروج وتشكيل نموذج جديد يناسبها، وهذا أيضاً أعتبره المرحلة الثالثة التي ترغبها الدول الغريبة شرقياً، في ايجاد مداخل تدخلها في الجسم المتخلع اجتماعياً.
رابعاً، أن الاستبداد وعدم المساواة وغياب قبول الآخر في نموذج الدولتية التسلطية، رأت الحلول التي فرضتها من أجل الحل، إلى نموذج بديل آخر قلق أيضاً هو بديل المحاصصة بعد فشل الانتماء ونشوء ظاهرة الوطنية ، وتسيد ظواهر الأولغيارشية المالية والرأسمالية.
كل هذه المظاهر كانت أسباب نوعية في ظل عدم المساواة والظلم المفروض على غالبية الشعوب الشرقية، كانت أسباب نوعية متقدمة لظهور ظاهرة الربيع، لكن الربيع ظل ساكناً، ولم يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، وعلة ذلك، أسباب كثيرة، لكن أهمها، كانت اللعبة العميقة التي أدركتها أنظمة الاستبداد وطبقتها بحذافيرها مرتين؛ مرة على شعوبها: استجلاب الأمن مقابل تسليم الإرادة وكذلك العقل، ومرة على الدولتية العالمية؛ بأنها لا بديل لها سوى مجموعات إرهابية ستخلفها أمكنتها، وهذا هو الجزء المهم في لعبة التدويل والصراع على السلطة، ولعبة التدويل تعاملت بحذر شديد مع القوى الرافضة الناشئة، فتحالفت بالسر مع الأنظمة المتكسرة، وتحالفت بالعلن مع القوى الناشئة، والنتائج أصبحت أكثر وضوحاً في العام الرابع من عمر حركات الربيع لكن الساكنة.
ما العمل؟ ما هو الحل؟
الأمة الديمقراطية… الحل الأخير للشرق الأوسط الجديد أشير إلى ضرورات الإدارة الذاتية الديمقراطية، كفهم وكنظرية وكممارسة وكجسد يمثل الأيديولوجية التي تختفي فيها ظواهر التفكك؛ وتضمن حالة الانتشاء التمثيلي أو الانتماء الجزئي إلى الكل، فمثلاً الكُرد في الإدارة الذاتية الديمقراطية تكون مضمونة الحقوق وفاعلة في الواجبات، والأسباب التي تؤدي إلى الردة القوموية تختفي فيها الأسباب، وكما يقول أنجلز: أن مجتمعاً تزول فيها أسباب العلة تختفي فيها العلة، والحال ذاته بالنسبة للتعصب القومي والذي يركز واسميه إلى مسألة الحدود فقط والتقسيم فقط، لا يمكن أن يكون هذا هو المدخل المناسب لحل قويم من أجل مشكلة القضية القومية الكردية، بل هو بمثابة الأبواب التي تدخل منها الرياح والأعاصير كلها، والعودة إلى الجذور المؤدية للمشكل الابستيمي للقضية الكردية؛ تتوافق الحلول معها وعلى أساسها، والحل الوطني للقضية الكردية هي في إعادة تفعيل العناصر التي أدت إلى تغيبيها وجعلها قضية بحاجة إلى حل قانوني اجتماعي سياسي واقتصادي ضمن الحل القانوني والسياسي الكبير.
لماذا نتبنى مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية؟
يعكس مفهوم الإدارة الذاتية كمدلول تاريخي جوانب متعددة لحياة بعض المجتمعات الإنسانية – القوميات والمجتمعات العرقية.
وهو المدلول نفسه الذي من أجله تحاول الإدارة الذاتية الديمقراطية أن تخلق حالة مجتمعية تضمن وضعاً ونظرة وفعلاً مستقراً ثابتاً في نظام قانوني واحد وموحد.
وتعتبر الإدارة الذاتية ودلالاتها ذي تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي، لا سيما في المجتمعات التي سبقت وجود الدولة القومية أو الدول ذات الصبغة الدينية، وما نقصده تحديداً المجتمعات والحضارات التي قامت على أسس تبتعد عن كل ظهور فرداني أو فئوي أو قومي أو ديني أو أي مظهر سلطوي يعمد على طمس معالم التكوين المجتمعي. هذا الأمر يكسبه شيئاً من السهولة والوضوح والبساطة نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي كجانب أساسي والجانب القانوني كجانب مبهم، أي ليس حتى اللحظة مدلول قانوني في القانون الدولي ودساتيرها يستفرد على هذا المفهوم الجامع والذي سيحدث لحظة الأخذ به عن طريق إداراته الذاتية الديمقراطية إلى المجتمع الديمقراطي ؛ قطيعة ابستيمية عن الغرب وتقديم قيوده بعد تحطيمها إليه مرة أخرى.
يعتبر مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية كمفهوم سياسي – فلسفي مُحَددٌ بمنطلقات نظرية أهمها:
-1 تمكين نظرية العقد الاجتماعي السوري في أن الإنسان السوري بحاجة مستديمة إلى تفعيل السمة «القوية « والتي يتمتع المجتمع السوري به وبالتحديد التنوع القومي والمذهبي والاثني، مرجع قوي ونمطية أقوى تجعله بحاجة مستمرة أن الإنسان بحاجة قصوى إلى نظيره وبغض النظر عن اللون واللغة والانتماء، فالإنتماء هنا مرتبط بالمرجعية العامة للانتماء وهو الوطن والأمة، فيتخلى الفرد السوري وفق نظرية العقد الاجتماعي السوري عن اللون الواحد واللغة الواحدة. يتخلى لإدارته المتشكلة المعبرة عن كل الألوان.
-2 المنطلق النظري الآخر في مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية هي إعادة التوازن بين عناصر المعادلة السورية )القومية – الوطنية – العالمية(، والتوازن المتحقق في المجتمع الديمقراطي الأعلى يسبب ضبطاً مجتمعياً في الانسياب اليومي والمحقق للذات المتوحدة والمدموجة مع الكل مما يسبب وبشكل أنُسي عدم الانزياح والتفرد والقوقعة.
-3 المنطلق النظري الآخر وهو مأسسة المجتمع الاقتصادي الديمقراطي، بتحويل الفرد المنتمي إلى منتج ضمن تشاركيات اقتصادية من خلال المجتمع الزراعي العضوي، وتحويل ال »GOND « إلى أول خلية فاعلة تحقق للقرية الشرقية «السورية أنموذجا » استقلالية اقتصادية بوجود المزارعين المثاليين والمتخصصين أو من هم بحاجة إلى تخصص ، تحقق هذه الخطوة توازناً ايكولوجياً مرتين: مرة بين المدينة والريف ومرة أخرى الحفاظ على الإيكولوجيا، فالبيئة والطبيعة حتى تكون في خدمة الفرد الذي يعيشها أن يكون خادماً للطبيعة وحامياً بإرادة لهذه الطبيعة.
والمدينة باقتصادها المتكون والتي تمتلئ بشركات مجتمعية تشاركية أيضاً: من غير المعقول أن لا تكون في كل محافظة شركات لتصنيع السكر أو تكرير الزيت أو للرز طالما هناك الإرادة النوعية المستوجبة في إدارة مجتمعية برؤى الاقتصاد التشاركي وخلق الكادر المتخصص وفي كل المجالات.
-4 المرأة وهي العنصر الأكثر فعالية في مجتمع الإدارة الذاتية، فحالات القمع المستديمة بحقها ستخلق لها ردة الفعل الأبرز في تولي مهامها، والدفاع عن حريتها وفاعليتها في المجتمع.
-5 الشباب وهم الحاملون الأساسيين للتغيير، وعلى عواتقهم يتم التغيير المنشود وهم كفئة يكون لهم الاهتمام الأكبر لأنفسهم وللمجتمع الذي يتطلع إليهم كقدرة نوعية ومتمتعة لهذه المهمة أساسا.
-6 المنطلق النظري الآخر هو حق الحماية الذاتية وحق الدفاع المشروع، لن يكون لأي مجتمع قائمة متغيرة وتطور حتى يؤمن جميع أفراده أن الإنسان ومنذ تشكل المجتمع الزراعي الأول أي قبل أكثر من 13000 سنة، كان أبرز عوامل استمراريتها هو الحاجة و الاقتناع أن الإنسان وفي كل المراحل كفرد وجزء مجتمعي يتوجب عليه ممارسة الحماية الذاتية الطبيعية وحق الدفاع المشروع الوطني.
المجتمع الديمقراطي المتشكل من خلال مفهوم و نظرية الإدارة الذاتية الديمقراطية تعتبر حلاً ناجعاً للكرد كمكون أساسي في المجتمع السوري، وكحل لكل سوريا، ومن غير أن نكون مجحفين أن فاعلية «الإدارة الذاتية الديمقراطية تعيد للشرق كله جهته التي افتقدها، وتُبْعِد عنه تبعيته للجهة التي تقابله.
اشكالية المصطلح مرة أخرى في تعريف الأمة الديمقراطية يرى المفكر الكردي عبدالله أوجلان في منحى الأمة الديمقراطية باعتبارها الحل القويم لمشاكل الشرق الأوسط، ومن أجل ضمان فك الارتباط العقدي عن الغرب الذي يجعل من الشرق مطية نفايات مجسمة بالمشاكل المعدة انفجاراً موقوتاً في اللحظة التي يريدها الغرب ذاته، فيراها أنه الحل الديمقراطي الذي يدل على كينونة الأمة الديمقراطية، وعلى ظاهرة إنشاء المجتمع لذاته كمجتمع وطنيّ ديمقراطي. أي إنه لا يعني التحول إلى أمة أو الخروج منها على يد الدولة وإنما الادارة الذاتية التي تستند إلى الأفقية المجتمعية. بل يعني انتفاع المجتمع بذات نفسه من حقِّه في إنشاءِ نفسه كأمة ديمقراطية. والحال هذه، يتعين إعادة تعريف الأمة.
يتوجب أولاً الإشارة إلى عدم وجود تعريف واحد فقط للأمة. فلدى إنشائها بِيَدِ الدولة القومية، فإنّ أعمَّ تعريف للأمة هو أنها أمة الدولة. وإذا كان الاقتصاد هو العامل المُوَحِّدُ لصفوفها، فمن الممكن تسميتُها بأمة السوق. في حين إن الأمة التي يَسُود فيها القانون هي أمةُ القانون. كما وبالمستطاعِ إطلاق تسمياتِ الأمة السياسية والأمة الثقافية أيضاً. أما المجتمعُ الذي يُوحِّدُه الدين، فيُسمى بالأساسِ مِلةّ والأمة الاسلامية دليل ذلك، حيث تمددت دون معرفة مسبقة للحدود الجغرافية الاسلامية، فالدين الاسلامي الذي بدأ في شبه الجزيرة العربية لم تضع نصب عينها أنها وبالضرورة ستصل إلى الصين ومشارف السند وعلى تخوب أوربا الغربية ذاتها، وهنا الجواب لمن يسأل وكأنه وجد تفاحة نيوتن: ما هي حدود الجغرافية في الأمة الديمقراطية؟.
أما الأمةُ الديمقراطية، فهي مجموع القوميات والمذاهب التي تقوقعت بفعل السلطة الدولتية، تتحرر هذه المجموعات من عناصر ارتباطها الأولية وتشكل وفق عقدهم الاجتماعي المجتمعُ المشتركُ الذي يُكَوِّنُه الأفراد الأحرار والمجموعات الحرةُ بإرادتِهم الذاتية.
والقوة اللاحمة والمُوَحِّدة في الأمة الديمقراطية، هي الإرادةُ الحرة والذهنية الثائرة العنصر الأكثر حسماً نحو التطور والانتقال لأفراد ومجموعات المجتمع الذي قررَ الانتماء إلى نفس الأمة.
بينما المفهوم الذي يربطُ بين الأمة والاشتراك في اللغة والثقافة والسوق والتاريخِ، فهو يُعَرِف أمةَ الدولة القومية، مثلاً: مفهوم الأمة العربية، ومفهوم الأمة التركية، والمفهوم المغيب بسبب عدم وجود مسند الدولة؛ الأمة الكردية، وكل ما سبق لا يمكن تعميمها، أي طرحُها كمفهومٍ وحيدٍ ومطلقٍ للأمة. ومفهوم الأمة هذا، والذي يتبنى الاشتراكيةَ المشيدة؛ هو مضاد للأمة الديمقراطية. وإذا ما لاحظنا قول القائد أوجلان: )نخص بالذِّكرِ أنّ هذا التعريفَ الذي صاغَه ستالين بشأنِ روسيا السوفييتية، هو أحدُ أهمِّ الأسبابِ الكامنةِ وراء انهيارِ الاتحادِ السوفييتيّ. وإذ ما لَم يتحققْ تخطي تعريفِ الأمةِ هذا الذي صبغَته الحداثةُ الرأسماليةُ بالطابعِ المطلق، فإنّ حلَّ القضايا الوطنيةِ سيستمرُّ في المعاناةِ من حالةِ تأزمٍ لا مخرجَ منها بكلِّ معنى الكلمة. وكونُ القضايا الوطنيةِ لا تنفكُّ مستمرةً حتى الآن وبكلِّ وطأتِها طيلةَ سياقٍ يمتدُّ لأكثر من ثلاثةِ قرونٍ بأكملِها، إنما هو على علاقةٍ كثيبةٍ بهذا التعريفِ الناقصِ والمطلق(.
وهذا النمط من المجتمعات الوطنية التي قُدِّرَ لها الخضوع لحدود الدولة القومية الصارمة، والتي تغلغلَت السلطة حتى أدق خلاياها؛ كادت تصبح ساذجةً ومغفلةً بقصفها بالأيديولوجياتِ القوموية والدينوية والجنسوية والوضعية. أي إنّ نموذج الدولة القومية بالنسبة إلى المجتمعات، هو مصيدة أو شبكة قمع واستغلال بكل معنى الكلمة. في حين إن مصطلح الأمة الديمقراطية يَقلب هذ التعريف رأساً على عقب. فتعريف الأمةِ الديمقراطية غيرِ المرسومةِ بحدود سياسية قاطعة، وغير المنحصرةِ بمنظور واحد فقط للغُّة أو الثقافة أو الدين أو التاريخ؛ إنما يعَبِّرُ عن شراكة الحياة التي يَسودها التعاضد والتعاون فيما بين المواطنين والمجموعات على خلفية التعددية والحرية والمساواة. هذا ويستحيل تحقيق المجتمعِ الديمقراطي، إلا من خلالِ هكذا نموذجٍ للأمة. في حين أن مجتمع الدولة القومية منغلق على الديمقراطية بِحُكمِ طبيعتِه.
حيث أن الدولة القومية لا تعبر عن واقع مناطقي ولا كوني. بل على النقيض، فهي تعني إنكار كل ما هو كوني أو مناطقي محلي. ذلك أن مواطَنة المجتمعِ النمطي دليل على جعل الانسان الذي يعيش في هذا المجتمع مقيداً بأصفاد صنعت له الدول التي رسمت الحدود قبل مائة عام، و المثير للشفقة أن المطبق بحقهم هذه الحدود انتشلوا هذه القيود وأدخلوا أيديهم وعقولهم فيها. ومقابل ذلك، فالأمة الديمقراطية تمكن من إعادةِ إنشاءِ المناطقيِ والكوني؛ الكُرد مثلا، وتُؤمن للواقعِ الاجتماعي فرصة التعبير عن نفسه وكيف يعيش، وتحقيق الممنوعات التي منعته أن يمارس كنه كينونته طيلة سنوات تغييبه، ولعل أبرز معالم التغييب الكُردية كقومية: ابتلاع الجغرافية أولاً وعلى يد الغريب الغربي؛ وثانيا: التحاجز المجتمعي وهذه المرة على الغريب الشرقي.
والتعريف الأنسب للأمة الديمقراطية هو التعريف المضموم للعناصر التي تؤدي إلى نشوء الأمة الديمقراطية ذاتها، وهذه العناصر أو ثالوث التطور إلى الأمة الديمقراطية: الذهنية والوعي والعقيدة، فيعاد صياغة التعريف إلى مجموعة القوميات والمذاهب والعناصر المجتمعية التي تعيش في بوتقة )متحدة( جغرافياً أو سياسياً، واتحدت بذهنية وبوعي وبعقيدة وتشاطروها على أساس تحقيق المساواة والعدل والحرية وعليه، فحدود الدين واللغة والثقافة والسوق والتاريخ والسياسة ليست مُعَيِّنةً في تعريف الأمة هذا، بل تؤدي دورا مجسِّماً لا أكثر. وتعريف الأمة في الأساس بناء على حالة ذهنية ما، يتسم بطابع ديناميكي.
وفي حل القضية الكردية يقول أوجلان: وفيما يخصُّ حلَّ القضيةِ الكرديةِ أيضاً، فالسبيلُ الأساسيُّ المبدئيُّ والثمينُ والذي لا يستندُ إلى الانفصاليةِ أو العنف، إنما يمرُّ من القبولِ بشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ. وجميعُ الطرقِ عدا هذا السبيلِ تؤدي إلى إرجاءِ القضايا وإمهالهِا، وبالتالي إلى توطيدِ الانسدادِ العقيمِ أكثر، أو تفضي إلى تصعيدِ الاشتباكاتِ وحصولِ الانفصال. وتاريخُ القضايا الوطنيةِ عامرٌ بالأمثلةِ على هذا الصعيد. ونَعيمُ بلدانِ الاتحادِ الأوروبيِّ بالرفاهِ والغنى ضمن أجواءٍ يعمُّها السلام خلال العقودِ الستةِ الأخيرة، بعدما كانت مهدَ الاشتباكاتِ والنزاعاتِ الوطنية؛ إنما أصبحَ ممكناً بقبولِها لشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، وبتطويرِها المواقفَ والممارساتِ المرنةَ والخلاّقةَ لحلِّ قضاياها الإقليميةِ والوطنيةِ وقضايا الأقلياتِ لديها. أما في الجمهوريةِ التركية، فالعكسُ هو الذي سرى. فالدولةُ القوميةُ المُرادُ إكمالُها وتتويجُها بسياسةِ الإنكارِ والإبادةِ بحقِّ الكرد، قد زجّت الجمهوريةَ في معمعانِ إشكالياتٍ ضخمةٍ لا تُطاق، وأقحمَتها في أجواءٍ من الأزماتِ المتواصلة، والانقلاباتِ العسكريةِ التي يُلجَأُ لها كلِّ عشرِ سنوات. وعليه، فلن تستطيعَ الدولةُ القوميةُ التركيةُ بلوغَ الرفاهِ والسعادةِ والغنى، أو ترسيخَ أجواءِ السلامِ الوطيدِ كجمهوريةٍ علمانيةٍ وديمقراطيةٍ طبيعيةٍ قانونية؛ إلا تماشياً مع مدى تخليها عن كلِّ ضروبِ سياساتِها الداخليةِ والخارجيةِ تلك، وتراجُعِها عن ممارساتِ نظامِها ذاك، واعترافِها بشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ لجميعِ الثقافاتِ عموماً )بما في ذلك الثقافتان التركمانيةُ والتركية(، وللوجودِ الثقافيِّ الكرديِّ على وجهِ الخصوص.
طريقُ الحلِّ الثاني لشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، هو تطبيقُ مشروعِه بشكلٍ أحاديِّ الجانبِ ولا يعتمدُ على الوفاقِ مع الدولِ القومية. حيث يطبِّقُ أبعادَ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيِّ على أرضِ الواقعِ بمعناها العامّ، مُؤَمِّناً بذلك حقَّ الكردِ في التحولِ إلى أمةٍ ديمقراطية.
لا جدالَ أنه في هذه الحالةِ ستزدادُ الاشتباكاتُ حِدّةً مع الدولِ القوميةِ الحاكمة، التي لن تعترفَ بطريقِ التحولِ أحاديِّ الجانبِ إلى أمةٍ ديمقراطية. ومقابلَ هجماتِ الدولِ القوميةِ فُرادى أو جَمعاً )إيران – سوريا – تركيا(، فإنّ الكردَ في هذه الحالِ لن يَجِدوا أمامَهم خيارا سوى «الانتقال إلى وضعِ الحربِ والنفيرِ العامِّ بهدفِ صونِ وجودِهم والعيشِ بحرية ». ولن يتقاعسوا عن تسخيرِ قواهم الذاتيةِ في تحقيقِ وتطويرِ تحوُّلِهم إلى أمةٍ ديمقراطيةٍ بكلِّ أبعادِها على خلفيةِ الدفاعِ الذاتيّ؛ إلى أنْ تُفرزَ الحربُ وفاقاً ما، أو يتوطَّدَ الاستقلال.
في مفهوم الإيكولوجيا المجتمعية أول افتراض في المفهوم البيئي أن الأنظمة البيئية ليست «مغلقة »، ولا تكفي نفسها بنفسها بصورة مطلقة، فكل نظام بيئي يتفاعل مع غيره من الأنظمة الأخرى، والعالم الطبيعي يتكون من شبكة من الأنظمة البيئية أكبرها المنظومة البيئية العالمية التي شاعت تسميتها ب »المجال البيئي eco-sphere» أو «المجال البيولوجي .bio-sphere » وقد غيّر التطور العلمي لعلم البيئة المفهوم عن العالم الطبيعي، ووضع الإنسان من المفهوم الذي يجعل الإنسان «سيدا » على الطبيعة إلى تصور يرى عكس ذلك، فالبشرية في الحاضر تواجه احتمال وقوع كارثة بيئية يعود السبب فيها تحديدًا إلى أن الإنسان في ملاحقته العمياء والمندفعة للثروة المادية أخل «بميزان الطبيعة »، وهدد الأنظمة البيئية التي لا يمكن للحياة البشرية أن تقوم إلا بها.
وعنصر المرأة أكثر حفاظاً على الطبيعة؛ لأنها الأم حاملة قيم الرعاية والرحمة، وهو ما يؤدي إلى مركزية الأنثى في النهاية. أي أن المرأة ستحرر نفسها من الثقافة البطريركية الأبوية الذكورية إذا تحالفت مع «طبيعتها الأنثوية .»
والمفهوم الذي يربط المرأة بالطبيعة ليس بجديد، فطالما صور علماء الاجتماع أن العصر الأمومي صورت الأرض والقوى الطبيعية كإله، وقد أحُييت هذه الفكرة من جديد في ممارسات الإيكولوجيين الاجتماعيين ومن بينهم المفكر أوجلان. ومؤيدو الحركة النسائية المحدثون يبرزون القاعدة البيولوجية لقرب المرأة من الطبيعة في حقيقة حملها للأطفال وإرضاعهم، كما يشكل التصاق المرأة بالإيقاعات والعمليات الطبيعية توجهها السياسي والثقافي.
ومن ثم تتمثل القيم «الأنثوية » التقليدية في مبدأ المعاملة بالمثل والمشاركة والتنشئة، وهي قيم «لينة » ذات طابع بيئي، وإذا كانت ثمة رابطة «حتمية » أو «طبيعية » تربط بين المرأة والطبيعة؛ فلأن علاقة الرجل بالبيئة تختلف اختلافًا شديدًا، فبينما المرأة تعتبر كائنا طبيعيا يعد الرجل كائنا ثقافيا، فعالم الرجل صناعي من صنع الإنسان، وهو نتاج الإبداع البشري لا الإبداع الطبيعي؛ إذًا يتقدم الفكر في عالم الرجل على الحدس ترتيبا، وتتفوق القيمة المادية على الروحانية، كما يكون الاهتمام بالعلاقات الميكانيكية أكثر من العلاقات الكلية.
لما كان رفض السلوك الأناني والطمع المادي أحد الموضوعات الثابتة في المذهب البيئي، فقد سعى هذا المذهب إلى تقديم فلسفة بديلة تقوم على الرضا الشخصي والتوازن مع الطبيعة. وبالفعل يشيع ربط نمو الاهتمام بالموضوعات البيئية. وعليه فإن الفلسفة الاجتماعية البيئية تنقسم إلى ثلاثة حقول رئيسية:
- الأول هو الأخلاق البيئية، التي تركز على الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه الكائنات الأخرى، وتجاه النطاق الحيوي ككل، إلى جانب، وبالتوازي مع، الالتزام الأخلاقي بين البشر تجاه بعضهم بعضًا.
- الحقل الثاني هو الإيكولوجيا الجذرية، التي تتضمن، بدورها، جدلاً واسعًا بين الإيكولوجيا العميقةdeep ecology ، التي تنتقد مفهوم «المركزية البشرية anthropocentrism » وتعتبره أساس الأزمة البيئية، وبين النسوية الإيكولوجية التي تعتبر أن البطريركية والتراتبية، التي ترى النساء والأطفال والطبيعة في منزلة أدنى، مترافقةً مع الهيمنة، هما مسبِّبا هذه الأزمة. يجمع بين هذين الاتجاهين نقدٌ واسع الطيف لمنتجنا الثقافي التاريخي والآني.
- الحقل الثالث هو الإصلاحية المتمركزة بشريًّا. والمنظِّرون لها يرون إمكانية كبح الممارسات البشرية الجائرة عبر سنِّ تشريعات جديدة وتغيير السياسة العامة وما إلى ذلك، دون الحاجة إلى «ثقافة ثورية » أو إلى تبدلات في النظرية الخلقية المتمركزة بشريًّا.
ووفق ما تقدم نستطيع تعريف الإيكولوجيا المجتمعية في الأمة الديمقراطية: أنه نموذج لفك هيمنة الطابع السلطوي والذكوري وبالتالي اتباعها من سيطرة المجتمع بالدولة. والسلطة التي تنشأ بفعل الدولتية – القوموية تلحق الضرر بالمحيط الحيوي أيضاً، وتتعمد على اخضاع البشر للظلم الاجتماعي على نطاق واسع.
*لا يمكن أن تقسيم المحيط الحيوي والذي يشكل الإنسان جزءاً منه وليس سيده إلى طبيعي بشري وطبيعي جامد. ونحن البشر جزء من العالم الطبيعي ونحن الذي نلحق الضرر من خلال قدراتنا على شعوذة الرمز «طبيعة ثانية .»
*الرأسمالية والحداثة الرأسمالية تتسلط من خلال مفاهيم التملك فقط، وبالتالي تنظر إلى الطبيعة على أنها الجزء الذي يستطيع تسخيره من أجل الربح فقط، وهذا هو الدمار الذي سينهي البشرية نفسها بعد استنفاذ الطاقة الخلاقة في الطبيعة.
* لا تتمثل أزمة عصرنا بظهور المدن، ولكن الايكولوجيا المجتمعية تستدعي أن يكون التوازن بين المدن والمناطق الريفية على حد سواء.
* مرة بين المرأة و الرجل، أي خلل لا يضمن هذا التوازن يجعل الايكولوجيا الاجتماعية في خطر داهم، على الأقل دوام الذهنية السلطوية.
* مرة بين الشيخ والشباب، التوازن يقتضي أن لا يتحول السلطويون إلى سد في وجه الشباب؛ فهم الحامل المهم من أجل التغيير.
* مرة أخيرة بين البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية، فخروج الإنسان من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع الوضعي كان عبر عقد اجتماعي وضعه الإنسان الحر، ووفق هذه العقد الاجتماعي يتوجب الرجوع إلى المجتمع الطبيعي بإرادة وبنوعية.
اسطورة الخلق عند شعب دوغون الأفريقي مع العلم أنه توجد المئات من التفسيرات التي تخص أساطير الخلق، لكن أغربها وأمتعها كانت عند شعب دوغون ) dogon ( في أرض مالي الحالية، بدأ الأمر منذ البداية مع امما ) Amma ( الذي خلق النجوم من الطين ثم رماهم إلى الأعلى. الشمس كانت كرة طينية ملتهبة تحيط بها حلقات من النحاس. القمر كان أيضاً مثل الشمس ولكن الخالق حماه بالنار فترة اقصر مما فعل مع الشمس. الأرض كانت أيضا قطعة من طين وكانت منطرحة على ظهرها، عندما رآها الله ) )Amma قرر أن يضاجعها لتنجب له بشر على شاكلته، نتائج المضاجعة الأولى مع الارض لم يكن توائم كما كان الله يتمنى ولكن ولد لهم ضبع. غير ان الله لم يفقد الأمل، لقد اعاد المحاولة من جديد لتولد له الارض هذه المرة توائم مع بعض اسمهم نومو ) Nummo ( وكانوا لنصفهم على شكل الحية. لقد اعطوا أمهم العارية تنورة من جلدهم، عليها كان مكتوب الكلمات الأولى من اللغة الأولى.
الله )امما( فقد الأمل أن يتمكن من خلق بشر على شاكلته من خلال مضاجعة الأرض، فقرر أن يصنع بنفسه زوج من شبهائه من الطين. أولاد هذه المخلوقات كانوا يخلقون ولهم جهتين أحداهما ذكر والأخرى أنثى.
اسطورة الخلق عند شعب دوغون طويلة للغاية ومعقدة وتفاصيلها يعرفها فقط الكهنة، ولكن جوهرها قائم على توضيح صعوبة خلق إنسان كامل وبدون اخطاء.*
مهما تكن هذه الأساطير ومهما تكن منابعها ومهما تكن دلالاتها، المهم الأهم أن إرادة الخلق؛ الإرادة المجتمعية وعبر ذهنيتها الثائرة والتي تشكل الوعي المسئول من خلال البراديغما الثورية. من خلال الثالوث الأيديولوجي يتم التحول إلى الأمة الديمقراطية محدثة ضجة تشبه القيامة البشرية، وهذه المرة في الشرق الأوسط ليكون له مرة أخرى المكانة التي فقدها، والمكانة التي تصبح كرتنا الأرضية أكثر توازناً وأكثر فاعلية وتتحرر فيها كل المكونات القومية والدينية حتى الوصول إلى المجتمع الأخلاقي – الإيكولوجي في الأمة الديمقراطية.
المراجع
-1 مايكل زيمرمان )محرِّر(، الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية، بترجمة معين شفيق رومية، سلسلة «عالم المعرفة 333-332 » ، طبعة 3، 2006 .
-2 معين رومية، «اخضرار الفلسفة »، معابر، شباط، 2007 .
-3 عبدالله أوجلان، القضية الكردية و حل الأمة الديمقراطية، ترجمة : زاخو شيار، مطبعة روناهي، نيسان 2013
4* حمدي الراشدي، أسطورة الخلق عند مختلف الأديان، مقالة نشرت في 9 آذار 2014 في موقع الذاكرة الالكتروني.