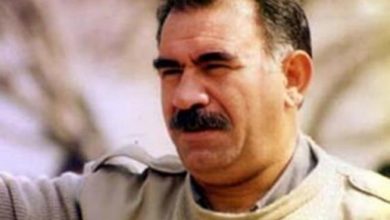موجز التكون التاريخي للحقيقة الكردية:
موجز التكون التاريخي للحقيقة الكردية:
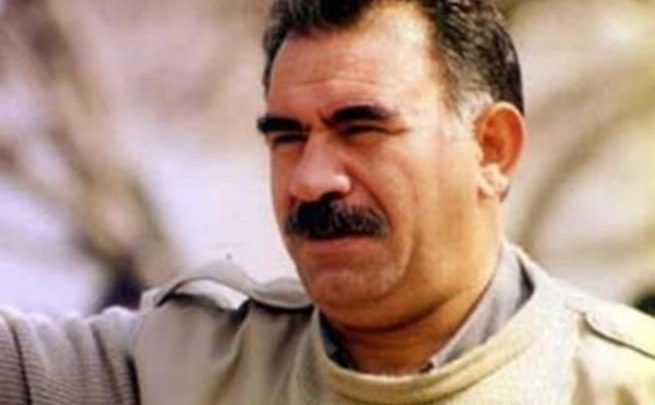
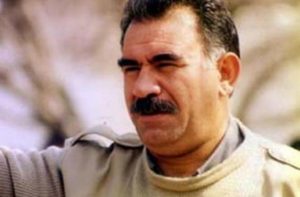
- عبدالله أوجلان
الكردايتيةُ ليست واقعاً يقفُ بثبوتٍ دائمٍ في التاريخ. بل تُطَوِّرُ وجودَها مارةً بالتحولات، مثلما هي كلُّ ظاهرةٍ اجتماعية. أما تحوُّلُها في حالتِها الراهنة، فأشملُ وأسرعُ بكثير. حيث أنّ الظاهرةَ الكرديةَ تَشهدُ في يومِنا الحاليِّ سياقاً انشراحاً واتضاحاً متعددَ النواحي. فالتعبيرُ الفنيُّ هو طرازُ التعبيرِ الأكثر بروزاً في هذا المضمارِ بنحوٍ تقليديّ. يَلوحُ أنّ الكردايتيةَ بجانبِها هذا تسعى نوعاً ما إلى التعريفِ بذاتِها عن طريقِ الموسيقى. أي أنّ الموسيقى من أهمِّ أنماطِ التعبيرِ في الحقيقةِ الكردية. هذا وثمة تطورٌ جادٌّ في النمطِ العلميِّ المُبَرهَنِ أيضاً. كما وتدورُ المساعي لإيضاحِ وبرهنةِ الكردايتيةِ بمختلفِ الأساليبِ من خلالِ المصطلحاتِ التاريخيةِ والسوسيولوجية. وانهماكُ الأكاديميين المتخصصين يصبُّ في هذا المنوالِ بالأغلب. زِدْ على ذلك أنّ المواقفَ ذات الأرضيةِ الأيديولوجيةِ تُقدِّمُ مساهماتٍ هامةً في مجالِ التعبيرِ عنها كحقيقة، بالإضافةِ إلى احتوائِها مزيداً من الأهدافِ التحرريةِ بين ثناياها.
ما من ريبٍ في أنّ الطابعَ الطبقيَّ لكلِّ أيديولوجيا، يتسمُ بنصيبٍ من الحقيقةِ يتفِقُ وإياه. كلُّ نموذجٍ يُشيرُ إلى جزءٍ من الحقيقةِ القائمة، مهما حاولَ إيضاحَ الحقائقِ بمفردِه. فالظاهرةُ الاجتماعيةُ بِحَدِّ ذاتِها تُرغِمُ على ذلك، تماماً مثلما لا يَكفي شرحُ لوحةٍ مؤلَّفةٍ من ثلاثةِ ألوانٍ بالإشارةِ إلى لونٍ واحدٍ فاقعٍ فيها. هكذا، فالمواقفُ أحاديةُ النموذجِ سوف تكَُونُ ناقصةً وضالةًّ على الدوامِ في تمثيلِ الحقيقةِ القائمةِ لدى إيضاحِها المجتمعَ التاريخيّ. ولدى إضافةِ مستوياتِ المعنى والشكلِ المعقدةِ في المجتمعِ إلى ذلك، فإنّ الاستخدامَ المتكاملَ لجميعِ الأساليبِ المُمَثِّلةِ لنِسَبٍ مختلفةٍ من الصواب، يتحلى بالأهميةِ البارزة.
إنّ طغيانَ الأسلوبِ العلميِّ على راهننا، أَبرزَ إلى المقدمةِ الأحكامَ التي تُفيدُ بعجزِ الأساليبِ الأخرى عن التعبيرِ عن الحقيقة. لكنّ الفوضى العلميةَ المُعاشة، قد كشفَت النقابَ كلياً عن نُقصانِ الأساليبِ التي ترتكزُ إليها. ذلك أنّ الأسلوبَ العلميَّ بالتحديدِ يُشَكِّلُ عائقاً هاماً منتصباً أمام استيعابِ الحقيقة. كما وتتجلى تدريجياً روابطُ الأسلوبِ العلميِّ مع السلطةِ والأيديولوجيا المهيمنةِ في نظامِ المدنيةِ الغربية. من هنا، فاستخدامُ المواقفِ الانفراديةِ والكونيةِ معاً بشأنِ الحقيقة، هو من ضروراتِ طبيعةِ تَحَقُّقِ الوجود.
- الكردُ وجودا ونشوءا:ً
يتضمنُ تشخيصُ وجودِ الكردِ وتعريفُه بالأساليبِ التاريخيةِ المألوفةِ مشقاتٍ عديدة. فالجغرافيا التي قطَنوها، والتواريخُ التي مروا بها، قد أثَرَّت بحِِدةٍ في نشوئهِم، وأرَغَمَتهم على البقاءِ على هامشِ الحياة. والبحوثُ الأخيرةُ تُشيرُ إلى أنّ ظهورَ الهوموسابيانس– الذي يعَُدُّ جَدَّ الإنسانِ الحاليّ – إلى الساحةِ خلالَ الثلاثِ مائةِ ألفِ سنةً الأخيرة من تاريخِه على وجهِ التقريب، وارتقاءَه بنفسِه ليصيرَ نوعاً سائداً؛ قد حَصَلَ وتكاثَف في الهلالِ الخصيب )في الأراضي التي تشَغلُ كردستان الحاليةُ مركزَها، والتي تَقطنها غالبيةُ الكرد(. ومرحلةُ الهوموسابيانس تزامَنتَ مع ولادةِ اللغةِ الرمزيةِ من تاريخِ النوعِ البشريِّ الذي شُخِّصَ عمرُه بما يزيدُ عن ثلاثةِ ملايين عاماً. من هنا، فثورةُ الهوموسابيانس التي احتَلَّت منزلةَ الصدارةِ تماشياً مع رُقِيِّ اللغةِ الرمزية، تقتضي تعاطياً أكثر جذريةً للتاريخِ الساري في الهلالِ الخصيب. هذا وبُرهِنَ بالبحوثِ الجينيةِ أيضاً أنّ ثورةَ الهوموسابيانس قد تركَّزَت في هذه المنطقة. فانقضاءُ الحقبةِ الجليديةِ الأخيرةِ قبل عشرين ألفِ سنة، وانحسارُ الجليدِ قد مَكَّنا من ظهورِ الثورةِ الزراعيةِ النيوليتية. وباتحادِ الغطاءِ النباتيِّ الوفيرِ للأراضي وغِناها الحيوانيِّ مع القوةِ الفكريةِ للهوموسابيانس، فإنّ الانتقالَ إلى مجتمعِ الزراعةِ – القرية، والذي يعُتبَرَُ أكثرَ الثوراتِ جذريةً وغورا في تاريخِ البشرية؛ قد مَهَدَّ السبيلَ أمام تطوراتٍ عظيمةٍ في الهلالِ الخصيب.
إنّ النقلةَ المُعاشةَ في اللغةِ والفكرِ مع ثورةِ الزراعةِوالقرية، قد فتحَت السبيلَ أمام تشكيلاتٍ اجتماعيةٍ لَم يَكُن لها نظيرٌ في عهدِها. وتشكلت المجموعاتُ الهندوأوروبيةُ كمجموعةٍ لغويةٍ – ثقافيةٍ سائدة )لقد سُمِّيَت خطأً بهذا الاسم، والأصحُّ هو تسميتُها بالمجموعة اللغويةِ – الثقافيةِ الآرية(. في حين بالمقدورِ تعريفُ أصولِ الكردِ الحاليين بأنها الخليةُ النواةُ للمجموعاتِ الهندوأوروبية. والبحوثُ الجاريةُ بصددِ اللغةِ والثقافةِ الكرديتَين، تَطفو بهذا الواقعِ إلى السطح. وجغرافيا الحياةِ وتاريخُها أيضاً يؤيدُ صحةّ ذلك أكثر. وما «كوباكلي تبه » التي نقَبَّتَ البحوثُ في بقاياها مؤخَّرا،ً وكَشَفَت عن دورِها المحوريِّ كمركزٍ لأقدمِ قبيلةٍ ودينٍ يَمتدُّ بجذورِه إلى ما قبل اثنتيَ عشرةَ ألفِ سنة؛ سوى أمثلةٌ هامةٌ لإثباتِ جدارةِ وقوةِ تلك الثقافةِ القائمة. إذ لَم يُعثَرْ على مثالٍ عريقٍ وضاربٍ في القِدَمِ كهذا في أيٍّ من بقاعِ العالمَ الأخرى. ولدى تقييمِ قوةِ الدينِ والقبيلةِ التي لا تنفكُّ مؤثرةً ونافذة، فسيُلاحَظُ أنّ التاريخَ والجغرافيا اللذَين تَستندُ إليهما يتميزان بمنزلةٍ مُعَيِّنةٍ فيها. فبقدرِ ما يتأثرُ مجتمعٌ ما بالتاريخِ والجغرافيا بنحوٍ طويلِ المدى وعميقِ الأثر، تَكُونُ محليّتُه وأهليّتُه قويةً ودائمةً بالقدرِ نفسِه. والتأثيراتُ القويةُ والراسخةُ قد تصُيرِّ المجتمعَ في أحداثِها التاريخيةِ اللاحقةِ تعصبياً ومتزمتاً أيضاً. وإذا كُنا لا نَبرحُ نستطيعُ رَصدَ المزايا العريقةِ والمحليةِ للكرد، فمن الواجبِ الحديثُ هنا عن التأثيراتِ القويةِ والدائمةِ الكامنةِ في ركيزةِ هذا الواقع. لا ريب أنّ ظاهرةَ التحولِ إلى شعبٍ لمَ تتكونْ بعدُ في العهدِ النيوليتيّ. بل نَشهدُ ولادةَ المجتمعِ القَبَلِيِّ آنذاك. فالعشيرةُ تطورٌ ثوريٌّ عظيمٌ قياساً بمجتمعِ الكلان.
هذا وبالإمكانِ نعتُ الثورةِ النيوليتيةِ بالثورةِ القَبَلِيّةِ أيضاً. فقد بدأَ اختلافُ اللغاتِ والثقافاتِ إلى جانبِ العلاقاتِ شبهِ المستقرةِ – شبهِ البَدَوِيّةِ بالنماءِ والازدهارِ في المجتمعِ القَبَلِيّ. وما المركزُ الدينيُّ في كوباكلي تبه سوى كعبةُ عصرِه، تَقصدُها القبائلُ التي تَعيشُ الاستقرارَ والترحالَ بنحوٍ متداخلٍ مدى آلافِ السنين. لذا، لا يُمكنُ الاستخفافُ بنصيبِ هذا الواقعِ في بروزِ العواطفِ الدينيةِ التي لا تنفكُّ راسخةً متينةً لدى الكردِ عموماً وفي أورفا على وجهِ الخصوص. إننا نتعرفُ هنا على وجودِ ثقافةٍ وطيدةٍ تَكَوَّنَت قبل الحضارةِ السومريةِ المدينيةِ بآلافِ السنين، ودامَت آلافَ السنين. كما وتُواجِهُنا في الأحجارِ المنتصبةِ هناك أمثلةُ الكتابةِ الأسبق ظهوراً من أولى حروفِ الكتابةِ الهيروغليفية.
إنّ نَحتَ تلك الأحجارِ قبل اثنتَي عشرة ألفِ سنة، وتحويلَها إلى كتاباتٍ شبيهةٍ باللغةِ الهيروغليفيةِ الرمزية؛ يُعَدُّ مرحلةً تاريخيةً نفيسة.
لَم يُولَدْ المجتمعُ المدينيُّ في مصر وسومر من تلقاءِ ذاتِه. بل إنه ينتهلُ بالتأكيدِ مشاربَه من ثقافةِ ميزوبوتاميا العليا، كما يثُبتُِ هذان المثالان أيضا ذلك. البرهانُ الآخرُ البالغُ الأهميةِ حول مدى رقيِّ الدياليكتيكِ التاريخيِّ في الهلالِ الخصيب، هو سفرُ النبيِّ إبراهيم إلى مصر قبل ما يُخَمَّنُ بحوالي ثلاثةِ آلافٍ وسبعمائةِ عاماً. والثقافةُ المُوَلِّةُ للمدنيتَين المصريةِ والسومرية، هي تلك الثقافةُ اليانعةُ في قوسِ سلسلةِ جبالِ طوروس – زاغروس. المهمُّ هنا هو وجودُ مستوى ثقافيٍّ باهرٍ بعظمتِه، ولا يزال تاركا آثارَه على التاريخِ الاجتماعيّ. من هنا، لا مفرَّ من إسنادِ نشوءِ الحقيقةِ الكرديةِ إلى هذه الثقافة، ما دامَت آثارُ هذا المركزِ الثقافيِّ لا تُعاشُ بكثافةٍ ملحوظةٍ بين الكرد، وما دام هذا الشعبُ لا ينَفكُّ يواصلُ سيرورتهَ بوصفِه أقدمَ الشعوبِ الآهلةِ في هذه الأراضي. بدأ المجتمعُ القَبلَيُِّ بالبروزِ قبل حوالي ثماني آلافِ سنة في أراضي سلسلةِ طوروس – زاغروس.
إنها ثقافةٌ عريقةٌ لدرجةٍ وكأنها تُعلنُ عن حضورِها من خلالِ كعبتِها الأولى البهيةِ من جهة، وعبر ثقافتِها الموسيقيةِ الكونيةِ الأولى متجسدةً في الطبلِ والمزمارِ والنايِ من الجهةِ الثانية. فما النايُ والمزمارُ سوى تعبيرٌ فنيٌّ لهذه الثقافة. بينما المركزُ الدينيُّ تعبيرُها الفكريّ.
الواقعُ الكرديُّ ثمرةٌ من ثمارِ هذا السياقِ التاريخيِّ العظيمِ من ناحية، ومشحونٌ من الناحيةِ الأخرى بالأعراضِ الدالةِ على تَسَمُّرِه وبقائِه عالقاً بقوةٍ في هذه الثقافة. لذا، من غيرِ الممكنِ إيضاحُ إصرارِه على البقاءِ شعباً قَبَلِيّاً ثقافياً وعَزوُه إلى وضعِ الدفاعِ عن الذاتِ إزاءَ قوى المدنيةِ وحسب. فلو أنّ تلك الثقافةَ بحِدِّ ذاتهِا لا تمتلكُ جذورا ضاربةً في الأغوار الغائرة، فإما أنْ تتحولَ بذاتِ نفسِها إلى مدنية، أو أنْ تنصهرَ في بوتقةِ المدنياتِ التي نشأتَ في ربوعِها. ونحن شاهدون على آلافِ المجتمعاتِ القَبَلِيّةِ المنصهرةِ بهذا المنوال. والكردُ بجانبِهم هذا مجموعةٌ شعبيةٌ لا مثيلَ لها. وكحقيقةٍ سوسيولوجية، فإذا كان مجتمعٌ ما قد شَهِدَ ثورةً تاريخيةً بنحوٍ جذريّ، فمن العسيرِ عليه ريادةُ ثورةٍ ثانيةٍ كبرى ومختلفةٍ بين ثناياه. واحتلالُ الثورةُ الذاتيةُ التي عايشَها لعالمَه الذهنيِّ والمؤسساتيِّ بنحوٍ تامّ، إنما يلعبُ دورَه في ذلك. فثورةٌ أخرى تقتضي ذهنيةً وتمأسُساً آخر مختلفاً. وهي غيرُ واردةٍ إلا بين الثقافاتِ من الدرجةِ الثانية، والتي تُشَكِّلُ الأطرافَ قياساً بالمركزِ الثقافيِّ الوطيد. وجميعُ المُعطَياتِ التاريخيةِ تُشيرُ إلى أنّ الثورةَ الزراعيةَ المعَمِّرةَ حوالي أربعةَ عشر ألفِ سنة قد تَرَكَت بصماتِها الثابتةَ في الثقافةِ الكرديةِ المستقرة، وليس فقط ثورةُ الهوموسابيانس المعَمِّرةُ ثلاثمائة ألفِ سنة. والخرائطُ الجينيةُ تُبَرهنُ أنّ نوعَ الهوموسابيانس والثورةَ الزراعيةَ على حدٍّ سواء قد انتشرَ من هذا المركزِ الثقافيِّ صوب أطرافِه وجميعِ أرجاءِ المعمورة.
لهذه الأراضي دورُها المُحَدِّدُ والمصيريُّ في الانتقالِ إلى مرحلةِ الحضارة، ليس على صعيدِ رَصفِ الأرضيةِ الثقافيةِ فحسب، بل ومن حيث رسمِها ملامحَ الحضارةِ وتكوينِها لمضمونِها أيضاً. فالأراضي التي ازدهرَت عليها المدنيتان التاريخيتان الأَوَّليِتّان السومريةُ والمصرية، أي ميزوبوتاميا السفلى ووادي النيل السفليّ، تفتقرُ إلى خلفيةٍ ثقافيةٍ عريقة. فمَناخُها لا يَصلحُ حتى لحياةِ مجتمعِ الكلان. من هنا، فهاتان المدنيتان المتصاعدتان قبل خمسِ آلافِ سنة، إنما هي مَدينةٌ بالفضلِ في أرضيتِها الذهنيةِ والمؤسساتيةِ جمعاء إلى تلك الثقافةِ ذاتِ المسارِ البهيِّ المُعَمِّرِ آلافاً من السنين؛ تماماً مثلما هي عليه المدنيةُ الأوروبيةُ في استنادِها إلى الحضارتَين الإسلاميةِ والصينية، وما هي عليه المدنيةُ الأمريكيةُ في ارتكازِها إلى المدنيةِ الأوروبية. لذا، فأوهنُ نقاطِ علمِ التاريخِ والسوسيولوجيا التي لا تزالُ قائمة، تتجسدُ في عجزِه عن التحليلِ الكافي للجوانبِ النظريةِ والعمليةِ للعلاقةِ بين الثقافةِ والمدنية. ولعدمِ تحليلِ الانتقالاتِ الثقافيةِ والحضاريةِ بين ميزوبوتاميا العُليا وميزوبوتاميا السفلى ووادي النيلِ دورٌ هامٌّ في ذلك. حيث محالٌ عَلمَنةُ التاريخِ والسوسيولوجيا بالأساليبِ التحليليةِ وحسب. بمعنى آخر، محالٌ عَلمَنةُ السوسيولوجيا، ما لَم يُفهَمْ التاريخُ مثلما حدث، وما لَم يُستَوعبْ المجتمعُ مثلما هو عليه.
أما صَونُ الكردِ لوجودِهم بطابعِه الثقافيّ، فيتأتى من قوةِ الثقافةِ التاريخيةِ التي يرتكزون إليها. لذا، يستحيلُ إيضاحُ تفضيلِهم الحياةَ الثقافيةَ على حياةِ المدنيةِ بكونِه تخلفاً ساذجاً أو بدائيةً بسيطة. فالثقافةُ التي عاشوها ليست ثقافةَ مدينةٍ أو طبقةٍ أو دولة، بل هي ثقافةٌ تُعاندُ في التشبثِ بالديمقراطيةِ القَبائليّة، ولا محلَّ فيها للتحولِ السلطويِّ أو الطبقيّ. والعجزُ عن التحكمِ اليسيرِ بالكردِ يُعزى إلى ديمقراطيتِهم الثقافيةِ هذه.
كنتُ سأدركُ بعد أَمَدٍ طويلٍ أنّ حياةَ المجتمعِ المدينيِّ والطبقيِّ والدولتيِّ ليست فضيلةً بل رذيلةٌ وانحطاط. لا شكّ أنّ المفهومَ الرانكَوِيَّ بصددِ الأمة (نسبةً إلى ليوبولد فون رانكه 1795-1886 ) قد أدى دورا رئيسيا أيضا في التأثيرِ على مسارِ فهمِنا للقضيةِ القومية. حيث اعتَبَرنا كينونةَ الواقعِ الدولتيِّ والطبقيِّ والقوميِّ من المزايا الأصلية، عند التفكيرِ بأيما مجتمعٍ منفردٍ بذاتِه. كما وسَقَطنا كثيراً في المواقفِ المثالية، من قبيلِ عدمِ إدراجِ المجتمعاتِ التي تفتقرُ لتلك المزايا إلى لائحةِ المجتمعات. هكذا كنا نُحيطُ الخاصيةَ الأوليةَ للفكرِ القومويِّ الدولتيِّ الغربيِّ بالصفاتِ العالمية. لذا، من الصعبِ علينا تطويرُ مفهومٍ علميّ، ما لَم نُنقذْ رموزَنا وتصوُّراتِنا بشأنِ التاريخِ والمجتمعِ من تلك القوالبِ الدولتيةِ والقومويةِ للهيمنةِ الأيديولوجيةِ الغربيةِ المركز. إذ إننا نغالي في تضييقِ الخِناقِ على ذهنيتِنا التاريخيةِ والاجتماعيةِ في سبيلِ التحولِ إلى أمةٍ ذاتِ دولة. وعادةً ما باتَ إنشاءُ تاريخٍ لكلِّ مجتمعٍ مرهوناً بكينونةِ وصَيرورةِ الأمةِ والدولةِ لديه. وتختلجنا عاطفةٌ وكأننا سنُضَيِّعُ فرصةَ الاندراجِ في لائحةِ المجتمعات، فيما لو لَم نتَّسِمْ تاريخياً بسِماتِ أمةٍ ودولةٍ «قديرة » )أيا كان معناها(. مما لا شائبةَ فيه هو أنّ هذه الذهنيةَ القومويةَ والدولتيةَ المتصاعدةَ كعاملٍ أساسيٍّ للاستغلالِ والتحكمِ لدى الحداثةِ الرأسمالية، تُشَكِّلُ المؤثرَ الأوليَّ المتخفي خلفَ النقصانِ والانحرافِ والعَمى الكامنِ في علمِ التاريخِ والمجتمع. ذلك أنّ ما يطُلقِ العَمى الأسودَ على آفاقِنا بصددِ عِلمِ التاريخِ وعلمِ المجتمع، هو أجهزةُ الاستغلاليةُ والأيديولوجيةُ للهيمنةِ الرأسمالية.
بالتالي، نحن لا نقتربُ من يومِنا الراهنِ نحو تلك المرحلةِ بمفهومٍ قومويٍّ أو دولتيّ، لدى سعيِنا إلى تحديدِ أعظمِ مراتبِ تاريخِ البشريةِ والثقافةِ الاجتماعية. ولا نُنشِئُ القوالبَ بصددِ الكردايتية. بل نهرعُ وراءَ التاريخِ العالميِّ والمجتمعِ الكونيّ.
من هنا، ينبغي الإدراك بأفضلِ وجه، أننا لن نستطيعَ الجزمَ بمكانةِ وموضعِ أيةِ مجموعةٍ منفردةٍ بذاتِها على مسارِ التطوراتِ الجاريةِ في التاريخِ والمجتمع، ما لَم نلتزمْ بالمفهومِ الكونيِّ للتاريخِ والمجتمع. ذلك أنّ النشاطاتِ التي سنُجريها بحقِّ التاريخِ والمجتمعِ المنفردَين، لن تذهبَ أبعدَ من كونِها أحكاماً ذاتية، في حالِ تناوُلِنا إياها بشكلٍ منقطعٍ عن التاريخِ والمجتمعِ الكونيَّين. وإلا، لماذا يتهربُ المدافعون عن الفكرِ الذي يتخذُ المدنيةَ الغربيةَ مِحوراً له من التطوراتِ التاريخيةِ والاجتماعيةِ الكونية؟ ولماذا يَحدُّون أنفسَهم بمفهومِ التاريخِ والمجتمعِ الإغريقيِّ – الرومانيِّ كحدٍّ أقصى؟ جليٌّ جلاءَ النهارِ أنّ منافعَهم في الهيمنةِ الأيديولوجيةِ والماديةِ تلعبُ دوراً مُعَينِّا في ذلك.
علينا ألا نقعَ إطلاقاً في الضلالِ والزيغِ بشأنِ الموضوعِ التالي: مهما كان مجتمعٌ ما يَحيا «الحاضرَ » من دونِ دولة، ومهما كانت مزايا الأمةِ لديه متدنيةَ المستوى؛ فهو لن يتخلص بالتأكيدِ من كونِه جزءاً من التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين. يكمنُ الضلالُ والتِّيهُ في إمكانيةِ البحثِ والتدقيقِ في العديدِ من المجتمعاتِ بنحوٍ منفصلٍ عن التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين.
يستحيلُ فهمُ التاريخُ والمجتمع، بهذه الذهنيةِ المناهِضةِ للعلمِ والمنفتحةِ على شتى أنواعِ الأحكامِ المُسبَقة. علماً أنّ التكاملَ ليس خاصيةً أساسيةً في الطبيعةِ الاجتماعيةِ فقط، بل وفي الطبيعةِ الفيزيائيةِ والكيميائيةِ والبيولوجيةِ أيضاً.
يجب التبيان بعناية أنّ كلَّ الأفكارِ الشاذةِ والهامشيةِ بحقِّ الكردِ تعتمدُ على هكذا أحكامٍ ذاتيةٍ مُسبَقة. فمهما أُقصِيَ الكردُ من التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين في راهننا، إلا أنّهم – وعلى النقيض – ممثلو المجتمعِ القَبَلِيِّ الذي أدى دوراً رئيسياً في كافةِ أطوارِ التاريخِ والمجتمعِ العالميَّين، ابتداءاً من تخطي مجتمعِ الكلان وحتى تطوُّرِ مجتمعِ المدنية )المجتمع المدينيّ، الطبقيّ، والدولتيّ(. إنهم العنصرُ الرئيسيُّ في إنشاءِ الثقافةِ القَبَلِيّة وتأمينِ سيرورتِها. من الخطأِ النظرُ إلى القبيلةِ على أنها ظاهرةٌ اجتماعيةٌ خارجةٌ عن العصرِ أو عفا عليها الزمن. ذلك أنّ القبيلةَ شكلٌ أساسيٌّ للبشرية، ولن يحصلَ تخطّيها في أيِّ وقتٍ من الأوقات. قد تتغيرُ شكلاً ومضموناً، ولكن، من غيرِ الممكنِ إقصاؤُها كلياً من الظاهرةِ الاجتماعية.
كما أنّ شكلَي الكلان والأمةِ في الظاهرةِ الاجتماعيةِ لا يتّصفان بالكونيةِ والتاريخانيةِ بقدرِ ما هو عليه شكلُ القبيلة. لا ريب أنّ شكلَي الكلان والأمةِ أيضاً يتحليان بالخاصيةِ الكونية، ولكنْ ليس بمستوى القبيلةِ من حيث التأثير. فالشكلُ الأوليُّ للإنشاءِ الاجتماعيِّ هو القبيلة. وحتى في عهدِ الرأسمالية، دع جانباً تجاوُزَ القبيلة، فجميعُ الاحتكاراتِ والشركاتِ المهيمنةِ القابضةِ الرأسماليةِ ذائعةِ الصيت، ما هي في نهايةِ المطافِ سوى تنظيماتٌ قَبَلِيّة. قد لا تَكُونُ قبائلَ البدوِ الرُّحَّلِ والمجتمعِ الزراعيِّ المُكَوِّنِ للتاريخ، ولا يمُكنهُا أنْ تكَُونَ كذلك؛ ولكنها قبائلٌ مدينيةٌ في مجتمعِ الأزمةِ والانهيارِ والتضعضع، أي أنها قبائلٌ هرميةٌ ودولتيةٌ واستغلالية.
نصادفُ مِرارا النماذجَ البدئيةَ من أسلافِ الكردِ في علاقاتِ مجتمعِ المدنيةِ السومريةِ مع محيطِهم، ابتداءاً من التاريخِ المكتوب. ونظراً لكونِهم يُشَكِّلون المنبعَ العينَ الذي يستقي منه السومريون، فقد كان السومريون يَصفون شعبَ المناطقِ الجبليةِ في الشمالِ والشرقِ منهم باسمِ الكورتيين، والذي لا يزال يفيدُ بنفسِ المعنى؛ ويُطلِقون تسميةَ العموريين على شعبِ القبائلِ التي في غربيهم عموماً. فالمعنى اللفظيُّ لكلمةِ كورتي تعني «الشعب الجبليّ ». ولدى ذِكرِ الكرديّ في يومِنا الراهنِ أيضاً يجري استذكارُ صفةِ «الجبليّ » كخاصيةٍ أساسية. في حقيقةِ الأمر، يَلوحُ فيما يَلوحُ أنّ الفارقَ بين كورتييّ Kurti العهدِ السومريِّ وكورتييّ Kürti راهننا، هو فرقٌ ربما يعادلُ النقطتَين اللتَين على حرفِ »u« ، لا غير.
فالكردُ الذين يعيشون الثقافةَ القَبَلِيّةَ طيلة آلافِ السنين، لا يزالون الكُردَ القَبَلِيّين الذين تطغى نسبتُهم ضمن عمومِ الشعبِ الكرديّ. ربما يضمّون بين أحشائهِم عددا وفيرا من أبناءِ المدنِ والسهول، وممَّن شَهِدوا التمايزَ الطبقيّ، والمتواطئين مع الدولةِ ومناهضيها أيضاً. لكنّ المُجَسَّدَ الأساسيَّ للكردايتيةِ يتمثلُ في تلك التي تحيا نَسَبَها بقوة، وتطغى عليها المزايا القَبَلِيّةُ التقليدية.
أي أنها الكردايتيةُ القَبَلِيّةُ المِحورية. بينما الكرديُّ المدينيُّ أو الدولتيُّ أو المنتمي إلى الطبقاتِ الحاكمة، غالباً ما يُعَبِّرُ عن كردايتيةٍ انتقاليةٍ منقطعةٍ عن الكردايتيةِ التقليديّة، ومُذعِنةٍ للانصهار. وأنكيدو، الذي تَنصُّ ملحمةُ كلكامش على أنه أولُ كورتيٍّ مدينيٍّ عميل، ربما يَكُونُ أولَ جدٍّ لجميعِ الكورتيين المدينيين والطبقيين والمتواطئين مع السلطة. بينما هومبابا الذي ورَدَ ذِكرُه في الملحمة، هو كورتيٌّ جبليّ. يستميتُ أنكيدو في التوسلِ من كلكامش كي يقتلَ هومبابا الذي خانه. لَكَم يُشبِهُ الكورتيَّ العميلَ الراهنَ بشكلٍ مذهل! إذن، فنحن لسنا مُجحفين ولَم نُغالِ كثيراً، عندما قلنا أنّ الفارقَ بينهما قد يساوي النقطتَين اللتَين على حرفِ .»u« من الأهميةِ بمكان عدمُ الانجرافِ في بعضِ نقاطِ الزيغِ والضلالِ الجذرية، أثناء التفكيرِ في التغيرِ الاجتماعي، أو بمعنى آخر في المجتمعِ التاريخيّ. وأهمُّ هذه المخادعاتِ الجذريةِ هو تقييمُ التغيرِ أو التاريخِ الاجتماعيِّ من زاويةِ الرأيِ البراديغمائيِّ القائلِ ب »التقدمِ على خطٍّ مستقيم ».
هذه الذهنيةُ الفلسفيةُ التي باتت نهجاً أيديولوجياً سائداً وطاغياً في عهدِ التنوير، تتناولُ شتى أنواعِ التغيرِ على هيئةِ خطٍّ مستقيمٍ يمتدُّ من الأزلِ نحو الأبد. فالأمسُ هو الأمس، واليومُ هو اليوم! وتتعاطاهما وكأنه لا يوجدُ أيُّ رابطٍ أو تماثلٍ بينهما إطلاقاً. إنه تفسيرٌ خاطئٌ للتطورِ الدياليكتيكيّ. ومضادُّ هذه البراديغما هو المفهومُ الذي يرفضُ التغير، ويقولُ بتكرارِ الذاتِ الدائمِ بشكلٍ «حلزونيّ ». حيث يَعتَبِرُ الظاهرةَ المسماةَ بالتغيرِ مَحضَ تكرارٍ دائم. هذان المفهومان الفلسفيان الذي يبدوان متضادَّين إلى آخرِ درجة، هما مثاليان مضموناً. وكِلاهما نسختان مختلفتان من الأيديولوجيا الليبرالية. وكِلاهما يلتقيان من حيث الجوهرِ في نقطةِ إنكارِ التغير، من خلالِ الاستقامةِ اللانهائيّةِ في الأول، والتكرارِ اللانهائيِّ في الثاني.
هذه المسألةُ الأقدمُ عُمرا في الفلسفةِ والأديان، بل وحتى في الميثولوجيا، ينتهي بها المطافُ إلى مخرجٍ مسدود. إنها مهزلةٌ ساخرة، حيث عجزوا عن استيعابِ العلاقةِ بين الزمانِ والمكان. ولم يتمكنوا من الإدراكِ أنّ العلاقةَ بين الوجودِ والزمانِ تتبدى في هيئةِ النشوءِ والتكوُّن، أي التغير. والعجزُ عن الإدراكِ يُقحمُ هذه العقلياتِ بما لا مفرَّ منه في أشكالِ التفكيرِ بالتقدمِ على خطٍّ مستقيمٍ أو بشكلٍ حلزونيّ. وأهمُّ تجديدٍ أتت به الفلسفةُ الدياليكتيكيةُ في هذا الخصوص، هو ذاك المعنيُّ بجوهرِ التطورِ الكونيّ. فالزمانُ والمكانُ غيرُ ممكنَين إلا بالوجودِ والنشوء. أي أنّ التغيرَ ثمرةٌ طبيعيةٌ لتواجدِ الوجودِ )المكان( والزمان. والتغيرُ شرطٌ لا بدَّ منه لأجلِ الوجودِ والزمان. وهو برهانٌ على تواجدِهما. من هنا، فتحليلُ مضمونِ مصطلحِ التغيرِ يتحلى بأهميةٍ أكبر. إذ ينبغي تواجدُ شيءٍ لا يتغير، من أجلِ إمكانيةِ حصولِ التغير. حينها يَكُونُ التغيرُ نسبةً إلى اللامتغير.
واللامتغير هو ما يبقى دوماً كما هو. بمعنى آخر فالذي لا يتغيرُ هو الوجودُ الأصل، الوجودُ ذاتا،ً وهو الجوهرُ الباقي دوماً والذي ينبثقُ منه النشوء. قد يُقالُ أننا دَنَونا هنا من مصطلحٍ إلهيٍّ صوفيّ. لكنّ استنتاجاً كهذا ضرورةٌ اضطراريةٌ لا تتنافى مع العِلم. بيَدَ أنّ القولَ بكونِ وعيِ الإنسانِ ذا كفاءةٍ تامّةٍ بشأنِ استيعابِ وإدراكِ النشوءِ والزمانِ والمكان، هو أمرٌ ميتافيزيقيّ. حيث أنّ مهارةَ الإنسانِ في فهمِ المطلقِ محفوفةٌبالشكِّ والظنّ.
بناءً عليه، فعدمُ إنكارِ التغيرِ في علمِ التاريخِ والمجتمع، وعدمُ المغالاةِ فيه أيضاً يُعَدُّ شأناً عاليَ الأهمية. فالمجتمعُ الثقافيُّ أكثرُ رسوخاً ودائميةً من مجتمعِ المدنية، ويُشَكِّلُ أصلَ المجتمعِ ووجودَه. ووجودُ المجتمعِ المتكونِ بمتانةٍ على الصعيدِ الثقافيّ، هو مجتمع محظوظٌ في تأمينِ سيرورتِه. وبينما يطرأُ التغيرُ بسرعةٍ وكثرةٍ على المدنياتِ والدول، فإنّ الثقافاتِ تتيحُ المجالَ أمام تغيرٍ جدِّ محدود. من الخطأِ القولُ بعدمِ حصولِ أيِّ تغيرٍ فيها. لكنّ الحديثَ عن الثقافاتِ المتغيرةِ دوماً وعن القيمِ الثقافيةِ المتغيرةِ بسرعة، هو أيضاً خاطئٌ بقدرِ الأول، أي بقدرِ المفاهيمِ القائلةِ بعدمِ حصولِ التغير. في حين أنّ وتيرةَ التغيرِ المذهلةَ التي تَعتقدُ الحداثةُ بانبثاقِها من حصرِ كلِّ شيءٍ في «لحظة »، تعُبرِّ في مضمونهِا عن اللاتغير. ذلك أنّ التغيراتِ السريعةَ إلى أبعدِ حدٍّ في الحَيَواتِ التي تُكَرِّرُ ذاتَها لحظياً، هي في الحقيقةِ غيرُ واردة. لقد أُنشِئَت هنا أيديولوجيةٌ تضليلية. هذه المخادَعاتُ التضليليةُ الأيديولوجيةُ الممهورةُ بمُهرِ الليبرالية، ترمي إلى تحريفِ وعيِ وإدراكِ التاريخِ والمجتمع.
يتوجبُ وضعُ هذه المواقفِ الأسلوبيةِ نُصبَ العين، لدى التعمقِ في الظاهرةِ الكرديةِ وتاريخِها. بينما العملُ على فهمِ الحقيقةِ الكرديةِ عبر التواريخِ القوميةِ والدولتية، يعني تحميلَها عبئاً مفرطاً في الثقل. والتجاربُ المُخاضةُ في هذا المنحى تواريخٌ إرغاميةٌ لا علاقة لها كثيراً بالمستجداتِ الظواهرية.
بل ولا تَعكسُ الحقائقَ حتى بقدرِ الميثولوجيا والأساطير. أما أسلوبُ التاريخِ الثقافيّ، فهو أدنى إلى الواقعِ الظواهريّ، حيث يستوعبُ المدنيةَ والحداثةَ أيضاً بين طواياه. بينما ثقافةُ المدنيةِ والحداثةِ لا تشتملُ على التاريخِ العالَميِّ للثقافة. ذلك أنّ الأمةَ والدولة، واللتان تعُتبَرَان عامِليَن أولييَّن لعهدِ المدنيةِ والحداثة، لا يُمكنُ إلا أنْ تَكُونا جزءاً من التايخِ الثقافيّ؛ حيث تفتقران إلى القدرةِ على استيعابِ الكونيةِ الثقافيةِ واحتوائِها. من هنا، فعدمُ احتلالِ الكردِ مكانَهم كثيراً في تواريخِ المدنيةِ والأمة، لا يُفيدُ إذاً أنهم بلا تاريخ. فإذ ما تناوَلنا الموضوعَ تأسيساً على التاريخِ الثقافي، فسنُلاحِظُ أنهم أصحابُ تاريخٍ مِحوريٍّ يمتدُّ لآلافِ السنين. والميزةُ الأساسيةُ لهذه الثقافة، هي عيشُها الشكليَن العشائريَّ والقبائليَّ بنحوٍ وطيد، وأداؤُها دورا ثوريا في اقتصادِ الزراعةِ والمواشي. لذا، فدورُ الكردِ في التاريخِ الثقافيِّ للشعوبِ يماثِلُ ويساوي ما لعبَته ثقافةُ الهلالِ الخصيبِ من دورٍ في تاريخِ البشرية. فهي ثقافةٌ محوريةٌ تاريخياً خلال الحقبتَين الميزوليتيةِ والنيوليتية (15000 – 3000 ق.م)، تَغذّت عليها جميعُ ثقافاتِ المجتمعاتِ النيوليتيةِ الممتدةِ من الصينِ والهندِ إلى أوروبا. هذا وبمستطاعِنا تشخيصُ آثارِ الانتشارِ والتوسعِ الثقافيِّ في هذه الأصقاع، سواءً بالأساليبِ الجينيةِ أم الأتيمولوجية. موضوعُ الحديثِ هنا هو ريادةٌ ثقافيةٌ محورُها الهلالُ الخصيب، عمرُها يقاربُ الاثنَي عشر ألفِ عاماً على وجهِ التخمينِ وحسبما شُخَّص. إننا لَم نَعثرْ في تاريخِ البشريةِ على أيةِ ثقافةٍ أخرى طويلةِ الأَجَلِ وشاملةٍ بهذا القدر، ومنورةٍ ومُدَفِّئةٍ ومُغذّيةٍ كالشمس. وحتى لو وُجِدَت، فأدوارُها محدودةٌ وسطحية.