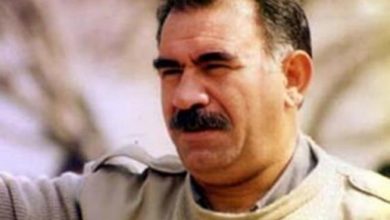حل العصرانية الديمقراطية في الشرق الأوسط
حل العصرانية الديمقراطية في الشرق الأوسط
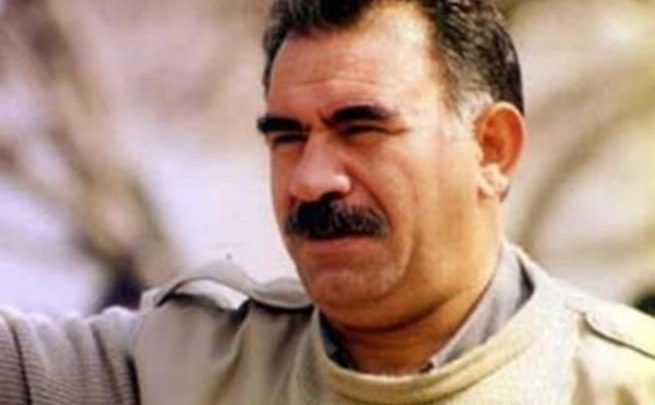
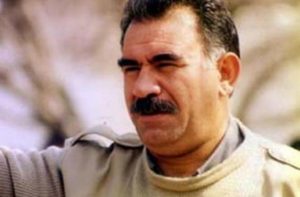 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
- c) المجتمع الأخلاقي والسياسي تجاه الدولتية القومية:
لَم تَكتَفِ الحداثةُ الرأسماليةُ بتقييدِ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ بِصَفَدِ الدولةِ القومية، بل وقَصَفَتها بالدُّوَيلاتِ القوميةِ التي تزيد في تأثيرِها على القنبلةِ الذّرّيّةِ المُلقاةِ على هيروشيما بعشراتِ الأضعاف. إذ بالمستطاعِ القول أنّ القِيَمَ الثقافيةَ المشتركةَ الناشئةَ منذ آلافِ السنين، قد تَمَزَّقَت إرباً إرباً بقصفِ الدولةِ القوميةِ في غضونِ القرنَين الأخيرَين. أي أنه مُهِّدَ السبيلُ أمام تَبَعثُرٍ وتَجَزُّؤٍ لا يملكُ أيُّ سلاحٍ ماديٍّ القدرةَ على تحقيقِه. ذلك أنّ مجتمعاتِ الشرقِ الأوسطِ لَم تُجَرَّدْ من هوياتِها، ولَم تُعَرَّ من كُلِّيّاتِيّاتِها، ولَم تُمَزَّقْ أو تَغتَرِبْ عن بعضِها وعن وجودِها في أيةِ مرحلةٍ من تاريخِها – سواءً كأنظمةِ المدنيةِ الدولتية، أم كأنظمةٍ كوموناليةٍ مُعاشةٍ على التضادِّ معها – مثلما هي الحالُ تحت ظلِّ هيمنةِ الحداثةِ الرأسمالية. فالإمبراطوريةُ البريطانيةُ تَمَكَّنَت من تأمينِ سيرورةِ هيمنتِها، بتطبيقِ هذا النظامِ الأفتكِ تأثيراً (القنبلة الذّرّيّة الحقيقية)، ليس في الشرقِ الأوسطِ فحسب، بل وفي كافةِ أرجاءِ المعمورة.
إحدى أكثر الممارساتِ مأساويةً هي تلك التي طُبِّقَت تجاه مَلِكِ فرنسا لويس السادس عشر. يجب ألا أُفهَمَ خطأً؛ فأنا لا أُقَيِّمُ الثورةَ الفرنسيةَ بأنها مؤامرةٌ من مؤامراتِ الإمبراطوريةِ البريطانية. ولكن، لا يُمكنُ إنكار كونِ بريطانيا ذاك العهدِ جَرَّبَت شتى أنواعِ الألاعيبِ في سبيلِ إحباطِ آمالِ مَلَكِيّةِ فرنسا في الهيمنة، وكونِ تلك الألاعيبِ قد أدت دوراً هاماً في قطعِ رأسِ المَلِك. الأمرُ يتعدى وجودَ العديدِ من المُعطياتِ بِحَوزةِ اليد. فابتداءُ تاريخِ الدولةِ القوميةِ رسمياً مع قطعِ رأسِ المَلِكِ في مرحلةِ إرهابِ اليعاقبةِ عامَ 1792، إنما هو أهمُّ برهانٍ على هذا الدور. ومع الدولتيةِ القوميةِ التي ابتُدِئَ بها رسمياً في 1792، ذهبَت كلُّ آمالِ فرنسا في الهيمنةِ أدراجَ الرياحِ موضوعياً. فبريطانيا هي التي استفادت من الإرهاب. وانطلاقةُ نابليون وحروبُه لَم تقتصرِ على خرابِ أوروبا فحسب، بل وشَلَّت تأثيرَ كافةِ القوى المُخَوَّلةِ للتمردِ على هيمنةِ بريطانيا. ونابليون بالذات صارَ ضحيةَ حروبِ الدولةِ القوميةِ تلك. تَحيا فرنسا جمهوريتَها الخامسةَ في يومِنا الراهن. لكنّ الأسبابَ الحقيقيةَ وراءَ خُسرانِها قوتَها طوالَ العهودِ الجمهوريةِ المختلفةِ وتَخَلُّفِها عن بريطانيا، تَعُودُ إلى الدورِ الذي تلعبُه الطبقةُ الوسطى والدولتيةُ القوميةُ البيروقراطيةُ الممهورَةُ بالطابعِ الهولنديِّ والبريطانيّ. الواقعُ عينُه يَسري على إسبانيا والنمسا – المجر وروسيا، بل وحتى على الإمبراطورياتِ العثمانيةِ والصينيةِ والهنديةِ واليابانيةِ أيضاً.
الغريبُ في الأمرِ هو بدءُ لَعِبِ نفسِ الألاعيبِ مُجَدَّداً، وبأشكالٍ أكثر فظاعةً ومأساويةً تجاه الدولةِ القوميةِ ذاتِها، في الربعِ الأخيرِ من القرنِ العشرينِ ومطلعِ القرنِ الحادي والعشرين؛ عندما باتت الدولُ القوميةُ عائقاً على دربِ الهيمنةِ العالميةِ للحداثةِ الرأسماليةِ (بزعامةِ أمريكا – إنكلترا) في الشرقِ الأوسطِ خاصةً، مثلما الحالُ في عمومِ العالَم. فالنهايةُ التراجيديةُ لِصَدّام حسين، الذي صُيِّرَ رمزاً عصرياً لـ لويس السادسِ عشر، وكأنه بُعِثَ مُجَدَّداً في الدولةِ القوميةِ العراقيةِ ضمن الشرقِ الأوسط؛ إنما غَدَت نسخةً رائعةً من الألعوبةِ نفسِها.
إنْ لَم يُحَلَّلْ ويُستَوعَبْ بعمقٍ غائرٍ الدورُ التاريخيُّ – الاجتماعيُّ للدولتيةِ القوميةِ في ثقافةِ الشرقِ الأوسط، فمن المحالِ التمكُّنُ من إيجادِ حلٍّ لأيةِ قضيةٍ اجتماعية. أما تقييمُ ممارساتِ الدولتيةِ القوميةِ خلالَ القرنَين الأخيرَين، بأنها مجردُ مؤامراتِ “فَرِّقْ – تَسُد” للإمبراطوريةِ البريطانيةِ التي تُمَثِّلُ قوةِ هيمنةِ الحداثةِ الرأسمالية؛ فمفادُه التبسيطَ المُفرطَ للحوادثِ والظواهر. لذا، من الضروريِّ تَوَخّي الحرصَ والحساسيةَ لعدمِ الوقوعِ في هذا الخطأ. ما من شكٍّ في أنّ الدولةَ القوميةَ شكلُ دولةٍ مناسبٌ جداً لحبكِ المؤامرات. لكنَّ الأهمَّ هو القدرةُ على تحديدِ قيمتِها بمنوالٍ شاملٍ على صعيدِ الحقيقة. فمضمونُ الدولةِ القوميةِ مليءٌ بالعناصرِ الأكثر سِرّيّةً وإبهاماً وميتافيزيقيةً، رغمَ جميعِ الدعاياتِ الوضعيةِ في الاتجاهِ المعاكِس. إذ لَم يُسَلَّطْ النورُ على دورِها في التاريخ. بينما تأثيرُها على المجتمعِ مُعتِمٌ أكثر. إنها شكلُ الدولةِ المشحونُ بأكثرِ الخصائصِ الثيوقراطية، رغمَ كلِّ مزاعِمِها في مناهَضةِ الثيولوجيا.
يتسمُ تنويرُ مظهرِ الدولةِ القوميةِ في الشرقِ الأوسطِ من عدةِ مناحي بأهميةٍ بالغة. فكلما سُلِّطَ الضوءُ عليها، كُلما تَحَدَّدَت المهامُّ الأخلاقيةُ والسياسية:
1- الدولةُ القوميةُ هي الوجودُ الأضعف والأكثر سلبيةً على صعيدِ الحقيقةِ الاجتماعية، رغمَ كلِّ مزاعمِها العلمية. ودورُها الأساسيُّ هو توحيدُ جميعِ الرموزِ الذهنيةِ ذاتِ الغنى الوفيرِ جداً للطبيعةِ الاجتماعية، وذلك باسمِ النمطية. فاللغةُ الواحدة، التاريخُ الأوحد، العَلَمُ الأوحد، الأمةُ الواحدة، نمطُ السياسةِ الأوحد، نمطُ الحياةِ الأوحد، ونمطُ الأيديولوجيا الأوحد؛ كلُّ ذلك يَسيرُ بالتداخُلِ مع تنميطِ الطبيعةِ الاجتماعية. وعند تبسيطِ وتنميطِ البنى الاجتماعيةِ المُعَقَّدةِ والمتباينة، فإنّ الحقيقةَ تتنحى عن مكانِها لثنائيةٍ من نوعِ الأبيض – الأسود، والتي تَغدو قِيَمُها واهنةً وسلبية. وبناءً على هذه البنيةِ الثنائيةِ الساذجةِ تتنامى وجهةُ النظرِ العالميةِ المسماةِ بالرأي الأكثر تَزَمُّتاً وشوفينيةً وتَعَصُّبيةً وفاشية. وهذه الممارساتُ التنميطيةُ للسلطةِ الدولتيةِ القومية، إنما تتأتى من نزوعِ الرأسماليةِ نحو الربحِ الأعظميّ. ذلك أنه محالٌ على قانونِ الربحِ الأعظميِّ أنْ يستمرَّ بفعاليتِه ووظيفتِه، ما دامَت مجموعاتِ الحياةِ المختلفةِ للغايةِ ضمن المجتمعِ تَصُونُ حريتَها وكرامتَها. ولا يُمكِنُ التوجهُ صوبَ تَقَطُّبٍ ثنائيِّ الطبقةِ في المجتمع (البورجوازية – البروليتاريا)، إلا بصهرِ كافةِ ميادينِ الحياةِ المستندةِ إلى مختلفِ المصالحِ تحت ظلِّ الحاكميةِ القوميةِ النمطية. ويُعَمَّمُ سياقُ الربحِ الرأسماليِّ ويتطورُ مع هذا النمطِ من التمايزِ الطبقيّ. هكذا يُضَحّى بخبراتِ الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ المتراكمةِ على مدارِ التاريخِ فداءً للتنميطِ الثنائيِّ الطبقة. أي أنّ هذه الحقيقةَ عمليةُ أُضحيةٍ يندرجُ في نطاقِها كلُّ ما هو قائمٌ من مختلفِ اللغاتِ والأفكارِ والعقائدِ والعقلياتِ والبنى الأخلاقيةِ والسياسية. يُطَبَّقُ أسلوبان في ذلك: الإبادةُ الجسديةُ والثقافية، والصهر. فحينما تَعجزُ عمليةُ الصهرِ عن نيلِ النتائجِ المأمولة، تَدخُلُ الإباداتُ الجسديةُ والثقافيةُ حيزَ التنفيذ. وعادةً ما يُطَبَّقُ الأسلوبان بشكلٍ متداخل. وهكذا يَسري ويَنشطُ السياقُ المسمى بتصييرِ الحقيقةِ نَمَطيةً ضعيفةً وسلبية.
هذه هي حقيقةُ المجتمعِ الثنائيِّ الطبقة، والتي عَمِلَت الماركسيةُ بمنوالٍ خاطئٍ على عكسِها إيجابياً. فقيمةُ الحقيقةِ للطبقةِ المسماةِ بالبروليتاريا، واهنةٌ وسلبيةٌ للغاية. لقد أُضعِفَت الحقيقةُ الاجتماعيةُ للفردِ المُستَعبَدِ عموماً لدرجةٍ يمكنُ القولُ بانعدامِها. فنظراً لأنه صُهِرَ في بوتقةِ طبقةِ الأسياد، واختُزِلَ إلى مستوى كونِه مُلحقاً بها؛ فالحقيقةُ التي كان يتمتعُ بها عندما كان حراً، باتت منقولةً إلى الأسياد. وعدمُ إدراكِ الماركسيةِ ذلك، إنما هو نقصانٌ فادح. والأمرُ الذي يتبدى فيه ماركس تلميذاً سيئاً لهيغل، يَظهرُ أمامنا بالأكثر في موضوعِ هذه الحقيقة. فهيغل يتميزُ بمهارةِ تحديدِ الحقيقةِ بمستوى أرفع بكثير نسبةً إلى ماركس. ومأثوراتُه مُنصَبَّةٌ أساساً على إظهارِ الحقيقة. بينما تشخيصُ كارل ماركس للعبدِ على أنه عنصرٌ حاملٌ للحقيقة، فقد جعلَ القِسمَ الآخرَ المشحونَ بحقائقَ هامةٍ من تعاليمِه بلا جدوى. لا تُكَدِّسُ الرأسماليةُ القوةَ الماديةَ فحسب على أساسِ الربح، بل وتَنهبُ الحقيقةَ الاجتماعيةَ (قوة المجتمعِ الذهنية) أيضاً معها. حيث تُمَرِّرُها من المِصفاةِ بما يتواءمُ ومصالحَها، وتَجعَلُها حِكراً على طبقةِ الأسيادِ ومُلكاً لها. كما وتُعَزِّزُ شأنَها على صعيدِ الحقيقةِ أيضاً بشكلٍ مذهل. أما الحَدَثُ أو الظاهرةُ المسماةُ بالدولةِ القومية، فما هي من حيث الجوهرِ سوى سياقُ تحويلِ ونقلِ هذه الحقيقة.
إذن، والحالُ هذه، فطبقةٌ واحدةٌ، لا اثنتَين، هي الساريةُ كحقيقة. وإذا لَم يُقَيَّمْ الوجودُ الفيزيائيُّ للطبقةِ العاملة، بل وحتى تنظيمُها الضيقُ من نمطِ الحزبِ والنقابةِ كجزءٍ مندرجٍ داخلَ كُلّيّاتيةِ التنظيمِ الاجتماعيِّ الديمقراطيّ؛ فإنه لن يكتسبَ قيمةَ حقيقةٍ اجتماعيةٍ وطيدةٍ فيما عدا قِطَعِ الأَجر الزهيدة. وتاريخُ الاشتراكيةِ المشيدةِ تعليميٌّ وناجعٌ لأقصى درجةٍ بشأنِ كسبِ الحقيقةِ وفُقدانِها أيضاً. وباختصار، بقدرِ ما تُنَمَّطُ الدولةُ القومية، فإنّ الحقائقَ الأحاديةَ النمطِ تُحَدَّدُ بالمِثلِ باسمِ الطبقةِ الأوليغارشيةِ الاحتكارية. وكونُ مضمونِ هذه التحديداتِ يتسمُ بالمُفارَقةِ والتَصَوُّر، لا يعني أنها ليست حقائقاً. هذا وينبغي الإدراكَ جيداً أنّ الميتافيزيقيا أيضاً شكلٌ من أشكالِ تحديدِ الحقيقة. كما وتَحمِلُ الميثولوجياتُ أيضاً قيمةَ الحقيقة. والعجزُ عن العثورِ على مُقابلِها في الطبيعة، لا يُثبِتُ عدمَ حملِها لقيمةِ الحقيقة. من الضرورةِ بمكان عدمَ النسيانِ أنّه للحقيقةِ علاقتُها مع نشوءِ ذهنيةِ الإنسانِ في كلِّ زمان. ومن المحالِ القيام بنشاطاتٍ علميةٍ وفنيةٍ وفلسفيةٍ جادة، ما لَم يُستَوعَبْ أنّ ذهنيةَ الإنسانِ هي الشكلُ الأرقى للحقيقةِ مِن بينِ ما هو معروف. وكونُ ذهنيةِ الإنسانِ مَشروطةً بالظروفِ الاجتماعية، إنما يَجعلُ علاقةَ الحقيقةِ مع المجتمعِ أيضاً ضرورةً حتميةً في الوقتِ نفسِه، دون أدنى ريب. هذا ولَم تُصَيَّرْ الحقيقةُ المرتبطةُ بالتحكمِ ضعيفةً وسلبيةً في أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدولةِ والمجتمع، بقدرِ ما هي الحالُ في الدولةِ القومية.
2- العناصرُ الثيوقراطيةُ والثيولوجيةُ للدولةِ القومية، تقتضي التوقفَ عندها بأهميةٍ أعلى. فهيغل لَم يَكُن يَصُوغُ تقييماً رمزياً خالصاً، لدى تعريفِه الدولةَ القوميةَ بالإلهِ الهابطِ على وجهِ الأرض. بل كان يُفَسِّرُ الدولةَ القوميةَ على أنها تَحَقُّقٌ وتنفيذٌ للأفكارِ المُراكَمةِ باسمِ الإله على مرِّ جميعِ العصور. ومجردُ دراسةِ مجموعِ الأفكارِ المؤديةِ إلى الثورةِ الفرنسية، كافيةٌ لفهمِ ذلك. ولدى قولِ الوضعيين بأنّ الحاكميةَ انتُزِعَت من الإلهِ وسُلِّمَت إلى الأمةِ مع حلولِ الدولةِ القومية، فهم غيرُ مدركين لمدى الألوهيةِ التي يُزاوِلونها. ذلك أنه لا عِلمَ لهم بماهيةِ الحاكميةِ بالضبط، أو أنّ التصريحَ السديدَ بذلك لا يتوافقُ ومصالحَهم. فالحاكميةُ بالذات باعتبارِها إجماليَّ السلطاتِ الهرميةِ والدولتيةِ المتطورةِ على مدارِ التاريخ، هي السيطرةُ الاحتكاريةُ المُطَبَّقةُ على المجتمعِ باسمِ الإله (السيد)، واستغلالُ فوائضِ الإنتاجِ والقيمةِ المتحققةِ بناءً على ذلك. أما كونُ الحاكميةِ ذاتِ المصدرِ الألوهيِّ عبارة عن أناسٍ جعلوا أنفسَهم أسياداً (أي أرباباً)، فهي حقيقةٌ جليةٌ بما لا يقتضي حتى التحليل. أما القولُ: “لقد خَرَجَ الإلهُ من كونِه منبعَ الحاكمية، وباتت الأمةُ مصدرَها مع الثورةِ الفرنسية”، فهو أشنعُ زيفٍ باسمِ علمِ الاجتماع. والوضعيةُ Pozitivizm مبتكرةُ هكذا نوعٍ من الزيف.
بقدرِ ما كانت حاكميةُ وتَحَكُّمُ العصورِ الأولى والوسطى تنبعُ من الإله، فحاكميةُ الدولةِ القوميةِ للحداثةِ الرأسماليةِ أيضاً تقتاتُ من المنبعِ نفسِه بأضعافٍ مضاعفة. ما ينبغي التركيزُ عليه هنا هو أواصرُ مصطلحَي القومِ والقوموية (الأمة – الوطنياتية) مع الألوهية. فكما هو معلوم، فالقوميةُ تعني الدينَ في الإسلام. أي أنّ الإلهَ والقومَ متطابقان. وتَحَوُّلُ القومِ إلى أمةٍ لا يُغَيِّرُ النتيجة. بل ثمةَ تلاعُبٌ لغويٌّ هنا، لا غير. فالقومُ أو الأمة، سواءً ذُكِرَا في الكتبِ المقدسةِ أم في تعاليمِ الليبراليةِ الرأسمالية، يُعَبِّران عن الجماعةِ أو المجتمعِ المُمتَثِلَ لأوامرِ الإله (السيد، الرب، الحاكم، الآمِر الناهي). أي أنّ الرأسماليين بمصطلحَي الدُّنيَوِيّةِ والعلمانيةِ لا يصبحون خارجين على الدينِ أو الإلهِ أو الحاكمِ أو ناكرين إياهم. بل يَغدون مُطَوِّرين ديانةً مُتَكَيِّفةً مع مصالحِهم تحت اسمِ القومويةِ أو الوطنياتيةِ أو باسمِ مذهبٍ دينيٍّ جديد. بل وحتى إنّ القومويةَ التي تَحُومُ على تُخُومِ الفاشية، تتميزُ عن غيرِها باحتلالِ موضعِ الدينِ الأكثر تَزَمُّتاً مما شُوهِدَ في سياقِ التاريخ. ليس مهماً أنْ يتَّخَذَ أو لَم يَتِّخّذْ الدينُ الأشكالَ القديمةِ كالمسيحيةِ أو الإسلاميةِ أو البوذيةِ أو الموسوية. فكلُّ فكرةٍ أو عقيدةٍ تَحُفُّ المجتمعِ بمستوى العِبادة، يُمكِنُ التعبير عنها كدينٍ بكلِّ يُسر. كما أنّ وجودَ الإلهِ أو عدمَه ليس مُعَيِّناً في هذا الموضوع. فالجوهرُ الأساسيُّ يتجسدُ في القدرةِ على تقييدِ منسوبي مجتمعٍ ما بعالَمِ الشعورِ والعقيدةِ والفكر، وبأشكالِ ومراسيمِ وطقوسِ السلوكياتِ المسماة بالعبادةِ بشكلٍ مشتركٍ وكثيفٍ للغاية إلى درجةِ التقديس. ساطعٌ تماماً أنّ الأمةَ والوطنياتيةَ ضمن إطارِ الدولةِ القوميةِ قد أُنشِئَتا بموجبِ هذه التعاريفِ وبمنوالٍ مُفرطٍ ومتطرفٍ للغاية. بناءً عليه، فهذه مصطلحاتٌ وتعاليمٌ جليةٌ لدرجةٍ لا تقتضي الجَدَلَ على طابعِها الدينيّ.
الأمرُ الذي يجبُ مراعاته بعنايةٍ في إلهياتِ الأمةِ والوطنياتية، هو لجوءُ الوضعيةِ المُتَقَنِّعةِ بقناعِ العلميةِ إلى عكسِ ذاتِها وكأنها ليست ديناً أو ميتافيزيقيا. بل وحتى إنها لا تتوانى عن المبادرةِ إلى التجريدِ الدينيِّ باسمِ “العلموية” فيما يتعلقُ بالوطنياتيةِ والدولةِ القومية، بعدَ أنْ تَعَلَّمَت كيف تَكُونُ على تضادٍّ مع الدينِ والميتافيزيقيا كقاعدةٍ أوليةٍ لديها. من هنا، فحقائقيةُ ودِينَويةُ الدولةِ القوميةِ مرتبطان ببعضهما بعضاً بوثوق. أما هدفُهما المشترك، فهو صهرُ أشكالِ الحياةِ المتنوعةِ والمتباينةِ للواقعِ الاجتماعيّ، والقضاءُ عليها، وتشويهُها، وجعلُها بلا تاريخ؛ ثم إضعافُ تعابيرِ الحقيقةِ الغنيةِ بناءً على ذلك، وعرضُ نظامِها المهيمنِ على أنه الحقيقةُ الشرعيةُ الوحيدة.
3- نتائجُ العقليةِ والبنى الدولتيةِ القوميةِ المفروضةِ على حياةِ الشرقِ الأوسطِ الثقافية، لا تزالُ موضوعاً غيرَ مَبحوثٍ فيه بعدُ بنحوٍ كلياتيٍّ ووفقَ منظورِ الفترةِ التاريخية. فحتى أصحابُ هذه العقليةِ والبنى، نادراً جداً ما يُدرِكون ما يُطَبِّقون. ألا وهو السلطةُ والمصلحةُ الماديةُ المحصورتان بمكانٍ محدودٍ ضيقٍ والمُؤَطَّرتان بفترةٍ قصيرة. وفي حقيقةِ الأمر، فمُطَبِّقوا الدولةِ القوميةَ أيديولوجيةً وبنيةً، يتحركون بالمنطقِ القائلِ: “ما ننتَزِعُه من هيمنةِ الحداثةِ الرأسماليةِ مَكسَبٌ لنا”. وكلُّ مواقفِهم الاستراتيجيةِ والتكتيكيةِ محدودةٌ بهذه الرؤية. فالنظامُ المهيمنُ لا يُتيحُ الفرصةَ لأيِّ تطورٍ آخَر. ونظراً لأنهم يَجهَلون حقيقتَه وثيولوجيتَه، اللتَين سعينا لسردِ جوهرهما، فهم دوغمائيون وطنيون قطعيون من جهة، ولا يتخلصون من العيشِ دوماً كرَيبِيّين تشكيكيين من جهةٍ أخرى. وإذ ما عَمِلنا على تجسيدِ الأمرِ أكثر، فالدُّوَيلاتُ القوميةُ التي تُناهِزُ العشرين دولة، والمفروضةُ على الأنظمةِ القَبَلِيةِ والدينيةِ العربيةِ التي تُعتَبَرُ من أقدمِ الحقائقِ الاجتماعيةِ الشرقِ أوسطية؛ لا تَقتَصِرُ على تقسيمِ الحياةِ الثقافيةِ المشتركةِ وحسب، بل وتُلَقِّحُ جوهرَها الوجوديَّ أيضاً باغترابٍ ذي أبعادٍ لا نظيرَ لها. فالهويةُ العربيةُ الجديدةُ البارزةُ للوسطِ ليست أكفأَ من هويةِ العصورِ القديمةِ والوسطى التي طالَما تتَعَرَّضُ للنقد. ذلك أنّ العربَ المُتَجَزِّئين على خلفيةِ الدولةِ القومية، هم العربُ الأكثر وهناً وانحرافاً وانقطاعاً عن الحقائقِ التاريخيةِ – الاجتماعية. فمهما تظاهروا أو تَشَبَّثوا بالدولتيةِ القوميةِ الجَزميةِ والقطعية، فقُواهم تَخُورُ أكثر فأكثر، ولا يتعززُ شأنُهم كما يَظُنّون. علماً أنّ العروبةَ أيضاً هي دافعُ الوهنِ والبُعدِ عن الحقائق، لا عِلّةُ القوةِ والثبات.
إنّ القومويةَ التي لا تتغذى على الحقيقة، لن تَكُونَ عامِلَ قوةٍ وثَبات. وقد شُوهِدَ هذا الوضعُ في ممارسةِ هتلر بأكثر الأشكالِ لفتاً للأنباه. بينما الحدودُ المُناطةُ بالقدسيةِ من وجهةِ نظرِ الدولةِ القومية، هي محضُ ابتكارٍ مُصطَنعٍ حُدِّدَ بموجبِ مصالحِ الهيمنةِ العالمية. ومصطلحا الوطنِ والقوم اللذَين تَحتويهما، لا يُمكِنُهما النَّفاذ خارجَ إطارِ المصالحِ عينِها، بصفتِهما رمزَي الثيولوجيا الجديدة. وفي حالِ خروجِهما، فمن العصيبِ جداً خَلاصُهما من غضبِ الإلهِ المهيمن. وفي الحقيقة، فجميعُ الحدودِ والأوطانِ والأقوامِ والطبقاتِ الوسطى والبيروقراطيات، التي تَدُورُ مساعي إنشائِها في المنطقةِ في غضونِ القرنَين الأخيرَين، قد باتت ضامرةً وهامشيةً مع ألوهيةِ الدولةِ القومية. فهي تَعتَقِدُ أنّ الواقعَ الذي تَحياه واقعٌ أزليٌّ وأبديٌّ سرمديّ. بَيْدَ أنّ شخصاً منفتحَ الذهنِ قليلاً على الحقيقة، يَعلَمُ أنّ كافةَ هذه الحقائقِ مجردُ ابتكاراتٍ وهميةٍ تَرمي إلى شرعنةِ المصالحِ المهيمنةِ خلال القرنَين الأخيرَين. وإنشاءُ الدولتَين القوميتَين التركيةِ والإيرانيةِ هو منتوجُ المصالحِ المهيمنةِ نفسِها. إذ تَتطلعان إلى تذليلِ وتجاوُزِ أزماتِهما في الشرعنةِ بالأيديولوجياتِ الدِّينَوِيةِ والقومويةِ المتطرفة، بالرغمِ من أنهما مشحونتان بطابعِ الغزوِ للحداثةِ الرأسمالية. وتتداخلُ القومويةُ العلمانيةُ والدينيةُ في جميعِها، سعياً لتحصينِ الدولةِ القوميةِ بدرعٍ أيديولوجيٍّ منيع. بينما الثقافاتُ والأثنياتُ والأديانُ والمذاهبُ التاريخيةُ التي تُترَكُ في حالةِ الأقلية، تَغدو وجهاً لوجهٍ أمامَ قضيةِ الوجودِ أو العدمِ في مواجهةِ الدولةِ القومية.
كُلّيّاتيةُ الثقافةِ الشرقِ أوسطيةِ على تناقضٍ جذريٍّ مع تجزيئيةِ الدولةِ القوميةِ للحداثةِ الرأسمالية. فالحداثةُ تلعبُ دورَ القفصِ الحديديِّ المفروضِ على وقائعِ الحياةِ المشتركة. وكونُ العنفِ حديثَ الساعةِ الدائم، إنما يُؤَيِّدُ مصداقيةَ هذه الحقيقة.
قوةُ العصرانيةِ الديمقراطيةِ في الحلِّ والتحليلِ أكثرُ شفافيةً بكثير بالمقارنةِ مع الدولةِ القومية. فالوقائعُ الاجتماعيةُ التي تَتركُها القوى المهيمنةُ القديمةُ والحديثةُ للسَّباتِ والتنويمِ من خلالِ مساعيها المتواصلةِ في فرضِ نسيانِ تواريخِها عليها، إنما هي قادرةٌ على التعبيرِ عن حقيقةِ وجودِها ضمن إطارِ تاريخانياتِها الذاتيةِ عبرَ مواقفِ العصرانيةِ الديمقراطية. والتحليلُ بصددِ القوى المهيمنة، إنما يَجِدُ جوابَه كتاريخٍ وكحقيقةٍ بشأنِ المضادين لها. فالوقائعُ الاجتماعيةُ ليست بلا حقيقة، مثلما لَم تَكُ بلا تاريخ في أيةِ مرحلةٍ كانت. يُشَكِّلُ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ أطروحةَ العصرانيةِ الديمقراطيةِ المضادةَ في وجهِ هيمنةِ الدولةِ القوميةِ المفروضةِ على الثقافةِ الاجتماعيةِ المشحونةِ بالكُلّيّاتِيّةِ التاريخيةِ للشرقِ الأوسط.
a- تتطورُ الدولةُ القوميةِ إنكاراً للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. فتُقِيمُ قواعدَ القوةِ المسماةِ بالقانونِ الوطنيِّ مقامَ الأخلاق. فالقانونُ الذي يُعَبِّرُ عن ترتيباتِ وإجراءاتِ القوة، يَشهَدُ أقصى درجاتِ تطورِه ضمن إطارِ الدولةِ القومية. بينما تُصَيِّرُ الدولةُ القوميةُ الحُكمَ البيروقراطيَّ الصارمَ سائداً بدلَ المجتمعِ السياسيّ. إذ يُظهِرُ إنكارُ المجتمعِ السياسيِّ نفسَه عَينِيّاً في عدمِ فاعليةِ النظامِ الديمقراطيّ. ومهما يَكُنُ البرلمانُ والانتخاباتُ موضوعَ حديث، إلا أنّ ما يَسري هو الدستورُ غيرُ المُدَوَّنِ لِبُنيةِ حُكمِ الأوليغارشيةِ البيروقراطية. فسلطةُ الدولةِ القوميةِ المتغلغلةِ حتى الأوعيَةِ الشعريةِ الدقيقةِ للمجتمع، تَبسطُ نفسَها تحت القناعِ القانونيِّ على أنها حُكمٌ عامّ. بينما الانتخاباتُ والبرلمانُ لا يُعَبِّران عن معانيَ بارزةٍ أكثر من أدائِهما دورَ الطلاءِ لِصَقلِ شرعيةِ هذا الحُكم. ويُجعَلُ المجتمعُ والشعبُ والأمةُ مُرادِفاتٍ مطابقةً للدولةِ القومية. لذا، ما مِن سبيلٍ آخَر للحلِّ، سوى الدفاع عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ في وجهِ هذا الواقعِ المهيمن، الذي صَيَّرَته الحداثةُ الرأسماليةُ عالَمياً.
الطبيعاتُ الاجتماعيةُ أخلاقيةٌ وسياسيةٌ من حيث الجوهر. ومن المحال التفكير بمجتمعٍ أو فردٍ بلا أخلاقٍ أو سياسة. قد يُرغَمُ المجتمعُ على التَّعَرّي من الأخلاقِ والسياسة. وقد تُصَيَّرُ المهارةُ الأخلاقيةُ والسياسيةُ مشلولةً وواهنةً لدرجةِ العجزِ عن أداءِ دورِها. ولكن، لا يُمكنُ إفناءَها بتاتاً. فالإفناءُ أو القضاءُ عليها غيرُ ممكنٍ إلا بالخروجِ من كينونةِ المجتمع. الأخلاقُ والسياسةُ أداتا الحقيقةِ الاجتماعيةِ القويتان والمنيعتان. وكيفما يُفضي الافتقارُ إلى الأخلاقِ والسياسةِ إلى اللاحقيقة، ففي الميادين التي تتواجدُ فيها الممارسةُ الأخلاقيةُ والسياسيةُ الوطيدة، تَكُونُ أنماطُ تعبيرِ الحقيقةِ عن ذاتِها قويةً وشفافة. أما عرضُ الأخلاقِ والسياسةِ كبُنيةٍ فوقية، فهو أحدُ ضلالاتِ الماركسيين الهامة. إذ ما مِن مُكَوِّنٍ أو فردٍ غيرِ أخلاقيٍّ أو سياسيٍّ في المجتمع. أي أنّ كلَّ مُكَوِّنٍ وفردٍ في المجتمعِ هو أخلاقيٌّ وسياسيٌّ في آنٍ معاً. والديمقراطيةُ تتناسبُ مع المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. الديمقراطيةُ هي الحالةُ الفعّالةُ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. والحقائقُ الاجتماعيةُ تُظهِرُ ذاتَها بنسبةٍ قصوى في هيئةِ المجتمعِ الديمقراطيّ. أما التعبيرُ عن الحقائقِ في هيئةِ العلمِ والفلسفةِ والفنّ، فيَبلغُ أفضلَ أحوالِه مع المجتمعِ الديمقراطيّ. تُوَضِّحُ هذه التشخيصاتُ دوافعَ بلوغِ الحقيقةِ أقصى أشكالِ تعابيرِها في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ.
تُبَرهِنُ عناصرُ المقاومةِ التي لا تَبرحُ منيعةً في المجتمعِ الشرقِ أوسطيِّ على أنّ العنصرَين الأخلاقيَّ والسياسيَّ ليسا ضعيفَين كما يُظَنّ. إذ لا يستطيعُ الأفرادُ والمجموعاتُ اللاأخلاقيةُ واللاسياسيةُ إبداءَ المقاومة، لأنها مُعتادةٌ فقط على الخنوع. إنّ المقاوماتِ ذاتَ الأبعادِ الوطنيةِ والمذهبيةِ والعشائريةِ والقَبَلِيّةِ والعائلية، ومقاومةَ الرُّحَّلِ والناسِ المرغَمين على العيشِ في أطرافِ المدن؛ وبقدرِ ما تُعتَبَرُ رفضاً للدولةِ القومية، فهي في الوقتِ نفسِه دعوةٌ إلى إنشاءِ المجتمعِ الديمقراطيّ. أي أنّ هذه التطوراتِ والأحداثَ الجاريةَ ضمن أبعادِ ثقافةِ الشرقِ الأوسط، تُشَكِّلُ غنى الطاقةِ الكامنةِ للعصرانيةِ الديمقراطية، وليست مؤشراً على التخلفِ والفوضويةِ ورجعيةِ العصورِ الوسطى، كما تَصِفُها الاستشراقية. وغضُّ النظرِ عن غِنى الظواهرِ الاجتماعيةِ يُوَلِّدُ في النتيجةِ إضعافَ قوةِ المعنى والحقيقةِ لدى المجتمع. أي، وبقدرِ ما يُنَمَّطُ الغنى الثقافيّ، فإنه يُعَرّى ويُجَرَّدُ بالمِثلِ من معانيه ومن التعبيرِ عنه كحقيقة. أما حُكمُ الدولةِ القوميةِ في إنتاجِ مواطنين متجانسين ومن نمطٍ واحد، فهو على صعيدِ المعنى يتعدى كونَه عدةَ قوالب دوغمائيةٍ محفوظةٍ عن ظهرِ قلب ومفتقرةٍ لطاقتِها الكامنة، ليَغدوَ فرديةً ذهنُها معطوب، وجوفاءَ من حيث الحقيقة، وتَنظرُ إلى المراسيمِ الرسميةِ على أنها أشكالُ العبادةِ الجديدة.
أما القيمُ الأخلاقيةُ والسياسيةُ التي باتت فعالةً ووظيفيةً مع المجتمعِ الديمقراطيّ، فتُنتِجُ الحقيقةَ من خضمِّ طاقةٍ كامنةٍ ذاتِ معاني وفيرة. أما المجتمعُ المقتاتُ على الحقيقةِ باستمرار، فيَحيا في توازنٍ أمثل بين الفرد والجماعة.
b- مقابلَ الثيولوجيا الوضعيةِ للدولةِ القومية، يَتَّخِذُ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ الفلسفةَ أساساً من حيث معناها كعلمٍ وحِكمة. فالعلمانيةُ والدُّنيَوِيةُ لا تختلفان كثيراً على صعيدِ المبدأ عن الدوغمائياتِ الدينية. فبالتَّسَتُّرِ بقناعِ الدولةِ القوميةِ لا يتمُّ الخلاصُ من الدِّينَوية، بل يجري تغييرُ الشكلِ فحسب. ودوغمائياتُ الدولةِ القوميةِ التي تُنتِجُها العلمويةُ الوضعيةُ سريعاً، أكثرً صرامةً وتَزَمُّتاً من الدوغمائياتِ الدينيةِ للعصورِ الوسطى. وحقيقةُ الحربِ والاستغلالِ الناجمةُ عن الدولةِ القومية، تُبَرهِنُ هذا الأمرَ بمُنتهى العلانية. ينبغي العِلمَ على أحسنِ وجهٍ أنّ الثيولوجيا أُنشِئَت أساساً كأداةِ شرعنةٍ أيديولوجيةٍ للمدنيةِ الطبقيةِ – الدولتية، بما فيها الحداثةُ الرأسماليةُ أيضاً. وهي تتنامى كمُضادٍّ (أطروحة مضادة) لعناصرِ العلمِ – الحكمةِ القائمةِ في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. فبينما تُمَهِّدُ القِيَمُ الأخلاقيةُ والسياسيةُ السبيلَ أمامَ العلمِ والحكمة، فالعلمُ والحكمةُ بدورِهما يُغَذّيان المجتمعَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ على الدوام. أما التعبيرُ الاجتماعيُّ الذي يَفرضُ حضورَه من الخارجِ في هيئةِ ثيو Theo (الإله) ولوجيا Logy (العقل)، فما هو سوى دولةُ المَلِكِ – الإله. ويُعزى العجزُ عن التعبيرِ عن ذلك بوضوحٍ وشفافية إلى تَغَذّي السوسيولوجيا الغربيةِ على المضمونِ الطبقيِّ – الدولتيِّ عينِه. ومع الخطوةِ الوضعية، تنتقلُ بالثيولوجيا إلى أخطرِ المراحل. فمَن ذا الذي يستطيعُ إنكارَ كونِ تصييرِ الإلهِ دُنيَوِيّاً قد أَسفرَ عن استغلالٍ وسَكبِ دموعٍ وإراقةِ دماءٍ أكثر بألفِ مرة منه عندما كان سماوياً! خاصةً وأنّ تجربةَ إلهِ الدولةِ القوميةِ الباهرةَ في غضونِ القرنَين الأخيرَين منتصبةٌ أمام الأعين. ما هي صفاتُ هذا الإله؟ إنها الحدود، الأقوام، الأعلام، الأناشيد الوطنية، الطبقاتُ الوسطى، البيروقراطيات، والمواطِنون الذين يُكَرِّرُون ذاتَهم. وما الذي فعلَه إلهُ الدولةِ القوميةِ تحت ظلِّ هذه الصفات؟ لقد حَقَّقَ الحروبَ وعملياتِ الاستغلالِ بما لا نِدَّ له في التاريخ، وأسَّسَ نظامَ الدولةِ القوميةِ في العالَم بصفتِه ديميورغاً (إله العمار). وبذلك أَثبَتَ أنه إلهٌ يتسمُ بأرقى الخصائصِ الوثنية.
لا يَشعرُ المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ بحاجةٍ إلى هكذا إلهياتٍ من أجلِ العيش، إذ يَعتَبِرُ الحكمةَ أثمنَ من الثيولوجيا. والحكمةُ والمعرفيةُ تنحدران من العلمية، لا من الثيولوجيا. إنها نوعٌ من السوسيولوجيا. ولَطالَما تواجدَت عُروقُ الحكمةِ في مجتمعِ الشرقِ الأوسط، على الرغمِ من كلِّ الإرغاماتِ الثيولوجية. لذا، من الضرورةِ بمكان تقييم الحكمةِ كَكُلّيّاتيةٍ متكاملةٍ مع الفلسفةِ والسوسيولوجيا، وبأنها حالتُهما المتداخلةُ مع الحياة. فبينما كانت الحكمةُ شكلاً أساسياً حتى عهدِ سقراط، فقد مَيَّعَت المدارسُ المتطورةُ لاحقاً هذه التقاليدَ وأَفسَدَتها، مما نَشَأَ الانقطاعُ بين التعاليمِ والحياة. وهذا ما صارَ بدورِه ضربةً مُلحَقةً بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. فدُفِعَ بالحكمةِ كفلسفة إلى خدمةِ الدولة. وإلى جانبِ طُغيانِ جانبِ الحكمةِ على تقاليدِ الأنبياءِ باستمرار، فإبداؤُها الانفتاحَ التدريجيَّ على الثيولوجيا أيضاً، جَلَبَ معه التفسُّخَ والانحلال. فبقدرِ ما يَنحَرِفُ الرُّسُلُ والواعظون والرهبانُ نحو الثيولوجيا، فإنهم ينقطعون عن الحكمةِ ويَبتعدون عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ بالمِثل. هذا وثمة صراعٌ مريرٌ ضمن ثقافةِ الشرقِ الأوسطِ بين عناصرِ هذه الثنائية. إذ يَعكِسُ هذا الصراعُ في جوهرِه التوترَ بين عالَمِ المدنيةِ الدولتيةِ وعالَمِ الحضارةِ الديمقراطية.
ومقابلَ إرغاماتِ المَلِكِ والاستبداديِّ المُقحَمةِ في مصطلحِ الإله، فإنّ الدفاعَ عن الهويةِ الاجتماعيةِ البارزةِ بنحوٍ أفضل مع التصوف، يُعَدُّ الشأنَ الأصلَ للحكمة. وبذلك يتمُّ الدفاعُ عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ، والبحثُ عن الكرامةِ والحكمةِ في المجتمع. هذا ويتحلى هكذا نمطٌ من تفسيرِ تاريخِ الشرقِ الأوسطِ بالأهمية. وتحديثُه سيَجعلُ العصرانيةَ الديمقراطيةَ أكثر وضوحاً للفهم.
c- المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ لا يعني إنكارَ المجتمعِ الوطنيّ. فتغييرُ المجتمعاتِ لأشكالِها باستمرار، إنما هو بِحُكمِ طبيعتِها. وتنوُّعُ الأشكالِ دليلُ غِنى الحياة. ما تتمُّ مناهَضتُه، هو انغلاقُ الأشكالِ الاجتماعيةِ على ذاتِها وصَرامَتُها. وما التَّزَمُّتُ أساساً سوى إصرارٌ على انغلاقِ الشكلِ وصرامتِه. بينما حَوافُّ أشكالِ الحريةِ مرتبطةٌ بانفتاحِها ومرونتِها. فبقدرِ ما تَكُونُ حَوافُّ الهوياتِ الاجتماعيةِ منفتحةً ومرنة، فإنها تكتسبُ التنوع، وبالتالي تَحيا حرةً بالمِثل. في حين أنّ مفهومَ الهويةِ في الدولةِ القوميةِ واحديٌّ ومنغلقُ الحافةِ وصارم. وتنبعُ الفاشيةُ من مفهومِ الهويةِ هذا. وهكذا إدراكٌ للهوياتِ الاجتماعيةِ يُعاشُ داخلَ المجتمعِ الوطنيِّ وخارجَه ضمن حالةِ حربٍ دائمة. إذ لا مَهربَ من حروبٍ كهذه، عندما تَتَواجَهُ الهوياتُ الاجتماعيةُ المنفتحةُ والمرنةُ الحوافِّ مع إرغاماتِ الهويةِ ذات الطبيعةِ الزائفةِ والمنغلقةِ والصارمة. والحروبُ الدينيةُ والوطنيةُ على السواء، تُعَبِّرُ عن صراعِ الهوياتِ ذاك (الانغلاقُ والصرامةُ خاصيتان أساسيتان في هوياتِ كِلتَيهما). والمعاناةُ من الحروبِ ذاتِ الهويةِ الدينيةِ والوطنيةِ الكثيفةِ والطاحنةِ في الشرقِ الأوسطِ خلالَ القرنَين الأخيرَين، إنما على صلةٍ بمفهومِ الهويةِ الذي أرادت الحداثةُ الرأسماليةُ فرضَه. فهوياتُ الدولةِ القوميةِ المارّةِ من مِصفاةِ هيمنتِها، ما هي مضموناً سوى بمنزلةِ امتداداتٍ وعُملاء للهويةِ المركزية. والهويةُ المركزيةُ بدورِها تَعمَلُ دوماً كمَقَرٍّ مركزيّ، وتَهتَمُّ بشؤونِ مستَعمَراتِها ووكالاتِها عن كثب، وتُعيدُ فَرزَها من جديد إنْ اقتضى الأمر.
ومثلما الحالُ في عمومِ المعمورة، فهوياتُ الدولةِ القوميةِ للقرنَين الأخيرَين قد أُبلِيَت في الشرقِ الأوسطِ الراهن، وباتت عائقاً على دربِ الرأسماليةِ الساعيةِ لتكثيفِ العَولَمة. وتَكمُنُ مقاوَمةُ الدولةِ القوميةِ المتزَمِّتةُ في أساسِ البنيةِ البنيوية. هذا هو التناقضُ الرئيسيُّ الذي يَشهَدُه النظامُ في داخلِه. ولكنه عاجزٌ عن إيجادِ الحلّ. فبينما تزدادُ التناقضاتُ القائمةُ بين الدولتيةِ القوميةِ والرأسماليةِ العالمية، بدءاً بأفغانستان وحتى المغرب، ومن قفقاسيا وحتى المحيطِ الهنديّ؛ فهي من الجانبِ الآخَرِ تَفتحُ الطريقَ أمامَ الحروبِ المُعاشةِ مِراراً. تَعلَمُ الرأسماليةُ عِلمَ اليقينِ استحالةَ قضائِها كلياً على الدولةِ القوميةِ التي هي مَدينةٌ لها بنسبةٍ هامةٍ من الفضلِ في تَوَسُّعِها. في حين تُواجِهُ مقاوَمةَ هذه الدولِ باستمرار، عندما تَوَدُّ إطراءَ الإصلاحِ عليها. فالشرائحُ التي باتت بَدِينةً بإفراطٍ بليغٍ بفضلِ الدولةِ القومية، تُقاوِمُ تجاه رأسماليةٍ أكثر عقلانية. ونتيجةُ ذلك هي المزيدُ من الأزماتِ والحروب. ومثلما ينبثقُ “مشروعُ الشرقِ الأوسطِ الكبيرِ” الأمريكيُّ الأخيرُ من هذه الحقيقة، فبإمكاننا النظر إلى هذه الحقيقةِ لإدراكِ دوافعِ العجزِ عن تنفيذِه أيضاً. ذلك أنّ الانسدادَ السائدَ في المنطقةِ أعمقُ من أزمةِ النظامِ في الحربَين العالميتَين الأولى والثانية. ولأنّ الأمرَ كذلك، فهو لا يُحَلُّ بأيِّ شكلٍ من الأشكال. كما أنّ مصطلحَ الأزمةِ البنيويةِ أيضاً يَستَقي معناه من ماهيةِ الحقيقةِ هذه.
إذن، والحالُ هذه، فالشرقُ الأوسطُ لا يَحُوزُ على احتمالِ إيجادِ حلٍّ قَيِّمٍ لأيةِ قضية، دونَ تَخَطّي هويةِ الدولةِ القوميةِ المنغلقةِ والصارمة، سواءً انعكستَ من التطورِ الكُلّيّاتيِّ للثقافةِ التاريخيةِ – الاجتماعية، أم من التناقضاتِ الداخليةِ للحداثةِ الرأسمالية. فجميعُ الجهودِ المبذولةِ لإعادةِ إنشاءِ الدولةِ القوميةِ في العراقِ وأفغانستان تذهَبُ هباءً. وعلى الرغمِ من أنّ الدعمَ المحدودَ الذي قَدَّمَته أمريكا ضمن إطارِ مشروعِ مارشال بَعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ كان كافياً لأجلِ إعادةِ إنشاء أوروبا المنهارةِ في الحرب، إلا أنّ إعادةَ الإنشاءِ لا تتحققُ البتة في بلدٍ صغيرٍ كالعراق، رغمَ تقديمِ دعمٍ أكبر بأضعافٍ مضاعفة. في الواقع، ما يجري في العراق، إنما يَعكِسُ كافةَ حقائقِ المنطقة. إذ يُنَبِّئُ بإفلاسِ وأزمةِ الحداثةِ الرأسماليةِ بشأنِ ركائزِها الثلاثِ أيضاً. وفي المحصلة، لا يُمكِنُ للشرقِ الأوسطِ إلا أنْ يُنتِجَ الأزماتِ والحروب، بهذا الكَمِّ مما يَمتَلِكُه من دولٍ قوميةٍ وصناعويةٍ ورأسمالية.
ولكن، ينبغي التبيان ثانيةً أنّ الأزماتِ والحروبَ المُعاشة، ليست معنيةً بالحداثةِ الرأسماليةِ للقرنَين الأخيرَين فقط، بل هي أزماتٌ بنيويةٌ وحروبٌ متعلقةٌ بالمدنيةِ الطبقيةِ والدولتيةِ المُعَمِّرةِ خمسةَ آلافِ سنة أيضاً في الوقتِ نفسِه. والحلولُ المُحتَمَلةُ مُلزَمةٌ باتّخاذِ هذا الواقعِ أساساً.