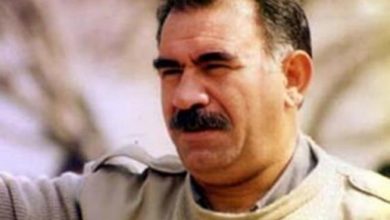تصور نظام الحضارة الديمقراطية
تصور نظام الحضارة الديمقراطية
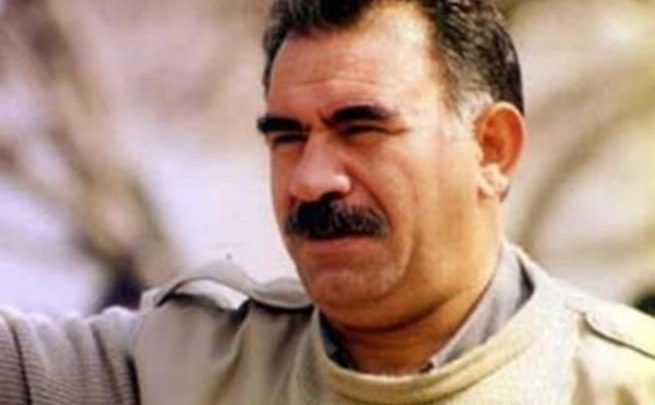
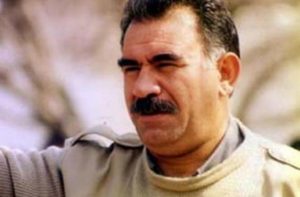 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
أنا على قناعةٍ بأنّ تحويلي كلَّ شيءٍ – حتى غرائزي – إلى معضلةٍ إشكالية، قد أَكسَبَني كفاءةَ الانقطاعِ عن نمطِ التفكيرِ الدوغمائي، الذي لا يَبرَح منيعاً للغاية في تقاليدِ مجتمعِ الشرق الأوسط. وفي نهايةِ المآل، فأهميةُ الموضوع تتبدى مِن مدى كَونِ نمطِ التفكيرِ المهيمنِ الأوروبيِّ المركزِ لا يزال مؤثراً حتى الآن في الدوغمائيةِ الوضعيةِ الحداثويةِ والفكرِ ما وراء الحداثويِّ على السواء. لقد سعيتُ لتحديدِ مكاني مِن خلالِ المقارنةِ بين المهارةِ الفكريةِ المتأسسةِ على العقيدةِ في الشرق، وبين القدرةِ الفكريةِ المتأسسةِ على المُساءلةِ في الغرب. واضحٌ أني لَم أستطعْ العثورَ على مكانٍ لنفسي في كِلا الجانبَين. وعندما كان تفكيري بهذا المنوال طبيعياً، فقد استمرَّت حياتي أيضاً بِتَجَذُّرِ الانقطاعِ واتساعِ الهوةِ بيني وبينهما طرديا مع مرورِ الأيام.
ما عُرِضَ لَم يُقنِعني أو يُشبِع طموحي بتاتاً، سواءً بنمطِه الفكريِّ العقائدي أو المَنطِقي. بل ويتمثلُ انتقادي الأساسيُّ في مدى أهميةِ مسؤوليةِ هذه الأفكارِ عن تعاظُمِ القضايا الاجتماعية. وهذا بدورِه ما كان يشيرُ إلى ضرورةِ التركيزِ الانتقاديِّ على المنهجيةِ العقائديةِ للشرق والمنهجية العقلانيةِ للغرب في آنٍ معاً، مما كان يَمُدُّني بالجرأة في هذا الشأن.
خاصيَّتي الثانية هي عدمُ انقطاعِ وعيي النبيهِ عن ممارستي الاجتماعيةِ إطلاقاً. وفي هذا المضمار، بَرَزَ في شخصيتي تكوينٌ ذو طابعٍ تَشارُكِيٍّ خارقٍ في وقتٍ باكرٍ جدّاً. فمنذ ذهابي إلى المدرسةِ الابتدائيةِ سيرا على الأقدام )وهي في قريةِ جِبيِنCibin الاجتماعي، فلا تتعدى نطاقَ تصييرِ الوضعِ أكثر تشويشاً وتعقيداً.
أُبَيِّنُ مِراراً أنّ توضيحَ الاشتراكيةِ العلميةِ لهذا الوضعِ بالطابعِ الطبقيِّ للتاريخ قد عَجِزَ عن حلِّ القضية، بل ولَم يتوانَ حتى عن التحولِ إلى جزءٍ مِن القضية ذاتهِا؛ حتى وإنْ كان يُنِيرُ بعضَ الحقائق.
لهذا السببِ بالذات أشُيرُ مِرارا إلى أنه، إذا لمَ يتم تخَطي براديغما الحداثةِ الرأسمالية كلياً، فدعك مِن فهمِ الحقيقةِ التاريخية؛ بل إنها ستؤدي دورَها في طمسِ الحقيقةَ وتجريدِها مِن معانيها بدرجةٍ أكبر بكثير مما في تاريخِ الأديان. والنتائجُ التاريخيةُ لرؤيةِ ماركس البراديغمائية تلك، باتت مفهومةً بنحوٍ أفضل في يومنا.
فالتاريخُ الخاطئ يعني ممارسةً خاطئة. كما يستحيلُ الوصول إلى الموقفِ البراديغمائيِّ والأمبريقي )التَجَرُّبِيّ( للطبيعة الاجتماعية، ما لَم يتم تجاوُز المواقفِ البراديغمائية والأمبريقية للمدنيةِ عموماً وللحداثةِ الرأسماليةِ خاصةً. ما سعيتُ لعمله هنا هو الإقدامُ على تجربة، ولو دون أيِّ استعداد.
عناصر الحضارة الديمقراطية:
قد يَكُونُ مفيداً تسليطُ الضوءِ على مُكَوِّناتِ وعناصرِ المجموعاتِ المندرجةِ ضمن إطارِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي. إذ من الضروريِّ تعريفَ العناصرِ الاجتماعيةِ المتباينة، وذلك مِن جهةِ استيعابِ تَكامُلِها الكُلِّيِّاتيّ. فالتكاملُ الكُلِّيِّاتيُّ لن يَجِدَ معناه إلا ضمن الفوارقِ المتباينة. والمدينةُ كدولة، لا يُمكننا اعتبارَها عنصراً مِن عناصرِ الحضارةِ الديمقراطية. وبشكلٍ مستقلٍّ عن ذلك، فكلُّ مَن يقتاتُ على كدحه، والحِرَفِيوُّن، العمال، العاطلون عن العمل وأصحابُ شتى أنواع المِهَنِ الحرةِ ينَدَرجُون ضمن لائحةِ العناصرِ الديمقراطية، حتى ولو كانوا مدينيين. سنتناولُ مِثلَ هذه المواضيع.
a- الكلانات: كُناّ تطََرَّقنا لها باختصار. وكُناّ بيَنَّاَّ أنّ الكلاناتِ كخليةٍ نواةٍ للمجتمع تَشمَلُ 98 % مِن عمرِ الجنسِ البشريِّ خلالَ مسيرةِ حياتِه الطويلة. لقد كانت الحياةُ شاقةً فعلاً بالنسبةِ لهذه المجموعاتِ المؤلَّفةِ مِن 25 – 30 فردا،ً والمستخدِمةِ لغةَ الإشارة، والمقتاتةِ على القطفِ والقنص. حيث كان صعباً جداً عدمُ الوقوعِ فريسةً للحيواناتِ الكاسرة، وتأمينُ الغذاءِ السليم. كما كان الطقسُ بارداً للغاية في بعضِ الأحايين. كان قد تمَّ عيشُ أربعةِ عصورٍ جليديةٍ هامة. علينا ألا نَمُرَّ على أجدادنا مرورَ الكِرام. إذ، لولا جهودِهم العظيمة، لَما كُنّا نحن. ينبغي البحثَ عن التكاملِ هنا بالذات. ذلك أنّ بشريتنَا الراهنةَ بأكملها مُحَصِّلةٌ لصراعهم في سبيلِ البقاءِ أحياءً. والتاريخُ لا يكَونُ تاريخا بقِسمِه المُدَوَّنِ فحسب. كما أنّ التاريخَ الحقيقيَّ لَن يَجِدَ معناه، دون أخذِ وضعِ طبيعتنا الاجتماعيةِ لِما قبل ملايين السنين في الحسبان. فالمزايا الرئيسيةُ لمجتمعِ الكلان، ربما هي الحالُ الأُولى التي ستُوَحِّدُ البشرية. لقد سَعَينا لنعتِ الكلانِ بالحالةِ الأنقى للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي. هذه المجموعاتُ، التي لا تَنفَكُّ مستمرةً بوجودِها الفيزيائيِّ في العديدِ من البقاع، لا تزالُ مستمرةً بموضعِها كخليةٍ نواةٍ في جميعِ عناصرِ ومُقَوِّمات المجتمعاتِ المتطورة.
b- الأسرة: الكلانُ بذاتها أقرب إلى الأسرة، وإنْ لمَ تُوصَفْ كذلك. فالأسرةُ هي المؤسسةُ الأولى المتباينةُ ضمن الكلان. فبَعدَ العيشِ كعائلةٍ أموميةٍ مدةً طويلةً من الزمن، تمَّ العبورُ إلى عهدِ العائلةِ الأبوية تحت كنفِ السلطةِ الهرمية ذات الهيمنةِ الرجولية المتناميةِ بَعدَ الثورةِ الزراعية – القروية )في أعوام 5000 ق.م على وجه التخمين(. هكذا ترُكت الإدارةُ والأطفالُ لحاكميةِ أكبرِ ذكورِ العائلة سنّاً. أما استملاكُ المرأة، فكان الأرضيةَ لفكرةِ المُلكِيةِ الأولى. وعلى التوالي تمّ الانتقالُ إلى عبوديةِ الرجل أيضا.ً هذا ونصادفُ أشكالَ حُكمِ الأسرةِ الواسعةِ النطاق والطويلةِ الأَمَد على شكلِ سلالاتٍ خلالَ عهدِ المدنية. لكنّ العوائلَ القرويةَ والحِرَفِيةَّ الأبسط ظَلتّ موجودةً وباقيةً في كلِّ الأوقات. أناطَت الدولُ والسلطاتُ الرجلَ – الأبَ ضمن الأسرةِ بدورٍ طِبقِ النسخةِ مِن حاكميتِها. هكذا أقُحِمَت الأسرةُ في وضعِ الوسيلةِ الأهمّ على الإطلاق لشرعنةِ الاحتكارات. فأدََّت دائما دورَ المنبعِ الذي يقُدِّمُ العبدَ، القِنَّ، العامل، الكادح، الجندي، وجميعَ أشكالِ الخدماتِ الأخرى لشبكاتِ الهيمنةِ ورأسِ المال. لهذا السبب أُولِيَت الأسرةُ أهميةً بارزةً وقُدِّسَت. ورغمَ حَظيِ الشبكاتِ الرأسماليةِ بأهمِّ مصادرِ الربحِ تأسيساً على استغلالِ كدحِ المرأة ضمن الأسرة، فقد مارسَت ذلك بشكلٍ مستور، وحَمَّلته بالتالي على الأسرةِ كعبءٍ إضافيّ. لقد حُكِمَ على الأسرةِ عيشُ أكثرِ مراحلها تعصبيةً، بِتَصييرها صَمَّامَ أمانٍ للنظام القائم.
انتقادُ الأسرةِ هام. إذ لا يمُكنها أنْ تكَونَ العنصرَ الأوليَّ للمجتمعِ الديمقراطي، إلا على أساسِ النقد. ومِن دونِ تحليلِ الأسرة – وليس المرأةَ فحسب )الفامينية( – كخليةٍ أوليةٍ للسلطة، ستبقى الحضارةُ الديمقراطيةُ بطموحها وتطبيقها المجاورة( لم يَكُن تَخطيطي للقيامِ بالإمامةِ لمجموعةٍ صغيرةٍ مِن الطلابِ عبرَ عدةِ أدعيةٍ كنتُ حفظتُها، أمراً يسيراً على الفهم. كان بمثابةِ لعبة، ولكني كنتُ أؤديها بكلِّ جدية. أَعتَقِدُ أنّ ما يكَمُنُ وراءَ ذلك كان رغبتي في إثباتِ احترامي لمِا حَفِظتُه مِن الأدعيةِ بمشقةٍ بالغة – وبالتالي لِكَوني بدأتُ أُفَكِّر – بمشاطرتهِ مع الغير. أي أنّ ما حَفِظتهَ شيءٌ صعبٌ وهام، إذن عليكَ باقتسامِه مع الحَول! جليٌّ أني أتعرفُ هنا على مبدأٍ أخلاقيٍّ جاد. ونظراً لأني في المجلداتِ السابقةِ مِن مرافعتي كنتُ سردتُ على شكلِ قصةٍ قصيرةٍ كيف كانت أُولى أضواءِ الحداثةِ تَصعَق عينيّ، فلن أُكَرِّرها هنا. وتَوَقَّفتُ بمجردِ انتباهي بكلِّ تعَقُّلٍ إلى أنّ الحداثةَ الرأسماليةَ قوة مُدَمِّرة في السِباقِ الجنونيِّ لمِاراثون الفكرِ الكبير. لكََم هو غريبٌ جدا أنّ تحطيمَ آلهةِ القرونِ الأربعةِ الأخيرة )النظام الرأسمالي العالمي( حَمَلنَي بَعدَها إلى الشعورِ بقوةٍ مِن العواطفِ والمشاعر الشبيهةِ بسرورِ سيدنا إبراهيم الأورفاليّ أثناءَ خروجِه بغُيةَ «تحطيم الأصنام .» هكذا أصبحتُ في الوقتِ نفسِه أتحكمُ بِرَيبِيَّتي بكلِّ يُسر، وأُحَدِّدُ مواعيدَ مُطَمْئِنةً مع «حقائقي » التي أُلاحِقُها. لقد خارت قوى بني البشر كلياً. ومن المؤلم إسقاطَ موعدِهم مع الحقيقة ربما إلى أَدنى مستويات الغريزية في تاريخهم، بحيث يكاد لم يتَبَقَّ اليوم فردٌ إلا وأسَرَه مِكيالُ زوجةٍ وطفلٍ وراتب. أنا لا أقول بإنكارِ هذه الظاهرة، بل أودُّ تبيانَ البؤسِ الكامنِ في إقامتِها مَقامَ الفلسفة، وعبادتِها وكأنها الفكرُ الأكثر عقلانية. هذا هو نطاقُ العالَمِ الذي وَهَبَته ألوهيةُ الدولةِ القوميةِ لِعِبادها السعداء. فهل يُمكِن إنكارَ كَوننا نحيا في عالَمٍ محصورٍ بشكلٍ فظيع؟ أنا شخصياً أرى العيشَ في كنفِ رمزِ إلهٍ واحدٍ ينحدرُ مِن أقدمِ العصورِ الغابرةِ أفضلَ وأقدسَ ألفَ مرةٍ مِن العيشِ تحت ظلِّ ألوهيةِ الدولةِ القومية الراهنة. بالطبع، إني مدركٌ لكِوني أتحدثُ عن الألوهيةِ الأكثر خواءً لاحتكارِ رأسِ المال. لكن، مع ذلك، فقد بتِّ أنَظرُ بعِينِ الأسى والألمِ لبقاءِ حتى مُتَلَقِّي الضربةِ القاهرةِ مِن هذه الألوهية متأثرين بها، ولِعَجزِهم عن التَعَقُّلِ في النفاذ منها. كما أني منتبهٌ تماماً إلى أنّ هذا هو واقعُ البشريةِ المُعاش. وكون الإبادةِ العرقيةِ اليهودية حَدَثاً يَعكِس ذلك على خيرِ وجه، إنما يَكشِفُ الأبعادَ المأساويةَ للوضع. لَكَم مؤلمٌ أنْ تَكُونَ قصةُ القبيلةِ العبريةِ ذاتَ نصيبٍ هامٍّ في تكوينِ هذا الوضعِ وتقديمِ ضحاياه في آنٍ معاً. وكأنه يضُرَبُ بها المَثلَ القائل «أنتَ فعلت، وأنتَ تنال » . لا يسُاورني الشكُّ حول طابعِ الهيمنةِ لقوةِ الفكرِ اليهودي. كما لا أدحَضُ اهميةَ تأثيراتِ قوةِ هذا الفكر وانعكاساتِها في شخصيتي، ولا أستَصغِرها بتاتاً، بدءاً مِن حفظي للأدعيةِ وصولاً إلى تحطيمي للأوثان. لكنّ مأساةَ التطهيرِ العرقيِّ التي شَهِدَها اليهودُ لوحدِها تَجعَلُ مِن تَمريرِ أنفسِهم مِن مساءلةٍ ومحاكمةٍ جذريةٍ بنمطِ أدورنو دَيناً في رِقابهم. أنا أيضاً سعيتُ إلى التفكيرِ في نظامِ الحضارةِ الديمقراطيةِ وتصَوُّرِه، بنِيِةَّ إيفاءِ كِسرةٍ مِن هذا الدَّينِ بقدرِ ما تأثرتُ به.
نحن إبراهيميون في هذه النقطة. لكنّ التفسيرَ المغايرَ يَكتَسِبُ القوةَ عندما يكَونُ السردُ عن الزرادشتية نوعا ما. فقد تعَرَّضَ مفهومُ التاريخِ السائدُ على هيئةِ قصصِ المدنية إلى انكساراتٍ هامة. هذا ويُجمَعُ عموماً على أنّ مسيرةَ الدولةِ والسلطة قد تَجِدُ معناها كتاريخٍ رسمي، إلا أنه مِن المستحيلِ أنْ تَكُونَ تاريخاً اجتماعياً. لا يُمكن لحقيقةِ تاريخِ نمطِ تكوينِ الدولةِ والسلطةِ إلا أنْ تَكُونَ نقطةً رمزيةً خامدةً ومتطرفةً لصالحِ احتكاراتِ رأسِ المال. كما أنّ هذا السردَ المتطرفَ هو الذي يجَعَلُ التاريخَ مُمِلاً، ولا يُلَبّي متطلباتِ التقاليدِ الاجتماعية. وبِحُكمِ بُنيَتِه المناهِضةِ للمجتمعيةِ مضموناً، واضحٌ أنّ هذا التاريخَ لن يستطيعَ التعبيرَ عن المجتمعِ كتقليد، بل على النقيض – سوف يَحجبه ويُعَرِّضُه للتحريفاتِ مِن مناحي عدة. وما قصصُ السلالاتِ سوى مثيلٌ لهذا السرد. أما سرودُ التاريخِ الديني، التي يَكُون مستوى تمثيلها الاجتماعيِّ سطحياً لأقصى درجة، خاصةً لدى وُلوجِها مرحلةَ التمدن؛ فلا تذهبُ في معانيها أبعدَ مِن تاريخٍ للدولة والسلطة.
هذا وتُذَكِّرُ التفاسيرُ التاريخيةُ الطبقيةُ والاقتصادية بتواريخِ الدولة، وإنْ مِن زاويةٍ مغايرة؛ نظرا لخصائصها التي تتناولُ الحقيقةَ الاجتماعيةَ مبتورةً من الكل، وتبلغُ حدَّ الاختزالية. فوجهةُ نظرها الوضعيةُ الجزئيةُ تفتقرُ إلى القدرةِ على سردِ المعنى حتى بقدرِ تاريخِ الأديان. جميعُ هذه السرودِ التاريخيةِ تَتَّحِدُ في نقطةِ انحدارِ جذورِها إلى المدنية، وإنْ بَدَت متضادةً ظاهرياً.
لستُ مقتنعاً بكَونِ تاريخِ الطبيعةِ الاجتماعية وَجَدَ معناه، سواءً براديغمائياً أم أمبريقياً. فالكتاباتُ التاريخيةُ المسماةُ بالتاريخِ الاجتماعي، لا تذَهبُ في معناها أبعدَ مِن أنْ تكَونَ الفصولَ الأكثر تجَزُّؤا وتنَاَثرُا للسوسيولوجيا الوضعية. أي أنها لا تتعدى كونَها تصويراً لجزءٍ مِن كاملِ الجسمِ أو الوجودِ الكلي.
بالمقدورِ شرحَ كلِّ هذه الإيضاحاتِ مطولاً، إلا أنّ ذلك لن يُقَدِّمَ أيةَ مساهمةٍ لموضوعنا.
أما تعمقي في التاريخِ كشرحٍ للحضارةِ الديمقراطية، ولو على حسابِ التكرارِ المتواصل؛ فهو بسببِ عُقمِ القضايا الاجتماعية، التي لا أزالُ ألُاقي صعوبةً في إيلاءِ المعنى لها.
فالعُقمُ والانسدادُ لا يقتصران على الحياةِ العملية وحسب، بل إنّ السرودَ أيضا مشحونةٌ بالانسدادات الجادة. وباتحادِ الوضعَين معاً، يصبح السيرُ في الميدانِ مستحيلاً بسببِ سرودِ المدنيةِ الرسمية. أما حشرُ بعضِ المقاطعِ الجزئيةِ باسمِ التاريخِ محرومةً من أهمِّ عناصرها. الأسرةُ ليست مؤسسةً اجتماعيةً يُمكن تجاوزها. ولكن، بالإمكانِ تحويلَها. إذ ينبغي التخلي عن مزاعمِ ملكيةِ المرأةِ والأطفال المتَوارَثةِ عن الهرمية، وألا يكَونَ لعلاقاتِ رأسِ المال )بشتى أنواعها( والسلطةِ دورٌ في العلاقاتِ الزوجية.
هذا ويجب تخَطّي التعاطي الغرائزيّ بذريعةِ استمرارِ الجنسِ البشري. الموقفُ الأمثل للوحدةِ بين الرجلِ والمرأة، هو ذاك الذي يَتَّخِذُ مِن فلسفةِ الحريةِ المرتبطةِ بالمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي أساسا.ً والأسرةُ التي ستمَرُّ بالتحولِ ضمن هذا الإطار، سوف تكَونُ أكثرَ ضماناتِ المجتمعِ الديمقراطيِّ سلامةً، وإحدى العلاقاتِ الأساسيةِ في الحضارةِ الديمقراطية. الزواجُ الطبيعيُّ هامٌّ هنا، بدلاً مِن الزواجِ الرسمي. ولكن، على الطرفَين المعنييَّن أنْ يكَونا مستعدَّين دائما لقِبولِ حقِّ هذه الحياة. ولا يمُكن الحِراكَ بعبوديةٍ وعمى في العلاقات. جليٌّ بوضوح أنّ الأسرةَ ستعيشُ أكثرَ تحولاتها معنىً في كنفِ الحضارةِ الديمقراطية. هذا ومن المحالِ تطويرَ الاتحاداتِ الأُسَرِيةّ القَيمِّة، ما لمَ تحَظَ المرأةُ بالتقديرِ والقوةِ العظمى، بَعدَ أنْ خَسِرَت الكثيرَ الكثير من التقديرِ على مَرِّ آلافِ السنين. كما يستحيلُ احترام الأسرةِ المتأسسةِ على الجهل. بالتالي، ذلك أنّ نصيبَ الأسرةِ هامٌّ في إعادةِ إنشاءِ الحضارةِ الديمقراطية.
c- القبائل والعشائر: هي مِن أهمِّ العناصرِ الاجتماعيةِ الأكثر رقياً في مجتمعِ الزراعة – القرية، والتي تحتضنُ العوائلَ في أحشائها، وتَحيا اللغةَ والثقافةَ عينَهما. وهي اتحاداتٌ اجتماعيةٌ ضروريةٌ لأجلِ الإنتاج والدفاع. ذلك أنّ الكلاناتِ والعوائلَ شعَرَت بالحاجةِ للتحول إلى شكلِ القبيلة، عندما باتت قاصرةً عن حلِّ قضايا الإنتاجِ والأمنِ المتصاعدة. كما أنها ليست اتحاداتٍ تَعتَمِدُ على رابطةِ الدمِ فحسب، بل هي عناصرُ نواةٌ للمجتمع، وضروريةٌ من أجلِ تأمينِ الإنتاجِ واستتبابِ الأمن.
هذا وتُمَثِّل التقاليدَ المعمرةَ آلافَ السنين. أما إعلانُها كمؤسساتٍ رجعيةٍ يتوجَّبُ تخطيها بسرعة، فهو مِن أفظعِ الإباداتِ العرقية التي تُمارِسُها الحداثةُ الرأسمالية. ذلك أنه يستحيلُ تحويل البشرِ إلى يدٍ عاملةٍ سَهلةَ الاستغلال، ما داموا باقين في ظلِّ اتحاداتٍ قَبَلِيّة. كما أنّ وجودَ القبيلة كان يعني – وبكلمةٍ واحدةٍ فقط – العدوَّ اللدودَ بالنسبةِ لأسيادِ العبوديةِ والإقطاع. حيث أنّ القبيلةَ لَم تَكُ تَفرضُ العبوديةَ والقِنانةَ والعُماليةَ على أعضائها. للقبائلِ حياتُها القريبةُ من الكومونالية. والقبيلةُ هي الشكلُ المجتمعيُّ الذي يَزدهرُ فيه المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسي بأقوى أشكاله.
بالتالي، فظهورُ القبائلِ المتواصلُ كَعَدُوٍّ لدودٍ للمدنياتِ الكلاسيكيةِ متعلقٌ بمزاياها في المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي. علاوةً على أنه كان يستحيلُ غزوها. فإما أنها كانت تفُنى، أو تحَيا حرةً أبية. ولكن، شُوهِدَ أيضاً أنها عانت التفسخَ والانحلالَ مع الزمن.
ذلك أنّ العملاءَ المتواطئين مِن بين صفوفها، قد لعَبوا أدوارا سلبيةً على الدوام، مثلما يلُاحَظُ ذلك ضمن العائلة أيضاً. ومع ذلك، فالقبائلُ التي يَطغى عليها الترحالُ الدائم، تُعتَبَرُ مِن القوى البَنَّاءةِ الحقيقيةِ للتاريخ. فالعبيدُ والأقنانُ والعمال لمَ يحَيوَا الحالةَ الحرةَ مِن المقاومةِ والعصيان التاريخيِّ للقبيلةِ في أيِّ وقتٍ من الأوقات، بل باتوا بالأغلب خَدَما صَدوقين وأكثر وفاءً لأسيادهم )فيما خلا الحالات الاستثنائية(. وربما لو نظُرَ إلى التاريخِ مِن زاويةِ صراعِ مقاوماتِ القبائل وتصَدِّياتها، بدلاً مِن الصراع الطبقي، لكَان سيسَود التعاطي الأكثر واقعيةً بكثير بشأنه. هذا ومِن أهمِّ تحريفاتِ مؤسِّسي تاريخِ المدنية هو استصغارُ دورِ القبيلة، والنظرُ إليها بعينٍ سلبيةٍ أحياناً، وعدم إناطتها بأيِّ دورٍ كان. تَمَيَّزَت العشائرُ بأهميةٍ أكبر كضربٍ من فيدراليةِ التجمعاتِ القَبَلية. وقد اكتَسَبَت وجودَها بنسبةٍ ساحقةٍ تجاه اعتداءاتِ المدنياتِ العبودية. فالحاجةُ إلى الاتحادِ والمقاومةِ في مواجهةِ الفناء، قد وَلَّدَت تنظيمَ العشيرة. إنها شكلُ المجتمعِ الذي تَحَقَّقَ تنظيمُه العسكريُّ والسياسي بسرعة. وهي تلقائياً جيشٌ وقوةٌ سياسيةٌ أساسُها الوحدةُ الذهنيةُ والتنظيمية. وتَحمِلُ معها ماضياً عريقاً وثقافةً سحيقة. وهي المصدرُ الرئيسيُّ لثقافةِ القوميات. هذا ولا يمُكن الاستخفاف بمساهماتها في الإنتاج.
فبُناها الاجتماعيةُ الجماعيةُ تقتضي التعاونَ المتبادلَ أساساً. والروحُ الكومونيةُ وطيدةٌ في المجموعاتِ العشائريةِ والقَبَلِيّة. بالتالي، فهي مِن العناصرِ البَنَّاءة للحركاتِ الوطنية. ولكن، قد تكَونُ أكثرَ خطورةً لدى تطَوُّرِ العَمالة. إنها مِن أهمِّ القوى المُحَرِّكةِ للتاريخ، بالرغمِ مِن كلِّ مساعي مؤرِّخي المدنيةِ في الحطِّ من شأنها واعتبارِها.
حيث ما كان للبشريةِ أنْ تتخلصَ من التحولِ إلى عِبادٍ وحشدٍ قَطيعيٍّ، لولا مقاومات العشائرِ في سبيلِ تقاليدِ الحريةِ والكومونالية والديمقراطية. وكونها مِن أهمِّ عناصرِ الحضارةِ الديمقراطية، إنما مرتبطٌ بمزاياها تلك. تاريخُ الحضارةِ الديمقراطية هو بنسبةٍ كبيرةٍ تاريخُ مقاومةِ وتَمَرُّدِ القبائل والعشائر، وإصرارِها على حياةِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسيِّ في سبيلِ الحرية والديمقراطيةِ والمساواة تجاه اعتداءاتِ المدنية. كما أنّ البُنى القَبَليةَ والعشائريةَ هي التي تُضفِي اللونَ الأصليَّ على المجتمعات. أما إفناءُ الدولةِ القوميةِ لجميعِ الثقافاتِ القَبَلية والعشائريةِ بوطأةِ مجموعةٍ أثنية،
فهو إبادةٌ ثقافيةٌ بكلِّ معنى الكلمة. لا تَبرَحُ هذه الإبادةُ العرقيةُ الكبرى بِحَقِّ المجتمعِ تُشَكِّلُ التهديدَ الأخطرَ والأهم، رغمَ ترَاخيها نوعا ما. بمقدورِ القبائل والعشائرِ أداءَ دورها الرئيسيِّ في تكوينِ الأمةِ الوطنية، بدلاً مِن دولةِ الأمة أو أمةِ الدولة، وذلك بوصفها عناصر بَنَّاءةً فيها. إنّ اعتبارَ العشائر والقبائلِ عناصرَ أصليةً للحضارةِ الديمقراطية انطلاقاً مِن هذه الدوافع والماهياتِ أمرٌ مفهومٌ لأقصى درجة.
d- الأقوام والأمم: إنّ تشَكُّلَ وحياةَ المجتمعاتِ على شكلِ أقوامٍ وأممٍ في الحضارةِ الديمقراطية يختلف عما في المدنيةِ الكلاسيكية. فالمدنياتُ الرسميةُ تَصطَلِحُ الأقوامَ والأمم على أنها امتدادٌ للسلالةِ والمجموعةِ الأثنية الحاكمة. أي، تتم رواية القومِ والأمة ممتَنَّةً بالفضلِ للسلالةِ والمجموعةِ الأثنية الرسمية. وبذلك يُطمَس وضعُ المجتمعِ الطبيعي في أحشاءِ تاريخٍ زائفٍ مُلفَقَّ. وبتحويلِ الأشخاص البارزين من بين السلالة والمجموعةِ الأثنية الحاكمة إلى أبطال، يكَونُ قد خُلقِ آباءُ القومِ والأمة. وخطوة أخرى قَبلهَا أو بعدَها تؤدي إلى التأليه. ويتمُّ تناوُلُ التاريخِ بأحدِ المعاني على أنه فنُّ تصنيعِ وابتكارِ أولئك الآباء )الأسلاف( وتأليههم. بينما الحقيقةُ مختلفة. ذلك أنّ طبيعةَ المجتمعِ التي تتطور على شكلِ قبائل وعشائر، تبدأ بالتكَّوُّنِ كقومٍ وأمة، كلما زادَ استقرارها وتطَوَّرَت لغتهُا وثقافتُها المشتركة، وكلما حافَظَت على هويةِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي الكامنةِ فيها. أي أنّ المجتمعاتِ لا تُولَدُ بهويةِ القومِ والأمة منذ البداية. ولكنها لَم تَقتَرِبْ كثيراً من هويةِ القومِ إلا في العصورِ الوسطى، ومن هويةِ الأمة إلا في العصرِ القريب.
القومُ ضربٌ من ضروب لوازمِ هويةِ الأمة. حيث يشُاهَد تَحَوُّلُ الأقوامِ إلى أممٍ بطريقَين اثنَين تماشياً مع العصر الحديث. إذ يُلاحَظ أنّ المدنيةَ الرسميةَ سَعَت لتحويلِ التعصب القوميِّ إلى نزعةٍ قومويةٍ عصرية، وعَمِلتَ الدولةُ على إبرازِ البورجوازيةِ والشكل الجديدِ لمجتمعِ المدينةِ باعتبارهما أمةَ الدولة. مجموعةٌ أثنيةٌ حاكمةٌ تؤدي دورَ النواةِ الأساسية. بحيث تُعَمِّمُ هويتَها على جميعِ الأمة. بل وحتى أنّ القبائلَ والعشائر والأقوامَ والأمم ذات الهوياتِ المغايرة للغاية، تخُضَع لعمليةِ الصهر عنوةً في بوتقةِ لغةِ وثقافةِ تلك المجموعة الأثنيةِ المسيطرة. هذا هو الطريقُ المسمى ب »التحويل الوحشي إلى أمة ». وقد طُبقِّت هذه المجزرةُ الثقافية الأشنع في التاريخ على كافةِ لغاتِ وثقافاتِ القبائل والعشائرِ والأقوام والأمم من خلال مواقفِ المدنيةِ الرسمية تلك. من هنا، يأتي هذا النمطُ من الأقوام والأممِ في مقدمةِ العناصرِ الواجب التركيز عليها بالأكثر في إنشاءِ الحضارةِ الديمقراطية باعتبارها تاريخاً ونظاماً.
السبيلُ الثاني في التحولِ إلى أمة يتحققُ بتحويلِ المجموعات المتمايزة أو المتشابهةِ في اللغةِ والثقافة إلى مجتمعٍ ديمقراطيٍّ ضمن نطاقِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي، وذلك على أساسِ السياسةِ الديمقراطية. وفي هذا التحولِ إلى أمة، تَحتلُّ جميعُ القبائلِ والعشائر والأقوامِ وحتى العوائل مكانَها كمُكَوِّناتٍ قائمةٍ بذاتها ضمن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي، ناقِلةً غِناها في لهَجاتهِا وثقافاتهِا إلى الأمةِ الجديدة. وفي هذه الأمةِ الجديدة، لا مكانَ بتاتاً لطغيانِ أو هيمنةِ طابعِ مجموعةٍ أثنيةٍ، أو مذهب، أو عقيدة، أو أيديولوجيةٍ ما بمفردِها.
ذلك أنّ التركيبةَ الجديدةَ الأغنى هي تلك التي تتحققُ طوعياً. بل وحتى بمقدورِ العديد من المجموعات اللغويةِ والثقافية المختلفة العيشَ كمجتمعاتٍ ديمقراطيةٍ على شكلِ وحدةٍ Birim عُليا مشتَرَكةٍ لجميعِ الأمم، وكهويةِ أمةِ الأمم بوساطةِ السياسةِ الديمقراطية نفسها. هذا هو الطريقُ المناسب للطبيعةِ الاجتماعية. أما في أسلوبِ أمةِ الدولة، فعلى أساسِ مواقفِ الحداثة الرأسمالية، وبحالتها المُتَجَرِّدةِ من المجتمع الطبيعيِّ بنسبةٍ كبيرة، فهي تَحيا بوصفها «لغة واحدة، أمة واحدة، وطنا واحدا،ً ودولة واحدة )مركزية( »، لتِكُوِّنَ ذاتَها على نمطِ نسخةٍ علمانيةٍ جديدةٍ معدَّلةٍ من المفهوم القديمِ ذي الدين الواحد والإلهِ الواحد؛ متحولةً بالتالي إلى شكلٍ جديدٍ لاحتكارِ رأسِ المالِ والسلطة والدولة في الوقتِ نفسه. بمعنى آخر، فأمةُ الدولةِ تُعَبِّرُ عن حقيقةِ كونِ احتكارِ رأسِ المال والسلطة في مرحلةِ التحولِ الرأسماليِّ متموقعاً في المجتمعِ مِن قمةِ رأسه حتى أخمصِ قدمَيه، مستغِلاً المجتمعَ وصاهِراً إياه في بوتقته. وهي الشكلُ الذي تتحققُ فيه ظاهرةُ السلطةِ القصوى والاستغلالِ الأقصى. إنها تعني تَركَ المجتمعِ للموتِ بتجريده من كافةِ أبعاده الأخلاقيةِ والسياسية، وبِتَنمِيلَ الفرد، وبالتالي خلقِ المجتمعِ الرعاع الفاشي. تؤدي المؤثراتُ التاريخيةُ والأيديولوجية والطبقيةُ الغائرة، وعواملُ رأسِ المالِ والسلطةِ دورَها في ظلِّ هذا النموذجِ الأكثر شذوذاً عن الطبيعةِ الاجتماعية. وقد تحَققَّت الإباداتُ العرقيةُ كحصيلةٍ مشتركةٍ لمجموعِ تلك المؤثرات.
إنّ توَاجُدَ كياناتِ الأمةِ واندماجَها مع بعضها ضمن نظامِ الحضارةِ الديمقراطية، هو الترياقُ المضادُّ لاحتكاراتِ رأسِ المال والسلطة، والسبيلُ الرئيسيُّ للقضاءِ كلياً على عللِ وأسبابِ الفاشيةِ والإبادة العرقية )التورم السرطاني للمجتمع(.
مرةً أخرى، يظَهَر أمامنا تواؤُمُ وتناغُم الطبيعة الاجتماعيةِ مع طابعِ الحضارة الديمقراطية.
e- عناصر القرية والمدينة: يتغيرُ معنى القرية والمدينةِ في تصوُّراتِ )براديغما( الحضارةِ الديمقراطية. فكيفما أنّ الزراعةَ والصناعةَ مجالان إنتاجيان يقتضيان بعضَهما البعض، كذلك فالقريةُ والمدينةُ أيضاً عنصران يقتضيان بعضَهما البعض للاستقرار. إذ ثمة بينهما توازنٌ لا بُدَّ من الحفاظ عليه. ولدى اختلالِ هذا التوازن، يغَدو الطريقُ مفتوحا أمام ظهورِ الكوارثِ الأيكولوجية، وطغيانِ الطبقةِ والدولة بلا هوادة، وتحَوُّلِ رأسِ المالِ إلى احتكار. هذا وتدَخُلُ التجارةُ طريقاً غيرَ شرعيٍّ باستغلالِ فارقِ الأسعار. إنّ قولَ «نعم » للمدينة » و »لا » لاحتكاراتِ الطبقة – الدولة – رأس المال، نقطةٌ هامة. ينبغي العملَ أساساً بهذه المعاييرِ الأولية في سبيلِ تفسيرِ التاريخ من ناحيةِ تَطَوُّرِ ونماءِ المدينة والقرية.
أما إلصاقُ يافطةِ «الحضارة » بثالوثِ المدينة – الطبقة – الدولة، فهو واقعٌ مؤلمٌ وهزليٌّ بكلِّ معنى الكلمة. كما أنّ نعتَ الجماعات التي تعيشُ على نهجِ الطبيعةِ الاجتماعية الحقيقية ب »الوحشية » و »البربرية »، يذُكِّرُنا بمثالِ اللص ياووز . فالبربريةُ والوحشيةُ الحقيقيتان هما نهبُ الطبيعةِ الاجتماعية وتدميرها. وهذا الأمرُ بذاته يتأتى مِن تحالفِ ثالوثِ المدينة – الطبقة – الدولة، ومن تحَرُّكِ هذا التحالفِ كالبنيان المرصوص. مرةً أخرى، ومن خلالِ هذا الوضعِ الهزلي بمستطاعنا – وبكلِّ شفافية – رؤيةَ أهميةِ قيامِ الهيمنةِ الأيديولوجية بإظهارِ الحقائقِ بَعدِ قلبِها رأساً على عقب. لقد حافَظَت، ولا تزال تحافظُ الأيديولوجيا على أهميتها طيلةَ التاريخِ على صعيدِ الدنوِّ مِن الحقيقة أو الابتعادِ عنها.
لذا، فالحضارةُ الديمقراطيةُ تُقَيِّمُ الحِراكَ الموَحَّدَ لثالوثِ المدينة – الطبقة – الدولة كبربريةٍ حقة، وتَنظُر إلى المناهِضين له كتعبيرٍ عن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي الحقيقي، فتَقُومُ بأدَلجَتهِم.
مجتمعُ القريةِ هامٌّ كأولِ ظاهرةِ استقرار. والاستمرارُ به بَعدَ تحديثه في عصرِ الصناعةِ ضرورةٌ لا مفرَّ منها للحياةِ الأيكولوجية. القريةُ ليست ظاهرةً فيزيائيةً وحسب، بل هي إحدى المصادرِ الأساسيةِ للثقافة. وهي – كما الأسرة – من المُكَوِّناتِ الأساسيةِ للمجتمع. وهجماتُ المدينةِ والصناعة، واعتداءاتُ الطبقةِ البورجوازية عليها طبقةً ودولةً؛ لا تُغَيِّرُ من هذه الحقيقةِ شيئاً. هذا وتتسمُ بالأهميةِ القصوى باعتبارها العنصرَ الأنسب لتطبيقِ وممارسةِ المجتمع الأخلاقيِّ والسياسي. أما المدينةُ فهي ضروريةٌ من حيثُ إعادةِ تحقيقِ توازنِها مع القرية، ولكنْ بشرطِ تحقيقِ تَحَوُّلِها الحاسم، سواءً على صعيدِ السكان، أم من حيث وظيفيتها. ذلك أنّ إخراجَها من كونهِا مركزَ عجلةِ الاستغلال والقمع، وتمَكُّنهَا من أداءِ دورها كبعُدٍ راقٍ على مسارِ التقدمِ الاجتماعي؛ أمرٌ غيرُ ممكنٍ إلا بالتحول الجذري.
أما إخراجُ المدينةِ من كونهِا مكانَ التضخمِ السرطاني للطبقةِ الوسطى ورأسِ المال، سواءً باعتبارهما دولةً أم بيروقراطيي الشركات؛ فيتميزُ بالمكانةِ والمعنى المِحوَرِيَّين في خلاصِ مجتمعِ عصرِنا الراهن. ذلك أنّ المدنَ بحالاتها القائمةِ بمثابةِ مراكزَ رئيسيةٍ تَستَهلِكُ المجتمعَ بسرعةٍ كبيرةٍ حقاً، سواءً من حيث نطاقها أم معانيها )باعتبارها تعني الدمارَ الأيكولوجيَّ وإبادةَ المجتمع(. كما أنها وثائقُ دامغةٌ في بَرهَنَةِ إفلاسِ المدنية الكلاسيكية. لقد كانت روما متفردةً بذاتها وممثلةً العصورَ القديمة بأكملها. كما أنّ انهيارَها أيضاً كان متفرداً بذاته، وممثلاً للعصورِ القديمة.
أما مدنُ راهننا كمراكزَ لابتلاعِ واحتواءِ المجتمع بأجمعه )بما فيه الريف والقرية(، فتُمَثِّل غالبيةَ المجتمع السرطاني، بل وتكادُ تكَون كلَّ ما فيه. لذا، ينبغي عدم الريب مِن أنه لو لمَ يتخلصَّ الإنسانُ كمجتمع من المدينة التي آلت إلى هكذا حال، فإنها ستُخرِجُ من كونه طبيعةً اجتماعية!
يَحظى الاتحادُ المتناغمُ للقرية والمدينة في ظلِّ منهجيةِ الحضارة الديمقراطيةِ بأهميةٍ رئيسيةٍ أيديولوجياً وبنيوياً.
فالطبيعةُ الاجتماعيةُ لا يُمكِنُها ضمانَ الاستمرارِ بوجودها، إلا بالتأسيس على هذا التناغم.
f- العناصر الذهنية والاقتصادية: الأساسُ الاقتصاديُّ للحضارةِ الديمقراطية على تناقضٍ دائمٍ مع احتكاراتِ رأسِ المال المَبنِيّةِ على الفائضِ الاجتماعي. فهو منفتحٌ بِحُرِّيّة على شتى أشكالِ النشاطاتِ الزراعية والتجاريةِ والصناعية، بشرطِ أخذِ الاحتياجاتِ الاجتماعيةِ الأساسيةِ والعناصرِ الأيكولوجيةِ بعينِ الحسبان في تَطَوُّرها. وهو يَعتَبِرُ المكاسِبَ شرعيةً ما دامت خارجَ إطارِ الربحِ الاحتكاري. كما أنه ليس مضادا للسوق، بل على العكس، هو اقتصادُ سوقٍ حرةٍ حقيقيةٍ، نظراً للوسطِ الحرِّ الذي يُوَفِّرُه. ولا ينكر دورَ المنافسةِ الخَلاّقة في السوق. ما يناهِضه هو أساليبُ الكسبِ بالمُضارَبة. أما المعيارُ في قضيةِ المُلكِية، فهو العطاء. في حين أنّ دورَ الاحتكار كمُلكيةٍ يتناقضُ مع العطاءِ في كلِّ الأوقات. لا تندرجُ المُلكِيةُ الفردية المفرطة، ولا مُلكيةُ الدولة ضمن إطارِ الحضارةِ الديمقراطية.
فالاقتصادُ في الطبيعةِ الاجتماعية قد مُورِس دوماً على شكلِ مجموعات. إذ لا توجدُ علاقةٌ للفرد أو الدولة بمفردِهما مع الاقتصاد، فيما خلا الاحتكار. وأشكالُ الاقتصاد التي يكَونُ فيها الفردُ أو الدولةُ موضوعَ حديث، إما أنْ تتجهَ صوبَ الربح أو الإفلاسِ بالضرورة. بينما الاقتصادُ هو عملُ المجموعاتِ على الدوام. وهو الميدانُ الديمقراطيُّ الحقيقيُّ للمجتمع الأخلاقي والسياسي. الاقتصادُ ديمقراطية. والديمقراطيةُ ضروريةٌ للاقتصاد أكثر من غيره. وبهذا المعنى، لا يمكن تفسير الاقتصادِ كبنيةٍ تحتيةٍ أو فوقية. بل من الواقعيةِ أكثر تقييمه كممارسةٍ ديمقراطيةٍ أساسيةٍ أكثر بالنسبة للمجتمع. تحليلاتُ العلاقاتِ الاقتصادية التي جَرَّدَتها تقييماتُ الاقتصاد السياسيِّ الرأسمالي والتفسيراتُ الماركسية، إنما هي مَحفوفةٌ بالمخاطر الجَمّة. إذ لا يمكن للاقتصاد أنْ يَنحَصِر في ممارسةِ ربِّ العمل – العامِل بتاتاً. أنا شخصياً مرغَمٌ على تقييمِ ثنائيِّ ربِّ العمل – العامِل بأنهما لِصّان احتكاريان للاقتصادِ الذي هو ممارسةٌ ديمقراطيةٌ أساسيةٌ للطبيعةِ الاجتماعية )إذا ما أَدرَجنا عهدَي الكلان والقبيلة في ذلك، فسيكون من الأنسب تسميته بالنشاط الأولي للمجتمع الأخلاقي والسياسي(. مَقصَدي مِن العامل هنا هو ذاك العامِل المتنازِل الذي يمُنحَ باسمِ الأَجرِ جزءا زهيدا مما سُلبِ وسُرِقَ من بؤساءِ المجتمع الآخَرين، وخاصةً من رَبّاتِ البيوتِ والفتيات العامِلات بلا أَجر. فكيفما أنّ العبدَ والقِنَّ امتدادان لسيدهما وأفنديهما بالأرجح، كذلك، فالعامِلُ المتنازِل امتدادٌ لرِبِّ العمل في كلِّ زمان. الشرطُ الأول للتحلي بالأخلاق والسياسةِ القويمَين، هو النظرُ بِعَينِ الشكِّ والريبة إلى الاستعبادِ والاستقنانِ والتحول العُمّالي، ومناهضته، وتطويرُ الممارسةِ والأيديولوجية تأسيساً على ذلك. فمثلما أنّ ثالوثَ السيد – الأفندي – رب العمل غيرُ
جديرٍ بالثناءِ والمدح، فمن المحال بتاتاً إجلالَ ثالوثِ العبد – القن – العامل كشرائح اجتماعيةٍ فاضلة. أما الموقفُ الأصح، فهو التأسفُ على وضعِهم كشرائحِ المجتمعِ المنحطة، والعمل على تحريرهم بأسرعِ ما يمكن.
الاقتصادُ بماهيته الأساسيةِ هو الممارسةُ التاريخيةُ للمجتمع.
ما مِن فردٍ )سيدا كان أم أفنديا أم رب عمل أم عبدا أم قِناّ أم عامِلاً( أو دولةٍ يمُكِنهُ أنْ يكَونَ ممثلِّاً للممارسةِ الاقتصادية.
وعلى سبيلِ المثال، ما مِن فردٍ يمكنه دفعَ ثمنِ عملِ الأمومة التي تُعَدُّ المؤسسةَ الأكثر تاريخيةً ومجتمعيةً بلا نظير، سواءً كان ربَّ عمل أو أفنديا أو سيدا أو عاملاً أو قرويا أو مدينيا.ً ذلك أن الأمومةَ تعُدُّ الممارسةَ الأكثر مشقةً والأَلحَّ ضرورةً بالنسبة للمجتمع، وتُعَيِّنُ استمراريةَ الحياةِ فيه. لا أَوَدُّ الحديثَ عن إنجاب الأطفال وحسب. بل إني أنَظُرُ إلى الأمومة من زاويةٍ فسيحة، باعتبارها ثقافةً، وظاهرةً في حالةِ انتفاضٍ دائمٍ بنبضاتِ فؤادها، وصاحبةَ الممارسةِ المفعمةِ بالذكاء. وهذا هو الصحيح. حسنا،ً ما دامَ الأمر كذلك، تلك المرأةُ الضروريةُ لهذه الدرجة، والتي تعاني المشقات، وتمُارِسُ العملَ المتواصل، والمشحونةُ بهذا الكمِّ من الفؤادِ والعقل، والمنتفضةُ على الدوام؛ بأيِّ عقلٍ أو ضميرٍ تتناسبُ معاملتُها ككادحٍ بلا أَجر؟ كيف للماركسيةِ المعروفة بأنها أيديولوجيةُ الكادحين بلا منافس أنْ تَعرضَ علمَ الاقتصاد وحَلَّه على أنه اجتماعي، مع أنها أَبقَت على أصحابِ الممارسةِ الاجتماعية كالمرأة وأمثالها خارجَ الأَجر، و لم يخَطُروا ببالها قطعيا،ً وأجَلسََت غُلامَ وخادِمَ ربِّ العمل في الزاويةِ الرُّكن؟ الاقتصادُ الماركسي اقتصادٌ بورجوازيٌّ بنحوٍ خطير. وهو بحاجةٍ لتقديمِ نقدٍ ذاتيٍّ جدّيّ.
فالبحثُ عن الاشتراكية في ساحةِ مصالحِ البورجوازية، دونَ تقديمِ النقد الذاتي بجرأة؛ لا يعني سوى تقديم أثمنِ الخدماتِ للنظام الرأسماليِّ بلا مَقابل، تماماً مثلما لوحِظَ في إفلاسِ حركةِ القرن ونصفِ القرن )الاشتراكية المشيدة( وانهيارِها )بل وتلقائياً(. كَم كان لينين صادقاً عندما قال «الطريقُ إلى جهنم مرصوفةٌ بِلَبَناتِ النوايا الحسنة »! تُرى، هل كان نفسُه يتصور أنّ هذه الجملةَ سوف تُؤكِّدُ صحتَها في ممارسته هو أيضاً؟ آملُ تطويرَ هذه التحليلات في الفصول المعنية.
يُمكن التفكير في موضوعِ الاقتصاد على أنه ممارسةٌ أوليةٌ للمجتمع الأخلاقيِّ والسياسي التاريخي، بل وتصييره علماً تجريدياً إنْ تَطَلَّبَ الأمر. أما التفكير بِكَونِ الاقتصاد السياسي الأوروبيِّ المحورِ علماً، فربما يعني وقوعَ العقلِ أسيراً لميثولوجيا ثانيةٍ هي الأكثر استعماراً بعد الميثولوجيا السومرية. لذا، فالثورةُ العلميةُ الراديكالية سوف تؤدي دورا مصيرياً بالنسبة لهذا الميدان.
علينا التبيان، وبكلِّ إصرار، أنه ما مِن ممارسةٍ اجتماعيةٍ هي أخلاقيةٌ وسياسيةٌ بقدرِ الاقتصاد. وهو بتوصيفِه هذا لن يتخلصَ مِن إيجادِ معناه كموضوعٍ هو الأكثر أولويةً في السياسةِ الديمقراطية. عليه، فنظامُ الحضارةِ الديمقراطية المبنيُّ على اقتصادِ المجتمعِ التاريخيِّ الأكثر لُزوماً مِن الطبِّ ألفَ مرة لأجلِ سلامةِ وعافيةِ المجتمع، إنما يَعِدُ بثورةٍ حقيقيةٍ بقدرِ ما يُفَسَّرُ بمنوالٍ سليم.
عاملُ الذهنيةِ ليس بُنيةً فوقيةً بعيدةً عن الاقتصادِ مثلما يُعتَقَد. وبالأصل، فالتمايزات المشابهةُ مِن قَبيلِ الفوقي – التحتي، تُزيدُ مِن تعقيدِ وتشويشِ سياقِ فهمِ الطبيعة الاجتماعية.
ف الطبيعةُ الاجتماعيةُ بذاتها هي الكيانُ الذي يتكاثفُ فيه ذكاءُ الطبيعةِ على أعلى المستويات. أما التفكيرُ بعناصرَ ذهنيةٍ أخرى، فرُبَّما يُقابَلُ بالاستهجان. لكنّ بَترَ العلمِ عن المجتمعِ التاريخي، وحَثهَّ على خدمةِ المدنيةِ الرسمية، وإقحامَه في دورِ مصدرِ القوةِ الأكثر عطاءً بالنسبة للسلطة؛ إنما يُؤكِّدُ أهميةَ إعادةِ النظر في ذهنيةِ وبُنيةِ حياةِ الحضارةِ الديمقراطية. فلَطالما أَبدَت المدنيةُ الرسميةُ بِعِلمِها وهيمنتِها الأيديولوجيّةِ موقفاً مناهِضاً للذهنية وبُناها، وحاوَلَت إيجادَ البدائلِ لها على مَرِّ التاريخ. كما توَاجَدَ الصراعُ الأيديولوجيُّ والحركاتُ العلميةُ البديلةُ في كلِّ الأوقات. والمدنياتُ الكلاسيكيةُ باتت أكثرَ الأنظمةِ استِغلالاً لنماءِ الذكاء التحليلي، حيث استفادت كثيراً من جميعِ مستوياتِ التصورِ والرموز الخياليةِ المُضَلِّلة والمُرعِبة بشتى أنواعها التي لا ضوابطَ لها في دناءتهِا، في سبيلِ طمسِ حقيقتها الاستغلالية. هذا وعَرَضَت وقائعَها المادية في ميادينِ الميثولوجيا والدين والفلسفة والعلموية كواقعٍ اجتماعيٍّ عام، وسَعَت دائما إلى الترويجِ بأن البحثَ عن الحقائق الأخرى عبثٌ وهُراء.
هذا الهدفُ «الانفردي » ممهورٌ بطابعِ إرغاماتِ رأسِ المال والسلطة كسبيلٍ وحيدٍ صحيح. وكأنها دَهَنَت الألوانَ ذات التنوعِ والتباينِ العظيمِ للطبيعتَين الأولى والثانية باللونِ الرمادي في محاولةٍ منها لإثباتِ أنّ اللونَ الرماديَّ لونٌ وحيدٌ انفردي.
كما سَخَّرَت كَمّاً ضئيلاً مما جَمَعَته من فائضِ القيمة لاستخدامِه كرأسمالٍ فكريّ، ولم تُنقِصْ من الهيمنة الأيديولوجية شيئاً.
وتَحَوَّلَت أنظمةُ المدارسِ التعليمية والتربويةِ إلى أماكنَ تُلَقَّنُ فيها أنماطُ حياتها. هذا واستخدَمَت الجامعةَ كمكانٍ للنبذ والإلغاء والإنكار، لا مكاناً لتَبَنّي وتَمَثُّلِ الحقيقةِ والهويةِ الاجتماعية. أما مضمونُ العلم وبُنيتُه، فقد أُعِدَّت بِحِرصٍ وعناية في سبيلِ تشييءِ واقعِ المجتمعِ التاريخيِّ للطبيعةِ الاجتماعية، وعزلِه عن دوره كذاتٍ فاعلةٍ تحت اسمِ الموضوعية. هكذا عُرِضَت مستوياتُ المدنية ذات النهجِ المتصلب على أنها قواعد وصياغات كونية مُثلى.
يَنعَكِسُ تناغُمُ الحضارةِ الديمقراطية مع الطبيعة الاجتماعية على التطور الذهني أيضاً. فحتى أكثرُ أذهانِ الكلاناتِ طفولةً كانت مُدركةً لارتباطها الحيوي مع الطبيعة. أما تصَوُّرُ «الطبيعة الميتة »، فليس سوى تلفيقٌ وخيانةٌ أطلَقَتها المدنيةُ المبتورةُ تدريجياً عن الطبيعة. وإذا ما أَخَدنا بعينِ الحسبان أنّ الحيويةَ والألوهيةَ التي يَجِدُها عصرُ التمويل العالمي الراهن في «المال »، لا يراها في أيٍّ من كياناتِ الطبيعة الأخرى؛ فسنشُاهِد أنّ المتقدِّمَ والراقي في مضمارِ حيويةِ وألوهيةِ الطبيعة هو واقعُ الكلان، لا الاحتكارات الراهنة. ذلك أنّ القبيلةَ والعشيرةَ والقوم والبنى الوطنيةَ الديمقراطية كانت ميادينَ وجودِ ذهنيةٍ حية. فالذكاءُ والبنيةُ على علاقةٍ مع الحياة.
بالتالي، لا يُمكِنُ للذكاءِ التحليلي والعاطفي بلوغَ تَوَحُّدٍ جَدَلِيٍّ إلا في ظلِّ نظامِ الحضارة الديمقراطية.
إنّ ذهنيةَ الحضارةِ الديمقراطية، التي تَنظُرُ بعينِ الشك إلى أنظمةِ المدارس والأكاديميات والجامعاتِ الرسمية، لَم تتخلفْ عن تطويرِ بدائلها على مرِّ التاريخ. فبِدءاً من أنظمةِ النبوة إلى مدارسِ الفلاسفة، ومن التصوف إلى علومِ الطبيعة؛ قامت بتطويرِ عددٍ لا حصرَ له من المَقامات، غُرف الزاهدين، البؤُر، الطرائق، المدارس، المذاهب، الأديرِة، الكليات، الجوامع، الكنائس، والمعابد. يلُاحَظُ أنّ الحالةَ الثنائيةَ للحضارة، لا الأحادية الانفرادية، هي التي تظُهِرُ نفسَها للعيان في كافةِ ميادينِ الطبيعة الاجتماعية. القضيةُ هي التحلي بالحلِّ في الطرفِ الطبيعَوِيِّ من الثنائية، دون الاختناق في البنية الأحادية الرسمية؛ والقدرةُ على تطويرِ فوارقِ الحياةِ الحرةِ بوصفها خيارَ الحضارة الديمقراطية.
g- عناصر السياسة الديمقراطية والدفاع الذاتي: يؤدي عنصرا السياسةِ والأمن للحضارة الديمقراطية دورا أساسيا في نشوءِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي. تصنيفُ السياسةِ الديمقراطية في مفهومِ المجتمعِ الذي هو سياسيٌّ مِن ذاته بالأصل، قد يكَونُ أمرا زائدا عن اللزوم. ولكن، ثمة فرقٌ بينهما. فقد لا تُمارَسُ السياسةُ الديمقراطية في كلِّ وقتٍ ضمن المجتمعِ السياسي. علماً أنَّ هيمنةَ المَلَكِيّة الاستبدادية غالباً ما فُرِضَت على المجتمع السياسي طيلةَ تاريخِ المدنيةِ الرسمية. لا يَفنى المجتمعُ السياسيُّ كلياً تحت ظلِّ الهيمنة. ولكنه لا يستطيع دمقرطةَ ذاتهِ آنذاك. فكيفما أنّ امتلاكَ الأُذُنِ لا يعني السماعَ في كلِّ الأوقات، بل يقتضي أنْ تَكُونَ الأُذُنُ سليمةً أيضاً؛ كذلك وعلى نحوٍ مشابه، فوجودُ النسيجِ السياسي أيضاً لا يعني أنه فعالٌ بحرية في كلِّ الأوقات. حيث أنَّ عَمَلَ النسيجِ بمنوالٍ سليمٍ مشروطٌ بوجود أجواءٍ ديمقراطية.
بشكلٍ عام، بالمقدور إطلاق تسميةِ السياسةِ الديمقراطية على وجودِ المناخ الديمقراطي والبنية السياسيةِ للمجتمع السياسي. فالسياسةُ الديمقراطية ليست مجردَ نمط، بل وتُعَبِّرُ عن تَكامُلٍ مؤسساتيٍّ أيضاً. إذ لا يُمكن تطوير ممارسةِ السياسةِ الديمقراطية، دون وجودِ التمأسُساتِ العديدةِ من قَبيِل الأحزاب، المجموعات، المجالس، الإعلام، والمحافل وغيرها. الدورُ الأُساسيُّ للمؤسسات هو النقاشُ والتداولُ وصياغةُ القرارات.
إذ لا يمكن للحياة أنْ تَسيرَ في جميعِ الأعمالِ المشتركة للمجتمع، دون وجودِ المداولات واتخاذ القرارات. فإما أنْ تنتهي حينها إلى الفوضى العمياء، أو إلى الديكتاتورية. هكذا هو مصيرُ المجتمع اللاديمقراطي دائماً، حيث يبقى مترنحاً بين طَرَفَي الفوضى والديكتاتورية. ولا يمكن التفكير بنماءِ المجتمع الأخلاقي والسياسيِّ في هكذا أجواء. إذن، والحالُ هذه، فالهدفُ الأوليُّ للكفاح السياسي، أي للسياسة الديمقراطية؛ هو إنشاءُ المجتمعِ الديمقراطي، والوصولُ به إلى أفضلِ الأحوال بإجراءِ المداولات وصياغةِ القرارات المعنية بالأعمال المشتركة ضمن هذا الإطار.
الوصولُ إلى السلطة هو الهدفُ الأوليُّ للسياسةِ المُبعَدَة عن وظيفتها الحقيقية، والمتنامية في أجواءِ ومؤسساتِ ما يُسمى بالديمقراطيةِ البورجوازية. والسلطةُ بدورها تعني انتزاعَ الحصةِ من الاحتكار. جليٌّ تماماً استحالة وجودِ هكذا أهدافٍ للسياسةِ الديمقراطية. ولو أنها احتَلَّت مكانَها في مؤسساتِ السلطة )الحكومة مثلاً(، فالعملُ الأساسيُّ هو عينُه أيضاً حينذاك. وهذا العملُ هو اتخاذُ القراراتِ السليمة ومتابعةُ تنفيذها في سبيلِ المصالحِ الحياتية المشتركة للمجتمع، لا لأجلِ انتزاعِ الحصة من الاحتكار. أما القول باستحالةِ احتلالِ المكانِ ضمن الديمقراطيات البورجوازيةِ كقاعدة، فليس بموقفٍ ذي معنى. في حين ينبغي معرفة كيفيةِ اتخاذِ المكان فيها بشروط. ذلك أنّ اللامبدئية لا تنفعُ سوى في ممارسةِ السياسةِ المزيفة للطبقة الحاكمة باستمرار.
مِن غيرِ الممكن بتاتاً التغاضي عن حاجةِ السياسةِ الديمقراطيةِ للتنظيماتِ الكادرية والإعلامية والحزبية الكفوءة، ولمنظماتِ المجتمع المدني، وللنشاطاتِ الدائمة في الدعاية وتعليمِ المجتمع وتدريبه. أما الخصائصُ الضرورية اللازمةُ لممارسةِ السياسةِ الديمقراطية بشكلٍ مثمرٍ وناجح، فيُمكن ترتيبها كالتالي: الموقفُ الذي يَحتَرمُ جميعَ فوارقِ المجتمع، ضرورةُ المساواةِ والوفاقِ على أساسِ الاختلاف والتباين، الاعتناءُ بمضمونِ النقاش بقدرِ أسلوبه، الجرأةُ السياسية، الأولويةُ الأخلاقية، و »الحاكميةُ » على المواضيع، الوعيُ بالتاريخِ والمجرياتِ الراهنة، والموقفُ العلميُّ المتكامل. الدفاعُ الذاتيُّ هو سياسةُ الأمنِ والحمايةِ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي. أو بالأحرى، فالمجتمعُ العاجزُ عن حمايةِ نفسه، يخَسَر معانيَ صِفاتهِ الأخلاقيةَ والسياسية. وفي هكذا وضع، إما أنْ يكَونَ المجتمعُ قد استعُمِر، فينَصَهِرُ ويتفسَّخ، أو أنه يقُاوِمُ سعياً لاستردادِ صفاته الأخلاقيةِ والسياسية وتفعيلِ وظائفها.
والدفاعُ الذاتيُّ هو اسمُ هذه المرحلة. فالمجتمعُ المُصِرُّ على كينونته، والرافضُ للاستعمار وشتى أنواعِ التبعية المفروضةِ من طرفٍ واحد، لا يمُكِنهُ تبَنَيِّ موقفه هذا إلا بإمكانياته ومؤسساتهِ المعنيةِ بالدفاع الذاتي. لا يتكون الدفاعُ الذاتيُّ حيالَ المخاطرِ والضغوطِ الخارجية وحسب. فالتناقضاتُ والتوتراتُ محتَمَلةٌ في كلِّ وقت ضمن البنى الداخليةِ للمجتمع أيضاً. ينبغي عدم النسيانِ أنه ما دامت المجتمعاتُ التاريخيةُ طبقيةً وسلطويةً مدةً طويلةً من الزمن، فستبقى القوى الساعيةُ للحفاظ على خاصياتها تلك مدةً أطول. وستُقاوِم تلك القوى بكلِّ طاقاتها من أجلِ صَونِ وجودها وكياناتها. بالتالي، فسيحتلَّ الدفاعُ الذاتيُّ مكاناً هاماً في أجندةِ المجتمعِ ردحاً طويلاً من الزمن كطلبٍ اجتماعيٍّ شائع. إذ ليس من اليسير على قوةِ القرار أنْ تدَخُلَ حيزَ التنفيذ، دون تعزيزها بقوةِ الدفاع الذاتي.
علماً أننا في راهننا وجهاً لوجه أمامَ حقيقةِ سلطةٍ متغلغلةٍ حتى مساماتِ المجتمعِ كافةً، ليس من خارجه وحسب، بل ومن داخله أيضاً. لذا، فتكوينُ مجموعاتِ الدفاع الذاتيِّ المتشابهة داخلَ جميعِ مساماتِ المجتمع المناسِبةِ أمرٌ مصيريّ. فالمجتمعاتُ المفتقِدةُ للدفاعِ الذاتيّ مجتمعاتٌ مستعمَرةٌ ومفروضٌ عليها الاستسلامُ مِن قِبلَ احتكاراتِ رأسِ المال والسلطة. لكلِّ مُكَوِّنٍ في المجتمع قضيتُه في الدفاعِ الذاتيِّ دائماً وعلى مرِّ السياقِ التاريخي، بدءا مِن الكلانات إلى القبائلِ والعشائر، ومن الأقوامِ إلى الأمم والجماعات الدينية، ومن القرى إلى المدن. فاحتكارُ رأسِ المالِ والسلطة أَشبَهُ بانقضاضِ الذئب على فريستِه التي يُطارِدُها. وكلُّ مَن افتقَرَ للدفاع الذاتي، قامَ بتشتيته كما قطيع المواشي، مستولياً عليه قدرَ ما شاء.
إنّ تشكيلَ كيانِ الدفاعِ الذاتيِّ وممارسته، والحفاظَ عليه جاهزاً وفعالاً دائماً، شرطٌ لا بُدَّ منه في كينونةِ المجتمعِ الديمقراطيِّ والاستمرارِ بوجوده، ولو بمِا يكَفي للحَدِّ مِن اعتداءاتِ واستغلالاتِ احتكاراتِ رأسِ المال والسلطة كحدٍّ أدنى. ونظرا لأنه سيتم العيش مع أجهزةِ رأسِ المالِ والسلطة بشكلٍ متداخلٍ لأَمَدٍ طويل، فمن المهمِّ بمكان عدم الانزلاق في خطأَين اثنَين. الخطأ الأول؛ تسليمُ المجتمعِ أمنَه الذاتيَّ للنظامِ الاحتكاري، كأنْ تأَتمَن القِطَّة على الكَبدِ. وقد ظَهَرَت للعيان النتائجُ التدميريةُ لذلك مِن خلال آلافِ الأمثلة. الخطأ الثاني؛ العمل على التحول الفوريِّ إلى جهازِ سلطةٍ تجاه الدولة، بكلمةِ سرٍّ فحواها أنْ تكَُون كالدولة. وتجاربُ الاشتراكيةِ المشيدةِ تنويريةٌ في هذا المضمار بما فيه الكفاية. من هنا، فالدفاعُ الذاتي القَيمِّ والفعال سوف يبَقى عنصرا لا يمكن الاستغناء أو التغاضي عنه في الحضارةِ الديمقراطية، تاريخياً أم راهناً أم مستقبَلاً.
لا ريب أنه بالمستطاع الإكثار مِن عناصرِ الحضارةِ الديمقراطية، وشرحها أكثر. ولكني على قناعةٍ بأنّ هذا العرضَ كافٍ من حيث استيعابِ الموضوع وإدراكِ أهميته.