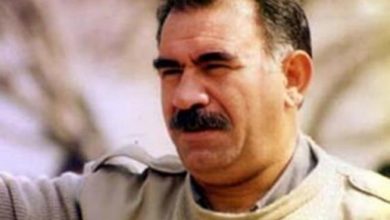في العلمانية …في المدنية ؟
في العلمانية ...في المدنية ؟

 سيهانوك ديبو
سيهانوك ديبو
يكتنفُ استخدام مفهومَي »الدولة المدنية « و «الدولة العلمانية « في خطابنا اليومي غموضٌ وخلطٌ وملابسات، لاسيما منذ بدء ثورات الربيع التي فتحت بابَ الجدل على مصراعيه حول هذين المفهومين اللذين باتا يتصدَّران أهداف هذه الثورات. للإجابة على عنوان هذا المقال، وللتطرّق للصعوبات التي ستواجه علمنَةَ الدول المدنية التي تنشدها الثورات العربية، يلزم التذكير أولا بتعريفي لهاتين الدولتين. الدولة العلمانية (المتجذّرة في حيوات معظم الدوّل المتقدّمة من أمريكا غرباً حتى اليابان شرقاً، مروراً بكلّ أوربا) دولةٌ تفصل بين السلطات السياسية، والمالية، العلمية، والدينية.
تخضعها جميعاً للقانون المدنيّ الذي يحدِّدُ أدوارها وميثاق علاقاتها. كلمة »الفصل « هنا ليست شديدة الأهمية فقط، لكنها بيت القصيد… ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل: المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص. المجال العام (الذي يضمّ المدرسةَ، والفضاءَ المدني عموماً) مكرٌّس لما يخدم جميع الناس، بغضّ النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية. لا مرجعية فيه لأي دينٍ أو فلسفةٍ إلحادية. أما المجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية. المبدأ الثاني: تضمنُ الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم وتحترمها بحق. لعلّ مفهوم »الدولة المدنية « انبثق غداة اندلاع الثورات العربية، واكتسب أهمية متصاعدة بعد أوّل انتصاراتها. يُعرِّفُ الكثيرون هذه الدولة بأنها دولة ’تحقق جملة من المطالب المتعلقة بالمواطنة المتساوية وبالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وغيرها من المطالب المتصلة بحاجة الشعوب العربية إلى التطور والتنمية، وتستمدُّ قانونها من الشريعة الإسلامية. لا تختلف الدولة المدنية هكذا كثيراً عن الدولة الدينية التقليدية إلا بنزعتها المُعلنة لإرساء الديمقراطية والمساواة ومواكبة العصر الحديث، فيما تختلف بشكلٍ ملحوظ عن الدولة العلمانية. لإجلاء ذلك يلزمنا تحديدُ بعض الفوارق الجوهرية بين مفهومَي هاتين الدولتين. أو بالأحرى يلزمُنا توضيح ما أضافته الدولة العلمانية للحضارة الإنسانية، وما لا تمتلك الدولة المدنية شروط تحقيقه. لعلّ أحّد أبرز ما حققه مفهوم العلمانية على الصعيد الحضاري هو انهاء الصراعات والاضطهاد الطائفي والحروب الدينية في الدول التي ترسَّخَ فيها هذا المفهوم، بفضل مبدئه الثاني. يكفي على سبيل المثال تذكُّرُ الخلافات الصدامية بين البروتستانتية والكاثوليكية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والحروب الدينية الطاحنة التي سبقت عصر العلمانية. صارت هذه الحروب والصراعات مستحيلةً اليوم في المجتمعات مفهومِ الدولة المدنية للمبدأ العلماني الثاني لا يبعث الأمل العلمانية بفضل المساواة المطلقة بين الجميع. لعل عدم اعتناق الجاد بإمكانية التساوي الكليّ الحقيقي بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية في دولنا المدنية المنشودة، أو بإمكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئةٍ عن أخرى. ناهيك أن أدبيات الدولة المدنية لا تضمن الاعتراف بحقِّ عدم الإيمان أو الإلحاد. أحد أبرز الانجازات الحضارية الأخرى للدولة العلمانية إلغاؤها المطلق لشرعية أي فتوى دينية او سياسة تمس حياة عالم او مفكر أو تمنع إصدار أي كتاب، كما ازدحم تراجيدياً بذلك تاريخُ ’فتاوى‘ الكنيسة في أوربا… لا تبدو في مشاريع دولنا المدنية أية نوايا تتعلق بالفصل القانوني بين الدين والسياسة والعِلم، بغية القطيعة الجذرية مع السابق الحافل بفتاوىٍ دينيةٍ وسياسيةٍ مضرٍّجة بالقمع والدم مسّت حياة مفكرينا وأدباءنا بشكلٍ قياسيٍّ مريع. تظلُّ المدرسة العلمانية أعظم إنجازات الدول العلمانية بلا منازع. يتأسّس عليها التفوق الحضاري لهذه الدول على بقية العالم. فهذه المدرسة (التي يَدرس فيها أبناء غير المتدينين أو ذوي الديانات والمذاهب المختلفة معاً، بشكلٍ حضاريٍّ متآلفٍ متناغم( مفصولةٌ تماماً عن تأثير أي دينٍ كان، أو فلسفةٍ مُلحِدة. تُعلِّمُ الطالبَ كيف يُفكِّر بروحٍ نقديّة، كيف يحكم لوحده دون أي يقينٍ مسبق بأية عقيدةٍ أو أيديولوجية، كيف يمارس حريّته في التحليل والتمحيصِ والرفض، وكيف يبني يوماً بعد يوم شخصيَّته المستق تُكرِّس هذه المدرسة في الطالب العقليَّة العلميَّة الخالصة والحياة انطلاقاً من مبادئ فهمِ الكون وتُنمِّي استخدامَها ل نظريات العِلم والتجربة والبرهان، وعبر دراسة السببية الحديث، لاسيما نظريات النشوء والارتقاء، الانفجار الكوني الكبير (البيج بانج…) تسمح له هذه المدرسة أيضاً الانفتاحَ على استيعاب كلِّ التراث الفكري الإنساني بمختلف تياراته الفلسفية، دينية أو لادينية… هي باختصار: مدرسة ثقافة العقل والحرية والحداثة بامتياز. لا يوجد في مشروع الدولة المدنية، الذي تُلوِّحُ به الثورات العربية حتى الآن، أية رغبةٍ المدرسة العربية وتكوين جليةٍ في قطيعةٍ جذريٍّة مع فلسفة الحالية التي انجبت بامتياز أجيالاً ممن تعلموا الخضوع للجلاد، وترعرعوا في ثقافة التفسيرات الظلامية للكون والحياة، وحافظوا على سمعة تخلفنا العلمي والاجتماعي والحضاري عموماً.
ثمّة أيضاً إنجازٌ حضاريٌّ علمانيٌّ هام: تحوَّل الدين في الدول العلمانية إلى سلطةٍ روحية خالصة، لا يستطيع السياسيّ التحكّم بها. لا يمكنه مثلاً إعداد الخطب الدينية التي تُلقى في المعابد، مثل حال خطب مساجد دولنا الإسلامية التي لا تخجل أحياناً من ها (سادسُ الخلفاء التصريح بأن حاكمَ بلد الراشدين وأميرُ المؤمنين وسليلُ رسول رب العالمين). باختصار شديد: ينتمي مفهوم الدولة العلمانية إلى نخبةٍ من المفاهيم الإنسانية الحديثة الراقية التي تتغلغل جذورها في أعماق الفكر الإنساني العالمي، لاسيما العربي المتنوّر. لا يرتبط هذا المفهوم بالطبع بنظامٍ محدّد، رأسمالي أو اشتراكي، يمينيٍّ أو يساري… رغم توسّع أنتشار العلمانية دوليا، يجد مفهومُ العلمانية عراقيل وكوابح لا حدّ لها في مجتمعاتنا المدنية الشرقية، تنذر بصعوبةٍ هائلة ستواجه عَلمنَة دوله المنشودة. لعلّ أبرز مناهضي هذا المفهوم هم الظلاميون الذين يمارسون تجاهه تضليلاتٍ ذكيّة باتت واضحة لمن يبغي الوضوح. يرافقهم بالطبع الطغاة الذين يتدخّلون بضراوة في شؤون الدين ويستخدمون الفقيه مطيةً للسيطرة على أدمغة أبناء شعوبهم، وممارسة دكتاتورياتهم. ليس هؤلاء فحسب، بل هناك العديد من »الثوريين « الذين يتسمّرون أمام مفهوم العلمانية أو يعتبرونه، بكل بساطة، كرارهم مفهوماً استعمارياً كونه انطلق من الغرب، رغم ت لمصطلحاتٍ نهضت أيضاً في الغرب ذاته، كالديمقراطية وحقوق الإنسان. ثمّة أيضاً عددٌ من المثقفين الذين يجدون صعوبةً في خوض الانتقال للفكر العلماني، لأسبابٍ متنوّعة لا يمكن حصرها في هذا المقال. لعلّ أبرز هذه الأسباب خيبة هؤلاء المثقفين من السلوك اللاإنساني الجشع، أو اللاعلماني المنافق، لقادة عددٍ من الدول العلمانية الغربية وبعض مفكريها، خارج دولهم أو داخلها أيضاً. وعندهم كلُّ الحق في ذلك أيضاً، منطقاً لفهم الازدواجية في سموّ مبادئ العلمانية ذات البعد الإنساني الراقي من ناحية، وفي خساسة السياسات الاستعمارية والاقتصادية والمالية الجشعة للدول العلمانية وما تصنعهُ من أزمات دولية تدمِّرُ الدول النامية من ناحية أخرى. ويكفي، على الصعيد الداخلي لبعض الدول العلمانية، ملاحظة كيف يلجأ بعض قادتها السياسيين، مثل بعض قادة اليمين الفرنسي، بتسريب تصريحات انتخابية ديماغوجية نتنة، تسيء للعلمانية أساساً، بهدف إرضاء بعض العنصريين من الناخبين الذين لا يحترمون، لسببٍ أو لآخر، الأديان التي دخلت النسيج الاجتماعي الفرنسي في العقود الأخيرة كالإسلام. لا يخلو مواقف بعض قادة اليسار ومفكريه من أخطاء موازية تسيء للعلمانية هي الأخرى عندما تلجأ، في معمعان معارضتها الإيديولوجية لليمين، إلى سلوكٍ لاعلمانيٍّ يدافعُ، باسم الحريّة الشخصية، عن مظاهر دينية ظلامية صارخة، كالنقاب الوهابيّ الطالباني، تتسلل لفضاء المجال العلماني العام الذي يُفترض أن يخلو من أي مظاهر تُخل بالمبدأ العلماني الأول. ولعلّ سلوك بعض العلمانيين المتطرفين، الذين يمارسون العلمانية كدين يسيءُ هو الآخر لمفهومها. لا يستوعب هؤلاء مثلاً دور الأسطورة والأديان في حياة الكثيرين. يغامرون أحياناً بإقحام العِلم والفكر الحر في جدَلٍ هدفه دحض فرضياتٍ دينية بحتة (مع أنها ليست فرضيات علميّة أساساً) أو السخريّة بحدّة من رموزٍ مقدّسة ذات أهميّة عاطفية قصوى في حياة المتدينين… أليس من الكياسة بمكان عدم تجريح هؤلاء أو إيذاء مشاعرهم بمسِّها الكاريكاتوري الواخز؟… إن أنظمة الشرق الانقلابية العسكرياتية؛ التي انقلبت عليها شعوبها في حركات الربيع الثورية حكمت باسم العلمانية علماً أنها لم تسئ إلى العلمانية فقط وإنما شوهت مناحيها كفكر و ممارسة لهذا الفكر النيّر؛ فحقيقة هذه الأنظمة إنما كانت أنظمة تشتمل » مفهوم الدولة القوموية » ذات الخطاب والصيغة الدوغمائية الجامدة ، وهي في الوقت نفسه تربعت في تحكمها التوليتاري باتفاق مع الدول ذات الصيغة الاستعمارية والصبغة اللاإنسانية تجاه دول العالم الثالث ، فكانت بمثابة أقنية كومبرادور تسلب خيرات الوطن وتهد البنية النهضوية لشعوبها …