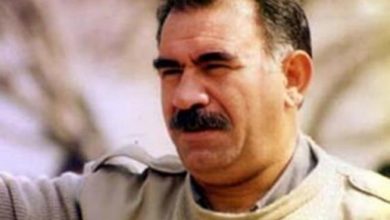أبعاد العصرانية الديمقراطية
أبعاد العصرانية الديمقراطية
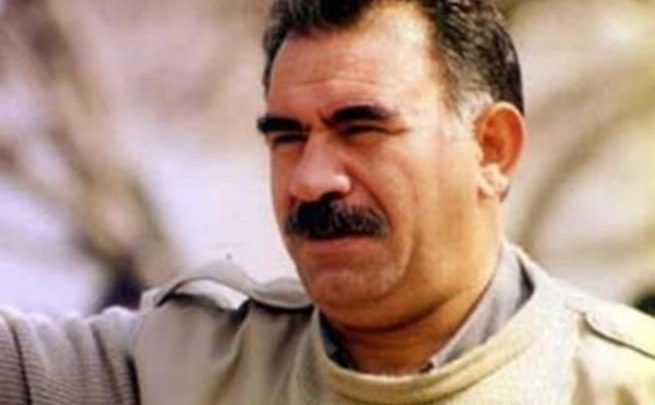
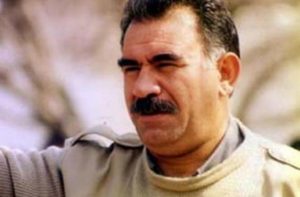 عبدالله أوجلان
عبدالله أوجلان
إني على قناعةٍ بأنّ تحليلاتِنا، إلى جانبِ انتقاداتها الشاملة بشأنِ المدنيةِ والحداثة، قد سَلَّطت الضوءَ قدرَ المستطاع على العصرانية الديمقراطية بالتداخُلِ مع تاريخِ التقدمِ الحضاري على شكلِ فصولٍ تَقومُ بتعريفِ عناصرها الأولية المختلفة. ما سأَجهَدُ لعمله هنا هو إظهارُ الموضوعِ بنحوٍ أفضل بأبعاده الرئيسة وبشكلٍ متكامل. سوف أَرُدُّ على التساؤل: كيف يمكن عرض العصرانية الديمقراطية على شكلِ أبعادٍ رئيسة بالنظر إليها من الأعلى؟ تحطيمُ مفهومِ الحداثة الأُحادِيَّةِ، وكشفُ النقابِ عن كياناتِ المجتمع التاريخي العظيمة التي حَجَبَها ذاك المفهوم؛ ينبغي أنْ يَكونَ دعامةَ عَمَلِنا العلمي هذا. تاريخُ المدنية أَشبَه ما يَكُون بِبِئرٍ دامسِ الظلام، يختَفي قَعرُه كلما تمَّ الغوص فيه. فمهما دَأَبنا على تنويره، تتبدى نقاطٌ أخرى مظلمة على الفور.
بالمقدور التخمين بأنّ الذاكرةَ (الضمير) الاجتماعيةَ ستتعرض لانطِواءات تُذَكِّرُ بِالتواءاتِ الدماغ تحت ظلِّ القصفِ الأيديولوجي طيلةَ آلافِ السنين على يَدِ احتكاراتِ الهيمنة، وأنها ستتكَوَّنُ ظاهرة على شكلِ آلافٍ من الدهاليزِ الملتويةِ بما يُشبِهُ ما نُسَمّيه بِما تحت الشعور. مع ذلك، يجب عدم الاستسلامِ لليأس. فمثلما أنّ التشخيصَ غيرَ السليمِ لعضوٍ في الإنسان لا يمكن معالجته بشكلٍ صحيح، كذلك لا يمكن لأيةِ قضيةٍ اجتماعيةٍ بلوغَ إمكانيةِ التحليل (التشخيص) والحل (العلاج) السليمَين ما لَم يتم تنويرها كفايةً. تماماً.
حتى لا أَتَعَرَّضَ لِلَّوم، أشعُرُ بالحاجةِ إلى التأكيدِ مِراراً: لو أنّ علمَ الاجتماعِ أو أيَّ منهجٍ علميٍّ آخَر مشابهٍ وذي أهدافٍ مُثلى كان قد نجح، لَما آلَت البشريةُ إلى حالتِها الراهنةِ خلال القرونِ الأربعةِ الأخيرةِ التي شَهِدَت هذه الدرجةَ من الحروبِ المُهَوِّلة، الإبادات العِرقية والإبادات المجتمعية، الهُوَّات الشاسعة بين الثراء والفقر المدقع، البطالة والهجرة، التفسخ والانحراف الثقافي واللاأخلاقية، قوى الاحتكار المسعورة والأفراد المُسقَطين لدرجةِ العَدم، والدمار البيئي الذي يُذَكِّرُ بيومِ المحشر. خمسةُ آلافِ عامٍ ونظامُ المدنيةِ العالمي يَكادُ يَستَنفِد كلَّ الوسائل الثقافية المادية والمعنوية حصيلةَ تَحامُلِه عليها تحت ذريعةِ الحل. فعبرَ أداةِ الحرب، لَم يَبقَ مكانٌ يمكن غزوه أو الاستيلاء أو السطو عليه مجدداً. وإنْ قِيلَ أنه موجود، فضَرَرُه أكثر من مَكسَبِه بأضعافٍ مضاعَفة.
وما تَبَقَّى من أداةِ المدينة ليس سوى مدنُ اللامدنِ المتضخمةُ كالسرطان، ومجتمعٌ قرويٌّ – زراعيٌّ يَسعَون لتفكيكه والحُكم عليه بالفناء في نهايةِ المآل. وما تَبَقَّى من الأداة التي يتشبثون بها على أنها اقتصاد، هو في آخِرِ المطافِ احتكاراتٌ عالميةٌ لا يمكن كبحَ جِماحِها، حيث باتت مُتَوَرِّمةً بالأساليب غير الأخلاقية على الإطلاق من قَبِيلِ كسبِ المال بالمال؛ وبقيَ بالمقابل العاطلون عن العمل والبؤساء المقهورون، الذين يُناهِزُ تعدادُهم الملايين، ويتضاعفون مع مرورِ كل عام. أما ما تَبَقَّى من الأداة التي يتشبث بها على أنها الدولة، فهو احتكاراتُ السلطة والدولة القومية، والتي تتورَّم بِنَخرِها المتواصل لمجتمعها الداخلي، ولَم يَعُدْ لها أيّةُ وظيفةٍ تُذكَر؛ وبالمقابل بَقِيَ حشدُ المواطنين الرعاع، الذين باتوا حمقى كلياً، ولا علاقةَ لهم بتاتاً بالمجتمع الأخلاقي والسياسي. وما تَبَقَّى من أدواتٍ أيديولوجيةٍ تُعقَدُ عليها الآمال، هو الدينَوِيّةُ المفتَقِدَةُ لوظيفتها الأخلاقية، والجنسوية التي تَنشُرُ السلطةَ في جميعِ مساماتِ المجتمع، والقوموية الغارقة في الشوفينية بما يُضاهي القَبَليةَ ألفَ مرة، والعلموية التي لَم يَبقَ لها هدفٌ سوى إظهار سُبُلِ الربح الأعظمي لاحتكاراتِ رأسِ المال والسلطة. بينما ما تَبَقّى من الفن مجرد صناعة الثقافة التي تُشَيِّئُ سُمُوَّ المشاعرِ وعواطفَ الجمال. يَبدو فيما يَبدو أنّ إحصائيةَ هذه المدنيةِ هي الوضعُ المسمى بنهاية التاريخ. مهما صُيِّرَ المجتمعُ بلا ردودِ فعلٍ بعد تعمِيَتِه والتشويشِ عليه في عالَمٍ افتراضيٍّ من خلال احتكاراتِ الإعلام، ومهما أُخضِعَ للرقابةِ المُشَدَّدة والرَصد المُحكَم حتى أدقِّ مساماته عبر أجهزة السلطة؛ فإنّ نظامَ المدنيةِ والحداثةِ العالميَّ المُعَمَّرَ خمسةَ آلافِ عامٍ عموماً وأربعةَ قرونٍ على وجهِ الخصوص، وصلَ قاعَ الأزمةِ الذهنية والبنيوية. والرأسماليةُ الماليةُ الصائرةُ قوةً كونيةً مهيمنة أسطعُ برهانٍ على ذلك. ما العالَم الذي تُدارُ عجَلاتُه بِيَدِ الرأسماليةِ المالية، فهو عالَمُ المآزقِ المُتَضَوِّرُ في الأزمات.
لا أرمي إلى تطويرِ نظرياتِ المأزق والأزمة. وقد كنتُ عَرَّفتُ الرأسمالية بأنها ليست مجرد نظامٍ يتسم بالأزمات الدورية وحسب، بل هي طَورُ الأزمةِ البنيوية الممنهجة لنظامِ المدنية المتأزم دورياً وعلى المدى الطويل معاً. وإنْ كان لِطَورِ الأزمة مستويات داخلية أشدّ حِدّةً يشتمل عليها، فالمرحلةُ المُعاشةُ حالياً هي تلك الفترة. لدى تبياني لذلك، فمن الضروري القول إني لستُ من أولئك الاشتراكيين الذين كانوا في وقتٍ ما، وربما لا يزالون، يَعقِدون آمالَهم على الثورةِ النابعة من الأزمات. فالأزماتُ لا تُنتِجُ الثوراتِ وحسب، بل والثوراتِ المضادةَ أيضاً. علماً أني أُقَيِّمُ هكذا نمط من نظريات الأزمة – الثورة – الثورة المضادة بأنها جهودٌ بَلاغيةٌ ودعائية أكثر من أنْ تَكُون واقعية. بالتالي، فأنا لا أتشبثُ بالمقولة التي مفادها إنّ الأجواءَ تَغدو منفتحةً بسرعة أمام العصرانية الديمقراطية. بل إني أَقبَلُ مساراتِ المأزقِ والأزمة على أنهما مجرد ظاهرة. بينما لا أراها عوامل مؤثرة بمستوى القدرةِ على توليدِ الأحداث التاريخية. كان النهجُ التقدمي الكوني المطلق في وقتٍ ما حريصاً على استنباطِ أشكالِ المجتمعِ المتوجهة قُدُماً من السيئ نحو الأفضل، حسب نظريات الأزمة. لكنّ الواقعَ الملموسَ بذاته لم يؤيد مصداقيةَ هذه النظريةِ كثيراً.
هذا ما معناه ضرورة البحثِ في ميدانٍ آخر عن العوامل ذات القيمة المُحَدِّدة بحالتها التاريخية والراهنة على السواء. وخَيارُ العصرانية الديمقراطية كان بالأغلب حصيلةَ مساعي البحث تلك. ولدى عرضي إياه، لا أَبرَحُ مُرغَماً على التنويه مِراراً إلى قناعتي بأنّ معرفةَ الخاصيات التي ينفرد بها هذا الخَيارُ ستَجعَلُ الجهودَ المعنيةَ بالممارسةِ العمليةِ مُثمِرَة. كما أني أُكِنُّ التقدير والالتزامَ الأقصى بالإرثِ الديمقراطي الإيجابي للتاريخ. بل وأَعتَبِرُ ذلك نقداً ذاتياً أيضاً بالنسبة لي. لا أقتصر على القول بأني استَنبَطتُ الدروسَ اللازمة، بل وأؤمن بأنّ عَمَلَ اللحظةِ استناداً إلى التاريخ يتميز بِقيمةٍ أسلوبيةٍ لا استغناء عنها. بينما لا أُكِنُّ نفسَ التقدير أو الالتزام تجاه كلِّ فكرةٍ أو ممارسةٍ عاجزة عن استيعابِ ضرورةِ أنْ يَكُونَ التاريخُ اللحظةَ الحالية، وأنْ تَكُونَ اللحظةُ هي التاريخ، أياً كانت قيمتها ونتائجها. ذلك أني لا أؤمن بهكذا أفكارٍ وممارسات. وإدراكاً مني بأنّ المستقبل يَمُرُّ من اللحظة، فإني لا أؤمن بوجودِ مستقبلٍ لِمَن هو عاجزٌ عن حلِّ أو تحليلِ لحظته وراهنه.
هذا التكرارُ المتواصل بشأنِ الأسلوب يهدف إلى التشديد بإصرار على أنه لا يتم التفكير بالحضارة الديمقراطية كخيالِ «عصرٍ ذهبي » مُعاشٍ ماضياً، ولا «يوتوبيا » معنية بالمستقبل. بل هي تعبيرٌ عن معنى نمطِ الحياة المتحققِ في الفكر والممارسة كحاجةٍ يوميةٍ بل ولحظيةٍ ماسّة. فلا هي لَومٌ للذكريات القديمة، ولا هي سِلوانٌ والتهاءٌ بخيالات المستقبل. لا هي إبداعاتٌ لحظية، ولا هي حالةُ وجودِ حقائق أبدية – أزلية. قد يَكُونُ من الأنسب نعت حالةِ الوجود كذكاءِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ المَرِن، وكوحدةٍ ضمن فوارق متميزةٍ بآفاقِ حريةٍ عليا على أنها عصرانية ديمقراطية. لكن، وبِحُكمِ أنّ العصرانيةَ تعني العصر، فعلينا ألا ننسى البتةَ أنها تكتسِبُ العصرانيةُ الديمقراطيةُ تُعَبِّرُ عن الذهنيةِ والبنيةِ التي تَلجَأُ لشتى الأساليب لِجَعلِ الحياةِ ممكنةً بمنوالٍ أكثر حريةً ومساواةً وديمقراطيةً في ظل كافةِ الظروف وجودَها كقطبٍ دياليكتيكيٍّ مقابلٍ ومضادٍّ لعصورِ المدنية الكلاسيكية، وأنه علينا توحيدها مع هذا التعريف بكل تأكيد.
فكما يتم التفكير بالحداثوية كتسميةٍ خاصةٍ بالقرونِ الأربعةِ الأخيرةِ من سياقِ المدنية الكلاسيكية، باعتبارها عصرَ هيمنةِ الرأسمالية؛ يجب التفكير بالعصرانية الديمقراطية أيضاً كتسميةٍ خاصةٍ بالقرونِ الأربعةِ الأخيرةِ للحضارة الديمقراطية.
الخاصيةُ الأخرى الهامة هي كون العصرانية الديمقراطية تحيا كقطبٍ مضادٍّ في كلِّ ساحةٍ وزمانٍ تتواجدُ فيه شِباك (أجهزة) الحداثةِ الرأسمالية. أي أنّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ في حالةِ وجودٍ دائمٍ في كلِّ مكانٍ وزمانٍ ضمن أحشاءِ الحداثةِ الرأسمالية، سواءً كانت ناجحةً أم فاشلة، مشحونةً بالحرية أو بالعبودية، ضمن تَماثُلٍ أم تبايُن، بعيدةً عن المساواة أم قريبةً منها، مكتسبةً المعانيَ الأيكولوجيةَ والفامينيةَ أم مفتقدةً إياها؛ وباقتضاب، سواءً كانت قريبةً من ميزةِ المجتمعِ الأخلاقي والسياسي أم بعيدة.
أما فيما يتعلقُ بمناهجِ المعارِضين اليساريين أو اليمينيين في الحنين إلى خلقِ المجتمعات عبر مخططاتٍ مركزيةٍ بممارسةِ «الهندسة المجتمعية » بغرضِ الاستيلاءِ على السلطةِ أولاً (وبالتالي الدولة) بوساطةِ الثورةِ أو الثورةِ المضادة، ومن ثم إدراجِ المخططات والبرامج التي يفكرون فيها حيزَ التنفيذ؛ فإني لا أَقتَصِرُ في تقييمها على أنها هذيانٌ وكلامٌ دعائيٌّ (بَلاغيّ) وحسب، بل إني مرغَمٌ على التبيانِ بأهمية بأني أَنظُرُ إلى هذا النمطَ على أنه ضمنياً ألعوبةٌ من ألاعيب الليبرالية، أو أفكارٌ وتطبيقاتٌ لن تَلقى الليبراليةُ مشقةً في احتوائها، حتى ولو مرَّ سبعون عاماً عليها.
للطبيعاتِ الاجتماعيةِ أيضاً شيفراتُها الوراثية الشبيهة بما لدى الطبيعات البيولوجية. إني مدركٌ للنزعةِ الأحيائية، وأعلَمُ أنّ نَقلَها إلى الطبيعاتِ الاجتماعية يعني الداروينية، وأنها تُؤَمِّنُ الخاماتِ الفكريةَ اللازمةَ للهندسة الاجتماعية بأكثر أشكالِ الماديةِ فظاظة. الأمر الذي تحدثتُ عنه يشير إلى المزايا الخاصة التي تتسم بها المجتمعاتُ التاريخية في إمكانيةِ تعديل ذاكرتها وخصائصها البنيوية الأساسية، حتى ولو كانت منفتحةً إلى آخرِ مدى أمام خَيارِ الحرية كطبيعةٍ متميزةٍ بأرقى درجاتِ الذكاء. لا يمكننا إخضاعَ المجتمعات للتغييرِ مثلما نُرَبِّي مختلفَ النباتات أو الحيوانات المُعَدَّلةِ بعد تغييرِ شيفرة مورثاتها الهرمونيةِ. فذاكرةُ الطبيعةِ الاجتماعية أصلاً لَم تُحَدِّدْ ذلك كمجتمعٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ عبثاً. لذا، من المهم للغاية التبيان بأنّ السبيلَ الاجتماعيَّ للتغيير والتعديل لا يمكن رؤيته مشروعاً إلا في حالةِ رفعِه من المستوى الأخلاقي والسياسي الاجتماعي، وأنه في حال العكس سوف يُسقِطُ من مستوى المجتمع الأخلاقي والسياسي بشتى الأساليب التوتاليتارية الشمولية والسلطوية، وبالتالي، لا يمكنه قَبولَ شرعيته، أياً كانت نتائجه.
العصرانيةُ الديمقراطيةُ تتحلى بخاصيةِ النظام الذي يُبقي الباب مفتوحاً أمام سبيلِ التغيير الشرعي. وارتفاعُ قيمته الأخلاقية والسياسية على صِلَةٍ وطيدةٍ بجوهره المنهجي هذا. سبيلُ التغييرِ الشرعيُّ بسيطٌ إلى جانبِ كونه هاماً جداً. وبمقدورِ كل عضوٍ في أيِّ مجتمعٍ تقديمَ مساهماتهِ في هذا التغيير، أينما ومتى كان. فالعضوُ الذي يَحيا بقايا المجتمعِ النيوليتي أو حتى المجتمعَ الكلاني، والعضوُ الذي يحيا في موسكو أو نيويورك، يتميزان بالطاقةِ الكامنةِ لتقديمِ المساهمة في التغيير في كلِّ لحظة. ومثلما لا يُشتَرَطُ السردُ المقدسُ لذلك، فلا يُشتَرَطُ أيضاً إبداءُ آياتِ البطولة. الشرطُ الوحيدُ هو التحلي بمهارةِ التفكير والسلوك الأخلاقي والسياسي كحالةِ وجودٍ أساسيةٍ للطبيعة الاجتماعية، وتفعيلُ هذه المهارةِ (الفضيلةِ الحَسَنة) التي نَثِقُ بوجودِها في كلِّ فردٍ ولو بحدودِها الدنيا. لا ريب أني لا أود من خلال ذلك الإشارةَ إلى عدمِ أهميةِ أو جدوى السرود العظيمة والمقدسة البارزة للميدان على مرِّ سياقِ المجتمعِ التاريخي، والتي باتت مُلكاً لذاكرةِ البشرية في سبيل تنويرِ سبيلِ التغيير الشرعي. بل، وعلى النقيض، يَقَعُ دورٌ كبيرٌ على عاتق هذه السرود، نظراً لأنّ الاحتكاراتِ الأيديولوجيةَ والماديةَ سَدَّت المجالَ أمام سبيلِ التغيير الشرعي. والممارساتُ البطوليةُ أيضاً تتميز بِقِيمةٍ مقدسة شبيهة لا غنى عنها على الدربِ المؤدية نحو الحرية. المهم هنا هو إدراكُ استحالةِ تأمينِ التغيير في العصرانية الديمقراطية، دونَ وجودِ المساعي المتكاملة للمجتمع التاريخي. لا يتم هنا إنكار دور الشخصيات والتنظيمات الهامة. لكنّ هذا الدورَ لن يعني الكثير، ما لم يُصَيَّر مُلكاً لأنسجةِ المجتمعِ الأخلاقيةِ والسياسية، وما لم يُمَرَّر من السبيل الشرعي.
النقاطُ عينُها ساريةٌ على الثورات أيضاً. إذ ينبغي عدم نعت التغيير المُعَبِّر عن التطور الاجتماعي بالذاتيةِ التلقائية للطبيعةِ الاجتماعية، ما لَم يَمُر من السبيل الشرعي وما لَم يُصبِح مُلكاً للنسيج الأخلاقي والسياسي. ذلك أنّ المجتمعاتِ تُعاش، ولا تُخلَق. هذا ولا شك أنه ثمة فرقٌ بين حياةٍ وأخرى. فكما أن هناك حياةٌ أكثر حريةً ومساواةً وديمقراطية، فهناك أيضاً حَيَواتٌ تَئِنُّ تحت وطأة العبودية واللامساواة والديكتاتورية التي لا تُطاق. وربما هي الأكثر. والعصرانيةُ الديمقراطيةُ تُعَبِّرُ عن الذهنيةِ والبنيةِ التي تَلجَأُ لشتى الأساليب لِجَعلِ الحياةِ ممكنةً بمنوالٍ أكثر حريةً ومساواةً وديمقراطيةً في ظل كافةِ تلك الظروف. كما أنّ إنجازَ ثورةٍ متبَقِّيةٍ كخَيارٍ وحيدٍ للتغيير الشرعي ضمن إطارِ العصرانية الديمقراطية أمرٌ قَيِّمٌ بِقدرِ إزاحةِ حجرٍ سقطَ على الطريق. مقابل ذلك، لا يتم التفكيرُ في الخَلاصِ الإلهيِّ والتصوُّفِ القَدَرِيِّ العبوديِّ ضمن الإطارِ نفسه، بل ولا يُنظَرُ إليهما بعينٍ أخلاقية. وعلى هُدى العِبَرِ التي سوف نستَنبطُها من كفاحاتِ الحرية والمساواة والديمقراطية القائمة في غضونِ القرونِ الأربعةِ الأخيرة، فمن المستطاعِ تعزيز العصرانية الديمقراطية، بل وحتى تحديثها بإعادة إنشائها مجدداً من مكانٍ إلى آخر، في مرحلةِ الأزمةِ الممنهجة والبنيوية لهيمنةِ الرأسمالية المالية العالمية التي نَمر بها. بناءً عليه، فالتنوُّرُ والتعمقُ في الأبعاد الرئيسية للعصرانية الديمقراطية، سوف يُنجِحُ مساعينا في هذا المنحى بنحوٍ أكبر.
– بُعد المجتمع الكونفدرالي الديمقراطي:
بالإمكانِ تحديد البُعدِ الثالثِ للطبيعةِ الاجتماعية إدارياً على شكلِ النظامِ الكونفدرالي الديمقراطي. حيث يُمكِن للبُعدِ الثلاثي أنْ يَكُونَ تعليمياً ناجعاً، رغمَ كلِّ مخاطره. المهمُّ هو تَداخُلُ الأبعاد. قد يَكُونُ ممكِناً إقامةُ شيءٍ ما مكانَ أحدِ الأبعاد مزاجياً، لكنّ ما يَظهَرُ للوسط آنذاك لن يَكُونَ نظامَ العصرانية الديمقراطية، بل شيءٌ آخَر. ثلاثيُّ الحداثةِ الرأسماليةِ أيضاً متداخِل، وأبعادُها تشترط بعضها بعضاً .
يؤلِّفُ النظامُ الكونفدراليُّ الديمقراطي في العصرانيةِ الديمقراطية نظيرَ الدولةِ القوميةِ التي تُعَدُّ الصياغةَ الرسميةَ للحداثةِ الرسمية. بالإمكان تسميةَ ذلك بشكلِ الإدارةِ السياسية التي ليست دولة. وهذه بالذات هي الميزة التي تَمنَحُ النظامَ خصوصيتَه وخاصيتَه. ينبغي قطعاً عدم الخلط بين الإدارات الديمقراطية وحُكمِ الدولة الإداري. فالدولُ تَحكُم، بينما الديمقراطياتُ تَقُود. الدولُ تعتمدُ على السلطة، بينما الديمقراطياتُ تعتمدُ على الرضا الجماعي. التعيينُ أساسٌ في الدول، في حين أنّ الانتخابَ أساسٌ في الديمقراطيات. كما أنّ الضرورةَ الاضطراريةَ أساسٌ في الدول، والطوعيةُ أساسٌ في الديمقراطيات. هذا وبالمقدور الإكثار من الفوارق المشابهة.
الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ ليست أيَّ شكلٍ إداريٍّ خاصٍّ بيومنا الراهن مثلما يُعتَقَد. بل هي نظامٌ يحتلُّ مكانَه في سياقِ التاريخِ بكلِّ ثِقَلِه. والتاريخُ بهذا المعنى كونفدراليٌّ، لا دولتيٌّ مركزيّ. لكنّ شكلَ الدولةِ معروفٌ كونَه بات رسمياً للغاية. في حين أنّ الحياةَ الاجتماعية أدنى إلى الكونفدرالية. وبينما تَهرَعُ الدولةُ دوماً نحوَ المركزيةِ المُفرِطة، فهي تَتَّخِذُ مصالحَ احتكاراتِ السلطةِ التي تَرتَكِزُ إليها أساساً. إذ لا يمكنها صَونَ هذه المصالح في حالِ العكس. أي، لا يمكن ضَمانَها إلا بمركزيةٍ مُشَدَّدةٍ للغاية. بينما العكسُ يَسري في الكونفدرالية. إذ عليها تَجَنُّب النزعةِ المركزيةِ قدرَ المستطاع، بِحُكمِ اتخاذِها المجتمعَ أساساً، وليس الاحتكار. ونظراً لأنّ المجتمعاتِ ليست نمطيةً (كتلةً واحدةً متجانسة)، بل تتألف من عددٍ جَمٍّ من المجموعات والمؤسساتِ والتبايُنات؛ فهي تَشعُرُ بضرورةِ تأمينِ وصَونِ تَكامُلِها جميعاً ضمن تآلُفٍ مُتَّسِقٍ مشتَرَك. بالتالي، فإدارةٌ مُفرِطةٌ في المركزية بالنسبة لهذه التعددية، قد تفسح الطريق مِراراً أمام الانفجارات. والتاريخُ مليءٌ بعددٍ لا محدودٍ من هذه الأمثلة. أما الكونفدرالية الديمقراطية، فتُعاشُ أكثر نظراً لِتَناسُبِها مع مقدرةِ كلِّ جماعةٍ ومؤسسة وتبايُنٍ مختلِفٍ على التعبير عن ذاتها. أما كونها نظاماً غيرَ معروفٍ كثيراً، فيَعودُ لبنيةِ المدنيةِ الرسمية وأيديولوجيتِها المهيمنة. أي أنّ المجتمعاتِ كونفدراليةٌ أساساً في التاريخ، وإنْ لَم يُعتَرَف بها رسمياً. وإداراتُ جميعِ العشائر والقبائل والأقوام تَسمَحُ دائماً بالكونفدارليةِ المتميزةِ بالعلاقاتِ الرخوة. حيث تُكدَمُ وتتضَرَّرُ استقلالياتُها الذاتيةُ في حال العكس. وهذا بدوره ما يُبَعثِرُ صفوفَها ويَنثُرُ كيانَها. بل حتى الإمبراطورياتُ تستند في بُناها الداخلية إلى عددٍ لا محدودٍ من الإداراتِ المختلفة. إذ قد تَتَّحِدُ شتى أنواع الإدارات القَبَلية والعشائرية والقومية والسلطات الدينية والمَلَكِيّات وحتى الجمهوريات والديمقراطيات تحت مِظَلّةِ إمبراطوريةٍ واحدة. بهذا المعنى، فمن المهم بمكان الإدراك أنه حتى الإمبراطورياتُ التي يُعتَقَدُ أنها الأكثر مركزيةً، إنما هي ضربٌ من ضروبِ الكونفدرالية. أما النزعةُ المركزية، فهي نموذجُ حُكمٍ يحتاجُه الاحتكار، لا المجتمع.
مسارُ الحداثةِ الرأسمالية هو الفترةُ التي بَلَغَتُ الدولةُ فيها مَركزيتَها القصوى. فبالاستيلاءِ على مراكزِ القوةِ السياسيةِ والعسكرية في المجتمع من قِبَلِ أعتى أشكالِ الاحتكارِ المسماةِ بالسلطة، وبِتَركِ المجتمعِ خائرَ القوى وبلا إدارة سياسياً وعسكرياً بنسبةٍ كُبرى، باتت المونارشياتُ الحديثةُ والدولُ القوميةُ المُطَوَّرَةُ على التوالي أشكالَ الحُكمِ التي تَرَكَت المجتمعَ مُجَرَّداً من القوةِ والسلاحِ لأقصى درجة على الصعيدَين العسكريِّ والسياسيّ. وما الظاهرةُ المسماةُ بنظامِ القانونِ والرفاهِ الاجتماعي سوى تأسيسٌ لحاكميةِ الطبقةِ البورجوازية. بينما تَكاثُفُ الاستغلال، والأشكالُ الجديدةُ التي اتَّخَذَها لنفسِه، اقتضت الدولةَ القوميةَ اضطراراً. أما الدولةُ القوميةُ، التي يمكننا نعتَها بالتنظيمِ الأقصى لدولةِ السلطةِ المركزية، فهي شكلُ الحُكمِ الأساسيُّ الذي تَعمَل به الحداثة. في حين أنّ الممارساتِ المسماةَ ب »ديمقراطية البورجوازية » كَرِداءٍ يُدَثِّرُها، فهي أساساً بغرضِ تأمينِ شرعيةِ احتكارِ السلطة لدى المجتمع. حيث تَكتَسِبُ الدولةُ القوميةُ وجودَها تأسيساً على إنكارِ الديمقراطيةِ بل والجمهوريةِ أيضاً. فالديمقراطيةُ والجمهوريةُ شَكْلا حُكمٍ مختلفان عن الدولة القومية بِحُكمِ ماهيتهما.
العصرانيةُ الديمقراطية، سواءً كأساسٍ تاريخيّ، أم على صعيدِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ المعقَّدة راهناً، لا تُحَدِّدُ خَيارَها للكونفدراليةِ الديمقراطيةِ كنموذجٍ سياسيٍّ أساسيٍّ مزاجياً أو عن عبث. بل إنها تُعَبِّرُ بذلك عن السقفِ السياسيِّ للمجتمع الأخلاقي والسياسي. سيُصبِح فهمُ الكونفدراليةِ الديمقراطية عسيراً، في حالِ عدمِ الاستيعابِ الكامل لِكَونِ الطبيعةِ الاجتماعيةِ ليست نمطيةً متجانسةً أو أُحاديةً مُتَكَشِّفَةً عن تراصٍّ وتناغُمٍ كليّ. وما تاريخُ المدنيةِ الرسميةِ في غضونِ القرون الأربعةِ الأخيرة سوى جنوحٌ لإِتْباعِ المجتمعِ المتعددِ الأثنياتِ والثقافاتِ، والمتنوعِ بكياناته السياسية، والمتميزِ بدفاعه الذاتي، وإخضاعِه لضربٍ من ضروبِ الإبادة (الإبادات الثقافية عموماً، والفيزيائية من حينٍ لآخَر) باسم الأمةِ الواحدةِ المتجانسة. بينما الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ هي تاريخُ الإصرارِ على الدفاع الذاتي والتعدديةِ الأثنيةِ والثقافيةِ والكيانات السياسية المختلفة تجاه ذاك التاريخ. وما وراء الحداثة استمرارٌ لتاريخِ صراعِ الحداثةِ ذاك، ولكنْ بأشكالٍ جديدة.
تَصَدُّعُ الدولةِ القوميةِ، التي تمَّ تقديسُها في عصرِ التمويل العالمي ككيانٍ هو الأكثر ألوهيةً في القرنَين الأخيرَين، وعودةُ انتعاشِ الحقائق الاجتماعية – التي قَمَعَتها وصَهَرَتها في بُنيتها عنوةً – لِتَغدو حديثَ الساعةِ مجدَّداً وكأنها تثأَرُ منها؛ إنما هي سياقاتٌ مترابطة. فمفهومُ عصرِ التمويل في الربح يقتضي تغييرَ الدولةِ القوميةِ بالضرورة. وهذا التغييرُ يؤدي دوراً هاماً في كَونِ الأزمةِ بنيوية. أما قيامُ النيوليبرالية بإعادةِ إنشاءِ الدولة القومية، فلَم يُكتَبْ له النجاحُ بأيِّ شكلٍ كان. وتجاربُ الشرق الأوسط تعليميةٌ مفيدة على هذا الصعيد. يُواجِهُ النظامُ الديمقراطيُّ حلَّ قضاياه الشكليةِ بنجاح، لدى تعزيزِ وجودِه في خضمِّ هذه الظروف، التي هو مُرغَمٌ ضمنها على جعلِ نفسِه مرئياً أكثر وتدريجياً كعصرانيةٍ مضادة. لهذا السببِ بالذات سَعَينا لتبيان أنّ الكونفدارليةَ ليست غريبةً عن التاريخ، وأنها الجوابُ الأفضلُ بالنسبةِ لطبيعةِ مجتمعنا الراهنِ المزدادةِ تعقيداً. وذَكَرنا مِراراً أنّ السبيلَ الأفضل للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيِّ في التعبير عن ذاته هي السياسةُ الديمقراطية. فالسياسةُ الديمقراطيةُ هي نمطُ إنشاءِ الكونفدراليةِ الديمقراطية. وتنتَهِلُ ديمقراطيتَها من هذا النمط. وعندما تسعى الحداثةُ المضادة، التي تزدادُ مركزيتُها طردياً، إلى تأمين استمرارِيتها من خلالِ أجهزةِ السلطة والدولة المتغلغلةِ حتى أدقِّ مساماتِ المجتمع الداخلية؛ فهي تَكتَسِبُ الدولةُ القوميةُ وجودَها تأسيساً على إنكارِ الديمقراطيةِ بل والجمهوريةِ أيضاً. فالديمقراطيةُ والجمهوريةُ شَكْلا حكم مختلفان عن الدولة القومية بحكم ماهيتها بذلك تَكُون قد قَضَت أصلاً على الساحةِ السياسية. مقابل ذلك، فلدى قيام السياسة الديمقراطية بمنحِ كلِّ شرائحِ وهوياتِ المجتمعِ فرصةَ التعبير عن ذاتها والتحولِ إلى قوةٍ سياسية، إنما تَكُون بذلك قد شَكَّلَت المجتمعَ السياسيَّ أيضاً، لِتَدخُلَ السياسةُ أجندةَ الحياةِ الاجتماعيةِ مجدَّداً. من المحال حلُّ أزمةِ الدولة، دون اللجوءِ إلى السياسة. ذلك أنّ الأزمةَ نفسَها تنبع من دحضِ وتفنيدِ المجتمعِ السياسي. من هنا، فالسياسةُ الديمقراطيةُ هي السبيلُ الوحيدُ لِتَخَطّي أزمات الدولة المتجذرة في يومنا الحاضر. وإلا، فالبحثُ عن دولةٍ أكثرَ تَشَدُّداً وصرامةً في مركزيتها، فلن يَخلُصَ من التعرض لانكساراتٍ قاسية.
تُشيرُ هذه المؤثراتُ مرةً أخرى إلى أنّ الكونفدراليةَ الديمقراطيةَ باتت خَياراً مطروحاً بقوة. الدافعُ الأوليُّ على الإطلاق لانهيارِ الاشتراكيةِ المشيدة هو القضاءُ على الكونفدراليةِ ضمنها بسرعة باسمِ الدولةِ المركزية، بعد أنْ كانت رائجةً في مطلعِ تجربةِ روسيا السوفييتية. كما أنّ عَجزَ حركات التحرر الوطني عن النجاح، بل وتَهَمُّشُها خلالِ مدةٍ وجيزة، هو على صلةٍ وطيدةٍ بعدمِ تطويرِها للسياسةِ والكونفدرالية الديمقراطيتَين. فضلاً عن أنّ ما يَكمُن في أساسِ فشلِ تجاربِ الحركاتِ الثوريةِ للقرنَين الأخيرَين، هو أساساً اتخاذُها موقفاً يَرى الدولةَ القوميةَ أكثر ثوريةً، بينما يَعتَبِرُ الكونفدراليةَ الديمقراطيةَ شكلاً سياسياً رجعياً.
الشخصياتُ والحركاتُ، التي اعتَقَدَت بتحقيقِ التحولاتِ الاجتماعيةِ العظمى بطرقٍ مختَصَرة بالتشبثِ بالدولةِ القوميةِ التي هي سلاحُ الحداثةِ الرأسماليةِ الجوهريّ، قد أدرَكَت بشكلٍ جدِّ متأخِّرٍ أنها أصابَت نفسَها بهذا السلاح.
مثلما تتسمُ الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ بالقدرةِ على تجاوُزِ السلبياتِ الناجمة عن منهجيةِ ونظامِ الدولةِ القومية، فهي أيضاً أنسبُ وسيلةٍ لتسييسِ المجتمع. إنها بسيطةٌ وقابلةٌ للتطبيق. حيث بمقدورِ كلِّ مجموعةٍ وأثنيةٍ وثقافةٍ وجماعةٍ دينيةٍ وحركةٍ فكريةٍ ووحدةٍ اقتصاديةٍ بناءَ نفسِها كوحدةٍ سياسيةٍ شبهِ مستقلةٍ للتعبيرِ عن ذاتِها. ينبغي تقييمَ الفيدرالية أو شبهِ الاستقلالية أو المصطَلحِ المسمى بالذاتية ضمن هذا الإطار والنطاق. فلكلِّ كيانٍ ذاتيٍّ فرصتُه في بناءِ كونفدراليته، بدءاً من المحليةِ وصولاً إلى العالميةِ منها. العنصرُ الأكثر أساسيةً لكلِّ محليةٍ هو الحقُّ في النقاش والإقرارِ بِحُرّيّة. كما أنّ كلَّ وحدةٍ فيدراليةٍ أو ذاتيّة، لها فرصتُها في تطبيقِ الديمقراطيةِ المباشَرةِ المُصطَلَح عليها باسمِ الديمقراطية التَّشارُكِيّةِ أيضاً. ولهذا السببِ هي فريدة، حيث تَنتَهِلُ كلَّ قوتِها من قابليتِها في تطبيقِ الديمقراطيةِ المباشرة. وهذا بالذات حجتُها في تَحَلِّيها بدورٍ أساسيّ. بقدرِ ما تَكُونُ الدولةُ القوميةُ إنكاراً للديمقراطيةِ المباشَرة، فعلى النقيض، الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ هي شكلُ تكوينِها وتوظيفِها.
العناصرُ الفيدراليةُ كخلايا نواةٍ في الديمقراطيةِ التّشارُكِيّةِ المباشرة، هي عناصرٌ مُثلى لا نظيرَ لها من حيث مُرونَتِها في التحول إلى اتحاداتٍ كونفدراليةٍ أيضاً حسبما تقتضيه الظروفُ والحاجات. وكلُّ أنواعِ الاتحاداتِ السياسيةِ ديمقراطيةٌ بشرطِ عَمَلِها أساساً بالمُكَوِّناتِ المستندةِ إلى الديمقراطيةِ التّشارُكِيّةِ المباشرة. أما الوظيفيةُ السياسيةُ المُطَوَّرَةُ بدءاً من الوحدة الأكثر محلية – والتي تَحيا وتُطَبَّقُ الديمقراطيةَ المباشرة – وصولاً إلى الكيان الأكثر عالمية، فيمكن تسميتَها بالسياسةِ الديمقراطية. والنظامُ الديمقراطيُّ الحقيقيُّ هو صيغةُ عَيشِ مجموعِ هذهِ المسارات.
إذ ما رُصِدَت الطبيعةُ الاجتماعية بِدِقّةٍ وإمعان، فستُدرَكُ ماهيةُ «القفص الحديدي » للدولة القومية، والماهيةُ التحريريةُ الأنسب للكونفدراليةِ الديمقراطية بكلِّ سهولة. فبقدرِ ما تَقُومُ الدولةُ القوميةُ بقمعِ المجتمعِ وجعلِه نمطياً أُحادياً وإبعادِه عن الديمقراطية، فنموذجُ الكونفدراليةِ الديمقراطية تحريريٌّ وتعدديٌّ ومتوجِّهٌ نحو الدمقرطة بنفسِ القدر.
نقطةٌ أخرى ينبغي الانتباهَ إليها، ألا وهي تَصَوُّرُ الوحداتِ الفيدراليةِ والذاتيةِ ضمن إطارٍ غنيٍّ جداً. إذ من المهم للغاية إدراك مدى الحاجةِ لوحداتٍ كونفدرالية حتى في كلِّ قريةٍ أو حيٍّ في المدينة. أي أنّ كلَّ قريةٍ أو حيٍّ يُمكِنُ أن يَكُونَ وحدةً كونفدراليةً بكلِّ يُسر. وعلى سبيل المثال، قد تتواجدُ في قريةٍ ما وحدتُها، أي فيدراليتُها الأيكولوجية. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، تتواجد وحدات المرأة الحرة، الدفاع الذاتي، الشبيبة، التعليم، الفلكلور، الصحة، التعاون، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية. فجميعها تعد وحدات لا يمكن الحديث عن قدرةِ المجتمع على حمايةِ هويته أو تأمينِ تَسَيُّسِه أو مزاولة السياسة ، إلا عندما يكون قادراً على الدفاع عن ذاته الديمقراطيةِ المباشرة، وعليها الاتحادَ على نطاقِ القرية. هذا وبالمقدور بكلِّ سهولة تسمية الاتحاد الجديد لهذه الوحدات بالوحدةِ الكونفدرالية أو الاتحاد الكونفدرالي (اتحاد الوحدات الفيدرالية). وإذ ما عَمَّمنا النظامَ نفسَه على المستويات
المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية، فسيَكُون يسيراً فهمُ مدى كون الكونفدرالية الديمقراطية نظاماً شاملاً. كما أنه، ومن خلالِ منهجيةِ الكونفدرالية، بالمقدورِ الاستيعابَ على خيرِ وجهٍ مدى تكامُلِ الأبعادِ الثلاثيةِ الرئيسيةِ للعصرانية الديمقراطية، وإتمامِها بعضَها بعضاً. هكذا يَكُون واقعُ وتَكامُلُ المجتمعِ التاريخي للطبيعة الاجتماعية قد تَحَقَّقَ وتَوَطَّدَ بأفضل أحواله، نظراً لأنَّ كلَّ بُعدٍ ضمن هذا النظام قادرٌ على النقاش والتقييم والإقرار وإعادة الإنشاء وسلوك ممارساته فيما يتعلق بشؤونه الذاتية.
يمكن تطبيق الدفاعِ الذاتيِّ الاجتماعيِّ أيضاً على أكملِ وجه في النظامِ الكونفدرالي الديمقراطي. حيث يَندَرِجُ الدفاعُ الذاتيُّ ضمن إطارِ النظام الكونفدرالي كمؤسسةٍ من مؤسساتِ السياسةِ الديمقراطية. والدفاعُ الذاتيُّ من حيث التعريف تعبيرٌ مُكَثَّفٌ للسياسةِ الديمقراطية.
الدولةُ القوميةُ نظامٌ عسكريٌّ أساساً. وجميعُ الدول القومية محصلةٌ لمُختلَفِ الحروب الداخليةِ والخارجيةِ المُخاضة بشتى الأشكال وبمنوالٍ تَعَسُّفِيٍّ للغاية وعلى المدى الطويل. حيث لا يمكن التفكير بدولةٍ قوميةٍ واحدةٍ ليست ثمرةَ الحروب. إذ تَحُفُّ الدولةُ القوميةُ المجتمعَ برمته بدرعٍ عسكر تاريٍّ (مليتاري) من الداخل والخارج، ليس في مرحلةِ تأسيسها وحسب، بل وبنسبةٍ أعلى في مراحل تَمَأسُسِها وانهيارِها أيضاً. هكذا يَتَعَسكَرُ المجتمعُ بأكمله. أما مؤسساتُ السلطةِ والدولةِ المسماةُ بالإدارةِ المدنية، فهي أساساً ليست سوى ستاراً يُغَطّي هذا الدرعَ العسكري. بينما الأجهزةُ المسماةُ بالديمقراطياتِ البورجوازية تَذهَبُ أبعدَ من ذلك، لِتَطمسَ هذه البنية والذهنية العسكرتارية وتَصقلَها بطلاءِ الديمقراطية، مُتَحَمِّلَةً بذلك وظيفةَ الدعاية والترويج بأنّ الذي يَسري إنماهو نظامٌ اجتماعيٌّ ليبراليٌّ ديمقراطيّ. لذا، من غير الممكن الحديث عن أيةِ ظاهرةٍ من قبيلِ التسيُّسِ السليم أو مزاولةِ السياسةِ الديمقراطية، ما لَم يُحَلَّلْ هذا التناقضُ الصارخُ لِحُكمِ الحداثة. هذه هي الظاهرةُ المسماة بالأُمّةِ العسكرية. وهي ظاهرةٌ تَسري على جميعِ الدول القومية المُنشأَة على مدى أربعةِ قرون. وهذا هو الواقعُ المُتَخَفّي تحت كافةِ القضايا والأزمات والتَّفَسُّخات الاجتماعية. أما ممارساتُ السلطةِ الفاشية بشتى أنواعها (الفاشياتُ الانقلابية أو غير الانقلابية، العسكرية أو المدنية)، وفرضُها والترويجُ لها مِراراً على أنها الحل؛ فهي ثمرةٌ لطبيعةِ الدولةِ القومية، وهي الحالةُ الأكثر خصوصيةً لتعبيرِها الشكليّ.
لا يمكن للكونفدرالية الديمقراطية كبحَ جِماحِ نزعةِ الدولة القومية في ذاك التَّعَسكُر، إلا بوسيلةِ الدفاعِ الذاتي. فالمجتمعاتُ المحرومةُ من الدفاعِ الذاتيِّ لا بُدَّ أنْ تَخسَرَ هوياتها وخاصياتها السياسية ودَمَقرطاتها. لهذا السبب بالذات، فإنّ بُعدَ الدفاعِ الذاتيِّ ليس مجرد ظاهرةٍ بسيطةٍ من الدفاع العسكري بالنسبة للمجتمعات. بل هو متداخِلٌ مع ظاهرةِ حمايةِ هوياتها، وتأمينِ تَسَيُّسِها، وتحقيقِ دَمَقرَطَتِها. بمعنى آخر، لا يمكن الحديث عن قدرةِ المجتمع على حمايةِ هويته أو تأمينِ تَسَيُّسِه أو مُزاوَلَةِ السياسةَ الديمقراطيةَ، إلا عندما يَكُون قادراً على الدفاعِ عن ذاته. وعلى ضوءِ هذه الحقائق، فالكونفدراليةُ الديمقراطيةُ مُرغَمةٌ في الوقتِ نفسِه على تَعظيمِ ذاتِها كنظامٍ من الدفاعِ الذاتي. لا يمكن للعصرانيةِ الديمقراطيةِ الردَّ على هيمنةِ الاحتكارات في عهدِها العَولَميّ الذي تَسودُهُ ظروفُ عَسكَرَةِ المجتمعِ بأجمعه في هيئةِ الدولة القومية، إلا عبر نظامها الذاتي المتألِّف من الشبكاتِ والأواصرِ الكونفدرالية بالتأسيسِ على الدفاع الذاتي والسياسة الديمقراطية، وبنفسِ الشموليةِ وفي جميعِ الظروفِ الزمانية والمكانية. فبقدرِ ما تتواجدُ الروابطُ والشبكاتُ المهيمنة (التجارية والمالية والصناعية، السلطة، الدولة القومية، والاحتكار الأيديولوجي)، يتوجب على العصرانية الديمقراطية أيضاً تطويرَ شبكاتها وأواصرها الكونفدرالية والدفاعية الذاتية والسياسية الديمقراطية بالمِثل.
القضيةُ الأخيرةُ الواجب التطرق إليها فيما يَخُصُّ هذا البُعد معنيةٌ بكيفيةِ إمكانيةِ الاستمرار بالعلاقات والتناقضات فيما بينهما. ونخص بالذكر في هذا السياق المواقف السلطوية التي سادت في تيارات الاشتراكية المشيدة والتحررية الوطنية (المُطالِبة بسلطةِ البروليتاريا بل وحتى بديكتاتوريتها بَدَلَ السلطة البورجوازية، وبالسلطوية القوموية بَدَلَ الإداراتِ الاستعمارية المتواطئة)، حيث ارتَكَبَت أكثرَ الأخطاءِ التاريخيةِ مأساويةً، مانِحةً الرأسماليةَ الفرصةَ التي لا تستحقُّها للاستمرارِ في وجودِها بسببِ تلك المفاهيم. هذه التياراتُ وما شابهها مما يمكننا نعتَه بضربٍ من مفاهيمِ وتطبيقاتِ هدمِ السلطةِ والدولة، وإقامةِ الجديدِ منها مكانَها؛ إنما تُعتَبَرُ القوى الأكثر مسؤوليةً عن غرقِ المجتمع في التّحول العسكرتاري، وفقدانِه ماهيتَه السياسية، وخُسرانِه في نضالِه الديمقراطي. هذا النمط من التعاطي على مرِّ قرنَين من الزمن تقريباً، قد مَنَحَ الدولتيةَ القوميةَ للهيمنةِ الرأسماليةِ انتصاراً على طبقٍ من الذهب بِيَدَيه. في حين أنّ الفوضويين، وكذلك بعض الحركات الفامينية والأيكولوجية الماوراء حداثوية، والمفاهيم اليسارية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى تُعَدُّ في وضعٍ أكثر إيجابيةً في هذا الشأن، وإنْ متأخِّراً.
لا مَفَرَّ من عيشِ نظامَي الحداثةِ والعصرانيةِ معاً فترةً طويلةً من الزمن، مليئةً بالسلامِ والصراع، وذلك وفق الظروفِ والمبادئ التي عَرَضناها سابقاً. إنها حقيقةٌ من حقائقِ الحياة. وليس صحيحاً الاستمرار بمرحلةِ الحياةِ المشتركةِ الطويلةِ الأَمَدِ تلك، بمواقفِ السلمِ الاستسلاميّ وغير المبدئي، ولا بالمواقفِ والممارسات المتصارعة والمتحاربة في كلّ الشروط. أما المواقفُ الأنسب للمجتمعِ التاريخي في مسيرته نحو الحريةِ والمساواةِ والديمقراطية، فهي حالاتُ السلامِ المبدئيِّ والمشروطِ فيما بين نظامِ الدولةِ القومية ونظامِ الكونفدرالية الديمقراطية. وفي حالِ الإخلالِ بتلك الظروفِ والمبادئ، فمن الأفضل اتِّباع حروبِ الدفاع الذاتي إلى جانبِ فلسفةِ السياسة والمواقف الاستراتيجية والتكتيكية التي تَأخذُ إمكانيةَ العيش المشترك بعينِ الاعتبار. لديَّ القناعةُ بأني عَرَّفتُ بما فيه الكفاية الطابعَ الثنائيَّ لنزعةِ الحداثةِ (العصرنة) بوصفها المرحلةَ الأخيرةَ من تاريخِ المدنية، والذي سعيتُ لتحليله في هذا الفصلِ المُطَوَّلِ من عملي. النزعةُ العصريةُ ومسيرتُها التاريخيةُ الأقصر زمناً من سياقِ تاريخِ المدنيةِ مشحونةٌ بالتطورات الجَدَلِيَّةِ الكثيفةِ، مثلما الحالُ في التطورِ الجَدَلِيِّ لتاريخِ المدنية. ما ينبغي إدراكه لدى القول بالجَدَليةِ والدياليكتيك هو أنّ التطوُّرَ الثنائيَّ الأطرافِ مُحَمُّلٌ بذهنيتَين وبُنيتَين مختلفتَين بعلاقاتِهما وتناقضاتِهما. وتاريخُ القرونِ الأربعةِ الأخيرةِ يُؤَكِّدُ مصداقيةَ كَونِ الرأسماليةِ قد تَرَكَت بصماتها على نزعةِ الحداثة. لكنّ تَركَ الرأسماليةِ بصماتِها عليها لا يعني أنّ الحداثةَ رأسماليةٌ تماماً. علماً أنّ الرأسماليةَ بِحَدِّ ذاتِها نظامُ تراكُمِ الربحِ ورأسِ المال، أكثر مما هي شكلُ مجتمع. وهي ليست نظاماً مناسِباً لِوَصفِ ظاهرةٍ جدِّ شاملةٍ كالحداثة. ورغمَ استخدامي مصطلحَ الحداثةِ الرأسماليةِ مِراراً، إلا أني شَدَّدتُ دوماً على ضرورةِ فهمِ ذلك على أنه إشارةٌ إلى أنها مطبوعةٌ بطابعِها. إلى جانب ذلك، ومن خلالِ نعتي للوجهِ الثاني من الحداثة بالعصرانيةِ الديمقراطية (يمكن وضع اسمٍ آخَر أكثر ملاءَمةً في حالِ إيجاده)، فقد سعيتُ لتقييمِه على أنه يتسم بنصيبٍ أوفر من الحقيقة (لا أرى مناسِباً تسميتها بالحداثةِ ذات الطابع الديمقراطي). هذا وقد حَرصتُ على تَجَنُّبِ المواقف الأكثر ضحالةً وفَجاجة، من قبيلِ القول بالحداثةِ الرأسماليةِ والحداثةِ الاشتراكية؛ وذلك بغرضِ تلافي الوقوع في أخطاءٍ وانسداداتٍ تاريخيةٍ كتلك التي تُعاشُ في الفصل بين المجتمعِ الرأسمالي والمجتمعِ الاشتراكي.
لَطالما استخدمتُ أسلوبَ تناوُلِ كِلتا الحداثتَين المختلفتَين بالقياسِ بينهما ومقارنتِهما تاريخياً. ذلك أنّ الحقيقةَ نفسَها كانت مُتَشَعِّبة. ومثلما الحالُ في تاريخِ المدنية، فالأزمنةُ الحديثةُ التي هي أقصرُ طَوراً، كانت شاهدةً على هذه الثنائية، بكلِّ علاقاتِها وتناقضاتها. ما سعيتُ لعملِه، ولو من بابِ التجربة، هو صياغة تعاريف وتحليلاتٍ مقتَضَبة اعتماداً على تلك الشواهد. وبأقلِّ تقدير، لا يُساوِرُني الشكُّ أبداً في القدرةِ على فهمها كمُسودةٍ فكرية. كما لا ريب أنّ الانتقاداتِ والاقتراحاتِ التي ستُطرَح، سوف تُعَزِّزُ هذه التحليلاتِ أكثر لا يمكن إنكار كونِ الرأسماليةِ لا تَبرَحُ تارِكةً بصماتِها على الحداثةِ كنظامٍ لتَراكُمِ الربحِ ورأسِ المال، ولا تَنفَكُّ محافظةً على مكانتها كقوةٍ مهيمنةٍ عالميةٍ في ظلِّ حاكميةِ الرأسمالِ المالي. إلى جانب ذلك، لا يمكن أيضاً إنكار كونها قد أُنشِئَت كنظامٍ بِحَدِّ ذاته (النظام الرأسمالي العالمي، النظام العالمي)، وأنها تَحمِلُ بين أحشائها قوى متناقضةً بكثافة في كافةِ الظروفِ المكانية والزمانية. تلك القوى التي يجري العمل على تعريفِها بقوى العصرانية الديمقراطية من بابِ التيسير، لا تنحصرُ في الاشتراكيةِ المشيدةِ وحركاتِ التحرر الوطني وحسب، بل من المعلوم أيضاً أنها شَهِدَت انطلاقاتِ نُظُمٍ من قبيلِ الفوضوية بدايةً، والأيكولوجية والفامينية والدينية الراديكالية مؤخَّراً. لقد بُقِرَت أحشاءُ النظام ذاك منذ زمنٍ بعيد. والقوى الوافدةُ من داخله وخارجه (ينبغي القول من خارجه بالأكثر، لأن الطبيعةَ الاجتماعيةَ تَعتَرِفُ أصلاً بالقوى الآتيةِ من الخارج) لَطالما أَقدَمَت على ذِكرِ وممارسةِ وجودِها ومطالبها في الحريةِ والمساواةِ في ظلِّ كلِّ أزمِنَةِ وأَمكِنَةِ النظام، ولم تتلَكَّأ أبداً في بحثِها عن النظام المُتَوخّى.
وكما جُرِّبَ على مدى التاريخِ الحضاريِّ بأكمله، ففي الأزمنةِ الحديثةِ أيضاً لم تُسفِر مساعي النظامَين في إفناءِ أو احتكارِ بعضهما بعضاً عن أيةِ نتائج، وكان ثمنُ ذلك باهظاً جداً. لا ريبَ أنّ العمى السائدَ قد أَثقَلَ كثيراً من وطأةِ إحصائيةِ حروب هذَين النظامَين. ذلك أنّ النظامَين سيسعيان إلى الاستمرار في العيش بقمعِ بعضهما بعضاً بشدة. وكيفما ستُفرَضُ الهيمناتُ على الدوام من المستوى العالمي إلى المستويات المحلية، فالمقاوَماتُ المضادةُ أيضاً ستستمرُّ متوَطِّدةً أكثر باستخلاصِها الدروسَ والعِظاتِ من تجاربها. كما سنستمرُّ في عيشِ السلمِ والحربِ معاً على الدوام، ما دامَت حالاتُ العُقمِ والانسداد مستمرة. كلما كانت التحليلاتُ والحلولُ أكثرَ نجاحاً، وكلما كانت تَعكِسُ الصحيحَ والفاضلَ والجميلَ أكثر، فسيَكُونُ بمستطاعنا تَخَيُّل وتحقيق عالَمٍ أكثرَ مَراماً وجمالاً فيما يمكننا تسميته بحالةِ اللاسلم واللاحرب. وبالطبع، فإن الكثيرَ من السلم والقليلَ من الحرب هو الحالةُ الأثمن، وجهودُ تحقيقِها نبيلةٌ أصيلة؛ ولكن، بشرطِ أنْ تَكُونَ مبدئيةً وشريفة.
لقد عَرَّفنا هيمنةَ الرأسمالِ الماليِّ العالميِّ نفسِه بمرحلةِ الأزمةِ العارمة والأعمق على الإطلاق. والمستجداتُ تؤكِّدُ صحةَ هذا التعريف. علاوةً على أننا نَوَّهنا بإسهاب إلى منهجيةِ وبنيويةِ الأزمة. بل وحتى أنباءُ الأزمةِ اليوميةُ تؤيِّدُ مصداقيةَ طابعِها الممنهج والبنيوي. الأنظمةُ العصريةُ تُصبِحُ خصيبةً مُوَلِّدةً في مراحل الأزمة. ومثلما أنّ بعضها تُولَدُ مشلولة، فتلك المولودةُ سليمةً لا تنقصُ أيضاً. كما لا تَنقُصُ إطلاقاً طُرودُ الحلولِ الواسعةِ والتوفيقيةِ المتمفصلة للغاية في يوتوبيا الرأسماليةِ الليبرالية. حيث يَصوغون المخططاتِ اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والعقدية (لعشرِ سنين) ونصف القرنية (لخمسين سنة). هذا شأنُهم، وسيُواظِبون عليه.
قد تتضاعفُ فرصةُ قوى العصرانية الديمقراطية أيضاً في مراحل الأزمة تلك. فتاريخُ المقاوماتِ الباسلة ويوتوبياتُ الحريةِ والمساواةِ التي تستندُ إليها تُنِيرُ طريقَها. كما لديها العِبَرُ الكبرى التي استنبَطَتها من هزائمها ونواقصها. وعندما تستوعب كلَّ ذلك بالتداخل كحزمةٍ من الوظائف الفكرية والأخلاقية والسياسية، وتَضَعه قَيدَ الممارسة، ففرصتُها في النجاحِ عاليةٌ بالطبع. مع ذلك، لِمراحلِ الأزمةِ الممنهجةِ والبنيويةِ جوانبُها الخاصةُ بها، والتي تَقتَضي أخذَها بعينِ الاعتبار. إذ لا يمكن التغاطي عن ضرورةِ أن يَكُونَ العلمُ والفلسفةُ الأخلاقيةُ – السياسيةُ الواجب تطبيقَهما يتضمَّنان التحديث، مهما كانا يَحذوان حذوَ الماضي. وفي حال العكس، فحالاتُ السقم والعقم المعاشةُ بكثرة في الماضي، سوف تَجلبُ معها حالاتِ ضمورٍ وتَّقَزُّمٍ جديدة. خصوصاً وأنّ تحديثَ الليبراليةِ لذاتِها باستمرار يُعَظِّمُ المخاطر. ينبغي عدم النسيان أنّ الموجةَ الفاشيةَ، التي لا يزالُ تأثيرُها مستمراً إلى الآن، تصاعدت في الوقتِ الذي كان الجميعُ يَرتَقِبُ فيه الثوراتِ من خضمِّ الأزمةِ العالميةِ الكبرى المعاشةِ عام 1929 . وحُرِمَ المجتمعُ من ماهيته الأخلاقيةِ والسياسيةِ أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. وتقنيةُ المعلوماتية تُزَوِّدُ قوى العولمة المهيمنة أيديولوجياً بإمكانياتٍ هائلةٍ لِعَرضِ العوالِمِ الافتراضيةِ وتحريفِ العالَم الحقيقي. وهي لا تَرى بأساً في بَسطِ بُناها المتهشِّمة بسهولة، مُغَلَّفَةً بنظامٍ جديدٍ وكأنها وُلِدَت حديثاً. فالحشودُ الموجودةُ صُيِّرَت حشداً غفيراً من قَطيعِ الفاشية منذ أَمَدٍ سحيق. وعِوَضَ تحطيمِ آفاقِ الأمل، فإني أُبَيِّنُ ذلك بهدفِ عدم الاكتفاءِ بتوحيد الجانبَين التحليلي والشعوري العاطفي للحقيقة وحسب، بل وللتشديد على إمكانيةِ إفراغِ جهودِنا وهَدرِها بسهولة، ما لَم نَحمِلْ ونُجَسِّد العيشَ الأخلاقيَّ والسياسيَّ في كلِّ لحظاتِنا وأماكنِ وجودنا. الفصولُ الأخيرةُ من الآن فصاعداً سوف تُعنى بهذه المواضيع .